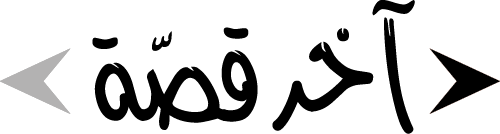١
أقف في المنتصف تمامًا بين حزن أمي وغضب أبي، كلما قابلتني تراجيديا صغيرة في المساء حفر جسدي جُحرًا في السرير كأني شهدتُ قبل دقيقتين خسارة هادئة لصديق قديم، كلما قابلتني تراجيديا صغيرة في المساء صرخ حلقي في السماء لأن الصوت العالي لضربات القدر أخاف العيال.
٢
يحدث غالبًا أن أنهي قهوتي بينما تكون أمي في منتصف كوبِها. تلك الإزاحة الصغيرة بسبب فرق ملعقة واحدة من السكر ورفض للتنازل من كلا الجانبين تضعُ كلًّا منّا في مدارين مُختلفين كل صباح، لكن أحيانًا، وبسبب تعثر في فكرة برّاقة أو مكالمة هاتفية طارئة، يحدث، بمجرد أن نقرع بكوبيْنا الطاولة معًا، أن أتوصل، كل مرة كأول مرة، إلى الدافع الحقيقي وراء اختيارها ألوانًا مرحة لطلاء البيت أو إلى سبب اختفاء وجه أبي من كل صور العائلة في الوقت نفسه الذي، طبعًا طبعًا، تتوصل هي فيه إلى شئ مشابه ربما يتعلق بطريقة نُطقي لحرف السين أو بالهالة الهادئة التي صرتُ أرتديها. يكون حتميًا، بعدها بوقت مناسب يسمح للفاكهة المغناطيسية على الثلاجة أن تزن أمورها، أن أعرض على أمي – كتعبير عن الالتزام الشديد بالاتفاق الضمني بأن يحتفظ المرء باكتشافه لنفسه – أن أقرأ لها قصيدة قصيرة، بدورها تكون إيماءتها غير مُتكلفة، تهزّ رأسها في قبول، وفي أناة عبر وجهها الذي لا يزال شابًا – وبالطريقة التي يقول بها عبدالوهاب أحب الظُلم علشانَك – تطلبُ منّي أن أُخرج دجاجة مجمّدة من الفريزر أو أن أملأ طبقًا صغيرًا بحبّات اللوبياء حتى حافته. هكذا، بخسارة قدر لا بأس به من المألوف، سمعتْ أمي بإيمان مرسال وتشارلز سيميك وعرفتُ أنا طريقتين لعمل طبق أرزٍ جيّد.
٣
فاتني يوم لأنّي لم أكن أعرف، قد تُخبر أمي الخالات في منتصف شكواها من العمّات أنّي أعرف الكثير من الأشياء وأنّي أفضّل ألاّ أنظر إلى الخلف أبدًا، ربما كان ذلك صحيحًا، لا أعرف رغم أنّي أحسبني، أحيانًا حين أمشي عائدًا إلى شئ دافئ بالجوار وأحيانًا حين أفعل شيئًا غير المشي عائدًا إلى شئ دافئ بالجوار، أعرف مثلًا أنه حتمًا فيما مضى فاتني يوم ولم أعرف فلم يفتني يوم لكن اليوم فاتني يوم لأني لم أكن أعرف والآن صار كُل ما أعرف أنه قد فاتني يوم لأني لم أكن أعرف.
٤
إن إضافة أي قطعة جديدة لمتحف الحزن تتطلب إعادة سرد كاملة لتاريخنا الشخصي مع الحزن. بالنسبة للقائمين على المتحف، يعتمد تحديد المكان الملائم لقطعة جديدة على معرفة دقيقة بأماكن القطع السابقة في صالة العرض وفي الوقت نفسه على تصوّر مقبول لمسار كل قطعة منذ مجيئها. بالنسبة لنا، يشبه الأمر بناء كتاب ضخم أمام جمهور لا يسعه الانتظار أكثر. لقد قرأنا الكتاب من الألف إلى الياء في صيف بعيد وتفاديًا لقراءة ثانية قاسية، لا يمكننا أبدًا الكشف عن حقيقة أن ما تبقى من تلك القراءة لا يُشكل أكثر من جملة أو جملتين. أجل، إننا نعترف بوجود تاريخ من الحزن يحمل اسمنا ولا يمكن لأي قادمٍ الهرب من وطأته، لكننا، بغضّ النظر عن عناوين الفصول ومقدمة قصيرة جدًا، نجهل هذا التاريخ بالقدر نفسه الذي تجهله القطعة الجديدة. تاريخ شخصي مع الحزن، في أفضل الأحوال، هو تاريخ للنسيان ولحماية ذلك النسيان من الإنكشاف وتلبيةً لإصرار القائمين على نوع من النظام في المتحف، نختار أن نقدم لجميع الحاضرين تاريخًا مختلقًا للّحظة الحالية يُماثل في الحجم والوزن تاريخنا الأصلي مع الحزن، في هذا التاريخ المختلق تحصل القطعة الجديدة، أيًا تكن أهميتها، على دور البطولة.
٥
تأتي أكثر أفكاري بداهةً في الصباح. سواء استيقظتُ إلى نور الشمس أو إلى ضوء النيون. أجِدهُا تتقافز حولي، مُلطخة بالمرح الوحشي الذي تستمده من حلم انتهي منذ قليل ومُعطّرة بالبراءة التي يمكن إيجادها في عَيْنَي طفل لا تُشكّل كلمة الخير أو كلمة الشر قسمًا في كتيب ارشاداته.
لقد ورثنا، كالشخصية الرئيسية في قصة الهجين لكافكا، بؤس آباءنا. أسكنّاه فراشنا، أطعمناه من أرواحِنا، أخذناه إلى كل موعدٍ أول وعرضناه في آخر الليل على جمهور مُتحمس في غرف نومنا. أن تقتل الأب، إنها فكرة لا تأتي في غير الصباح، مُغرية بصورة رائعة وتُناسب تراجيديا مصرية تبدأ في الشمال وتنتهي في القاهرة، لكن بقدر ما كان خلاص الشخصية الرئيسية واضحًا في نهاية القصة، كنّا نتخبط إذا ما خرجنا إلى النهار؛ يُمكننا وفقًا لوقود من الشباب الذي لا يفنى أن نقتل كل آبائنا، لكنه، الحيوان غريب الشكل من البؤس الخالص لا يزال ينام في حجورنا.
لا يكمن خلاصنا، أبناء التسعينات، في قتل الأب، لأننا، حين ورثنا لم نرث بؤس الأب فقط، بل أيضًا وبصورة أقسى وقعًا، فشل المُحاولة. ما نعرضه على حالنا على الإفطار ونحن نأكل الشوفان هو قتل لفرد آخر في العائلة، مسلّح بكل الرقّة والشاعرية التي نتعثر فيها في الأغاني وموّجهٌ تجاه من خاضوا معركتهم ومعركتنا في الفجر ونحن نيام لنستيقظ على أنينهم من السرير الآخر وثمار هزيمتهم.
٦
نبدأ المسير على سطح بحيرة مُتجمدة حينما نغلق كتابًا جيدًا على ابتسامة هادئة ومالنخوليا فاتحة اللون، لأن هناك شجرة رائعة وأبدية اقتطعت من حديقتنا، منذ لحظة واحدة، دون أن ينتبه أحد. تحتنا، على أَلَق اليراعات، يُمكن رؤية الألوان المُختلفة لأحلام يقظتنا تحاول أن تصنع منّا شيئًا آخرًا فنحس حركاتنا كطفل يتعلم المشي ولوهلة نشعر أن ذلك المسير لن ينتهي.
يُشبه من يسرع بإرجاع كتاب بعد انتهائه إلى المكان الذي أتى منه نادلًا في مقهي بلوما زايجارنِك؛ ينتهي من إنزال الطلب على الطاولة لينتقل إلى طاولة أخرى، ما لا يمكن إعراض وجوهنا عنه أنه بمجرد حدوث ذلك ينتهي المسير على سطح البحيرة المتجمدة، فحينما يغادرنا فجأة الوجود الفعلي للكتاب، حينما لا يعود يشاركنا السرير أو لا نراه يُراقبنا ناعسًا يتمدّد على أكثر كرسي مريح في البيت، وقتها يبدو الأمر وكأننا – حتى أكثرنا براءة – نضع في يده أو على الكومودينو – كرجل في قبوه – خمسة روبلات وهزّة رأس ساذجة.
٧
تتتابع أسماء صانعي العمل وتُضاء الأنوار في صالة السينما، وكما يحدث حين يفترق عاشقان، يُدفع المرء إلى عزلة من الزرقة والكاشمير. مُخالفًا قواعد اللعبة، أحتل مسنديَّ الكرسى وحدي، تعضّني الرغبة أن أجذب من بجواري من ياقة جاكيته الجلدي أحدثه عن شئ نُكِتَ في صدري، هُنا بالضبط، حيث تَفِدُ الأشياء الملونة، كأنني بذلك ألضم اتّساع المسافة بيني وبين شئ أقرب ما يكون لذكرى عن حلم، كأنني بذلك أرسم خريطة لكنز ضاع منّي منذ لحظات تحت هذا الكرسى.
يائسًا، أهرع إلى الحمام، أسلّم يديّ إلى الماء الساخن فأجد في المرآة آديل هاينل تترك طرف فستانها الأزرق إلى أرض زلقة، تسحب منديلًا من العلبة المعدنية في الحائط وتلصق علكة خضراء على سطحها اللامع. أسأل العجوز في الحوض المُجاور، أرأيت ما رأيت يا حاج؟ يلوك فمه، غريب والله يا بني، لا بد أنها ضلت الطريق إلى حمام السيدات. إنها الرغبة في الحديث كل مرة. كل مرة. كل مرة. تعضّني فأعضّها، ليس لأن الحديث عن دفء يُشبه الحلم يفسده، بل لأنه إيذان بالانتهاء، فلغة لا تمتّ للشعر بصلة لا تُناسب فضاءً كهذا شديد الرقة، إنها تمزّقه، هكذا لا ينتهي الفيلم مع تتابع أسماء صانعي العمل أمامنا، بل مع الكلمة الأولى التي ننطقها، ففي سعينا لفهم ملائم أو تعبير هادئ، نضحى بشئ أكثر أهمية ينتظرنا في الخطوات التالية.
٨
الليل هو اسم قصة قصيرة لراي برادبري. في القصة يوجد محل لبيع الآيس كريم وطفل صغير، الطفل يشتري الآيس كريم ثم يرسم خطواته عائدًا إلى البيت، من ورائه تنطفئ أنوار المحل ويغرق الشارع في النوم. ليس واضحًا ما إن كان الطفل قد لحق محل الآيس كريم بالكاد أم أن المحل كان ينتظر الطفل لكي يُغلق، لكن بما أنه لا توجد محلّات أخرى مفتوحة في الشارع وبما أن برادبري كاتب لم يغادر طفولته، نميل إلى الاعتقاد أنه ليس فقط محل الآيس كريم هذا بل كل محلّات الآيس كريم في قصصه تنتظر ذلك الطفل كي تذهب إلى السرير.
عالم مخلص للطفولة هو عالم يتبّع قاعدة برادبري. يبدو هذا مقبولًا لشخص مثلي، بل هو شئ لا يمكن أن يحدث عكسه. في الماضي، كنت أعبّر عن طفولتي باستخدام كلمات تشيكوف: في طفولتي لم تكن هناك طفولة لكن الآن الكلمات الرسمية هي: في طفولتي كانت محلّات الآيس كريم تذهب للنوم قبلي.
٩
حين يحدث شئ وأنت وحيد لا يحدث شئ، برغم أنه، وأنت تعرف، حدث شئ. حتمًا، حدثت العديد من الأشياء في وقت لم تكن فيه وحيدًا، لكن استرجاع تلك الأشياء لا يحدث إلا وأنت وحيد، وحينها لا تحدث فقط وكأنها حدثت وأنت وحيد، بل يبدو كل ما حدث وكأنه حدث وأنت وحيد وأنت تعرف جيدًا ما لا يحدث حينما يحدث شئ وأنت وحيد، كعدم معرفتك للّذي يحدث إذا لم يحدث شئ وأنت وحيد، لأنه حتمًا يحدث شئ وأنت وَحيد حتى وإن كان هذا الشئ هو المعرفة المُجردة من الصخب التي لا يهتم بها أحد، والغير مُثبتة في أناشيد الصباح عن كونك لستَ وحيدًا فقط بل أيضًا منذور بحدوث شئ ما غير محقق، وأنت وحيد.
هذا النصّ هو الأول من سلسلة تضمّ ٧ نصوص ننشرها كل يوم
صورة الشريط © حيدر ديوه چي