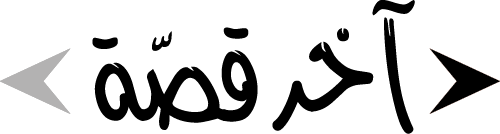في حاجة مريبة، مش فاكرة حاجة
– من أغنية لمي وليد
حصلتُ على قبلتي الأولى في خريف عام الثورة، تحت الوجود الفاتر لقمر مُتعب أبحرتُ في ضوئه أيضًا إلى نظام هِلهْلي للقراءَة. في ذلك التقاطع المُظلل بالبرتقالي والرمادي، بعد فترة من تبادل للّعاب كان، بلا شك، فشلًا ذريعًا، بدأت عادة التخلي عن كتبي للفتيات. كانت حماقة؛ الورقة الأولى في تقويم بدأ مع مئة عام من العزلة ليتوقف مؤقتًا في الوقت الراهن مع جوستِن لورانس داريل، مشهد الافتتاح في وثائقي عن فشل لن تُلقي المدينة له بالًا، أول قطرة في مشاركتي متناهية الصغر في دوران عجلة الثقافة المصرية وتاريخ ميلاد مكتبة حبيباتي السابقات.
أجل حماقة. كان يومًا مضجرًا وقررتُ كتابة رواية أجيال عن عائلة ما. أكان حماسًا فاضَ على الوجوه ما حركني أم كانت بحيرة آسنة من العزم تحت جلدي الملوّح من الشمس؟ كُنت، منذ بدأتُ خدمتي العسكرية الإجبارية، قد استمرأتُ متعة قراءَة أعمال ضخمة تستطيع أن تقتل أحدهم ضربًا على الدماغ بكعوبها. ذلك اليوم، بعد جلسة سمر حول ثلاثية نجيب محفوظ مع جنود سيئي التغذية حثني واحد منهم (لا يهتم بالقراءة لكنه يمتلك الرغبة الحارة للعبث بالجوار) أن استغلَ الوقت في كتابة شئ جميل. لماذا قال ذلك؟ لا أعرف. كنّا في حجرة خالية اعتدنا الفرار إليها للتدخين والاستماع إلى موسيقى سايكيديلك ملائمة للأحداث. هززتُ رأسي كفتاة ترفض الرقص في حفل زفاف لكن الفكرة لم تبرح عقلي. لا بد أن تكون على درجة من الحماقة حين تبدأ كتابة رواية وأنت في العشرين، يقول تشارلز سيميك، حسنٌ، لم يتحدث عن الثالثة والعشرين وأنت تمتلك كُل الوقت الذي في العالم. لبقية الليل، حرّك نسيم الربيع الباب الذي تركته مواربًا وامتدت أيادٍ بيضاء تدعوني للرقص.
هكذا استسلمتُ للإغواء وقررتُ البدء في فترة إعداد (كواحد من أولئك النبلاء المحترفين الذين يستعجب بورخِس من إصرارهم الذي لا يحتمل) فكونتُ في رأسي قبل النوم قائمة من عشرة كتب قد أو قد لا تساعد في فهم الأجواء المُحيطة بعائلة امتدت جذورها إلى رجل كان على علاقة متينة بالمماليك ونجح بأعجوبة وفي الوقت الضائع في الهرب من كلاب محمد علي السوداء. تسعة كتب تخص تاريخ مِصر في آخر مائتين وخمسين عامًا بالإضافة إلى الأعمال الكاملة لأمل دنقل. هل كانت ستجعلني قادرًا على صناعة شئ تقرأه أمي بدون إلحاح في عصر بارد، مَن يعرف؟ ربما فقط كُنت أبحث عن شئ يكحت الأيام.
اليوم التالي. عصرًا. خرجتُ برفقة زميلين من الوحدة العسكرية إلى الأسفلت وإبريل المحتضر. كان الطقس حارًا وكنتُ أرتدي جينزًا أزرقًا ممزقًا وبول-أوڤر رمادي شخّت عليه حمامة قبل ثلاثة أسابيع. النساء تعطرن بجاذبية الفيروز وأبواق السيّارات هَمس ملائكي. عبرنا الطريق. نزلنا إلى محطة مترو كُلية البنات. تحدثنا عن أشياء لا تعد مهمة لمن يمشي بدون تصريح إجازة لأقل من أسبوع. وصلنا العتبة. محطة واحدة، انفصلتُ عنهما. محطتان، خرجتُ إلى الهواء الطلق. أول يسار، كانت هناك جماعة من القطط تخدش حياء المواطنين الشرفاء أمام نقابة الصحفيين. يسار آخر، أخرجتُ سيجارة واستعرتُ نارًا من أول شخص قابلني. كان طعمها سيئًا، كأيام السبت. أطفأتُها. دخلتُ إلى مبنى الهيئة العامة للكتاب. اشتريتُ مختارات شعرية ليانيس ريتسوس، خلية النحل لثيلا، أسنان زادي سميث البيضاء، خبز السنوات الأولى لبُل ورواية المستبعدون لإلفريدة يلينك. السابعة مساءً. ألقيتُ كُل شئ على السجادة في غرفتي وغطستُ في السرير. لم يكن هناك شئ على وجه الأرض أكثر إثارة للمتعة من التكور في سرير من طابق واحد حتى وإن لم يأت نوم.
لا بد أني كُنت قد أوغلتُ في المساء، لا بد أنني صنعتُ من نفسي زوجًا وزوجة، صندوق بريد شكاوى العالم كان فارغًا والقلب المُعذب لأنطونيا بودنبروك حصل، أخيرًا، على نهاية سعيدة. قرار أمس. شعر أمل وتسعة كتب. واحد كُل شهر. تسعة أشهر تكحت من خدمتي العسكرية. شهر يتبقى لأعيد النظر في ما جمّعتُ أو لأرقب النجوم مُمددًا على ظهري في سرير بطابقين. شعر أمل وتسعة كتب. تسعة كتب وشعر أمل. لم أنتظر الفجر لكي أدخل المدن الرائعة، خرجتُ إلى ليل خسر الحرب ومدينة ملأى بأجساد العذارى الدافئة لكنها فقيرة في الاستعارات. ارتديت ابتسامة والدي و تيشيرتًا أصفرًا، خطواتي كانت سينمائية والوجه مَطهره الرياح وتواتر البَشر، حبُ الإنسانية بوجه العموم بدلًا من الاضطرار إلى حب المخلوقات بوجه الخصوص. لو عندك سر روح وقوله، لو عندك سر؟
تعلقت يداي بنهاية التيشيرت وحُشِرتا في جيبي الجينز متسخي الحافة. التيشيرت نفسه كان حاضرًا آخر مرة وقال لها، ماسحًا شارب القهوة الفرنسية، أنا مابقتش عارف كل حاجة ملهاش طعم. بنطال الجينز الأسود لم يكتف بالالتحاف بالصمت بل وضع نهايته على فَمي الجوربين وكحركة ختامية، تليق بمهرج الفصل الأول، شرب التيشيرت ما تبقى من سموثي الفراولة خاصتها كي لا يتلون به عائدًا وابتسم، أجل ابتسم، كقطعة ملابس لا تعرف المكواة في وجه لم يعد يثير فيه شيئًا. عندك سر؟ أول ما عدتُ أخرجتُ كتب فترة الإعداد من مكتبتي. أيوه أيوه عندي سر. عندي أغنية في رأسي وعندي كتاب ناقص.
اتصلتُ بها بعد مُنتصف الليل لأخبرها أني أريد التاريخ السري لاحتلال إنجلترا لمصر مجددًا. لم تَرد. تمددتُ على السرير وأشعلتُ سيجارة. لم تكن الليلة طويلة ولم تكن اللفة كبيرة ولم أكن أشعر بالتعب. فكرت في العثرات التي في طريقي لأصبح شيئًا آخرًا وكيف كان ملمس يدها وهي تُخبرني أنها تأخرت وعليها العودة إلى طنطا. نمت. تفحصتُ الموبايل أول عهدي بضوء شمس اليوم؛ حقلًا فارغًا. شاركتُ أمي فطورها وأحاديث الغياب، متوجهًا نحو الحياة التي ينبغي أن يعود الضال إليها. ساعة الحائط متوقفة وكل أصدقائنا داهمهم الغثيان. أكلتُ تفاحة خضراء في سريري وقمتُ بخيانة كُل طيور العالم لأجل النوم مرة أخرى.
أفقتُ على اهتزاز الموبايل، ازيك؟ كُنت جسدًا صدئًا وكرمشة في الملاءَة. حلوة، صوتها لم يكن كما اعتدت. أنا عارف، حاولتُ أن أكون مرحًا، بقدر ما تسمح به الظروف السياسية الرابضة جوار الدولاب، أنا عارف إنك حلوة. هل نقلَتْ الهاتف من يد ليد أم أبعدته عن وجهها؟ عاوز إيه؟ أخرجتُ لساني فأمطرتْ السحب. قالت إن الكتاب بحوزتها، نبْرتها متعجبة لمجرى الحديث. تمام يا فندم، أنا فقط أريد إزالة كل العثرات أمام مشروعي الكتابي، مرة أخرى، أنا فقط أريد التاريخ السري لاحتلال إنجلترا لمصر، لا زيادة. لكنها – تقول – مشغولة، اختبارات في الجامعة وتراجيديا في الأسرة الصغيرة. اقترحتُ ابنة خالتها في شارع الشبان المسلمين، صديق مشترك، البريد المصري أو أيًا من عصافير الكافيهات السيئة التي جلسنا فيها في طنطا أو في بنها؟ لا تكاد – تقول – تجد وقتًا بين العناية بأختها وبشرتها الخلاسية ومتابعة أثر الاستفتاء الدستوري في الشارع المصرى، من كان بإمكانه أن يخمن النتيجة؟ طيب، قدام باب البيت؟ لا – تقول – لن يحدث كما أن لديها الآن حبيبًا آخرًا، أكثر طولًا ولا يتحدث أبدًا عن كافكا. حبيب آخر؟ وأنا ما لي يا لمبي، زعقتُ فيها فأغلقتْ الهاتف في وجهي. بعد نصف ساعة، كنت أسبها وأنا أرمي الموبايل على طاولة في المقهى.
لا يعني تراص الكتب في مكتبتي شيئًا. لا يمكنها، ولو اجتمعت كلها، أن تُخبرك سرًا عني. لا تقدر أن تشير إلى طائر أخفيه بين جوانحي. ما الذي يمكنك أن تستنتجه من وجود ديوان أبي نواس؟ قصص الأنبياء؟ رأس المال؟ أصل الأنواع؟ الأعمال الكاملة لمحمود أمين العالم؟ أرجع الشيخ أم لم يرجع؟ / لا شــــئ / لكن ماذا عن الكتب التي تضمها المكتبة الأخرى، مكتبة حبيباتي السابقات، التي لا تحتل وجودًا في مُحيط؟ تواتر أعمال فيليب روث؟ الترجمة السيئة لقصائد سافو؟ لو-لي-تا؟ دراسة في شخصية المواطن المصري الأسمر؟ أجيب لك حاجة تشربها يا أستاذ؟
ومض الهاتف على الطاولة باسمها كما ومضت لافتة سؤال اليوم: ما الذي تفعله السجائر الكليوباترا في ابن آدم؟ وأسفله بين قوسين بخط أصغر : هل يدخن السجائر الكليوباترا أصلاً ابن آدم؟ أيًا كانت الاجابة؛ أعطيت النادل سيجارة وقلت قهوة سادة. عقلي مُدرجات درجة ثالثة تابعت انحسار البهجة عن بائعات الخضراوات على الرصيف الآخر. قلت آلو في المرة الثالثة. لم تكن هي نفسها التي كلمتني قبلًا؛ أقل جدية وأكثر مرحًا، كأنها فقدت رطلًا من الهالات السوداء وبؤس الروح. لم يعتذر أحد لأحد. ملتُ ببدني يسارًا مُتفحصًا الطريق من حمام المقهى إلى طاولتي حيث يمكن أن يُلقى ابراهيم نصر باروكته تلحقه فرقة موسيقية تُغني اللقطات اللي واخدينها كُلها طبيعية. أعدتُ الخيارات المُتاحة (بدون ذكر وسائل المساعدة) فوجدتها توافق على أن نتقابل في طنطا. أغلقت الخط وتنهدت. ثم حدث أن فكرت في الحمار وكيف أنك حين تسكت لي سأدخل به فاتصلت بها واقترحت أن نتقابل في القاهرة. مدينة مُحايدة ها؟ ردت ضاحكة. اتفقنا على مُشاهدة ثلاثة أيام في كويبرون ضمن اسبوع أفلام معهد جوته. الخميس. بكرة. البسي التيشيرت المَفضل لديكِ والجينز المفضل لدي، هل قلت لها ذلك فعلًا؟ لم نتحدث قط عن الكتاب. كانت مكتبتي الخاصة لا تتقاطع مع مكتبة الحبيبات السابقات ولو في كتاب واحد مما يعنى وجود تاريخ سرى واحد، وواحد فقط، لاحتلال انجلترا لمصر. حقًا توجد رغبة حارقة لأمتلك نسخة أخرى من الأعمال الشعرية الكاملة لرامبو ويحدث أن أتوقف لدقائق أمام اسم الوردة في ڤاترينة مكتبة الأهرام أو أحن إلى مقاطع مُناجاة ديڤيد كيبيش لكونسولا كاستيلو التي لم تعد موجودة. فبرغم قيمتها غير المُنكرة، هناك اتفاق ضمني بترك هذه الكتب وشأنها حتى تلك التي لم تتسن لي الفرصة لقراءتِها أصلًا، صورة دوريان جراي؟ الجزء الثالث عشر من قصة الحضارة؟ تاريخ شعبي للولايات الأمريكية؟ على فترات، بينما كنت أرتق الغياب في قميصي مع صعاليك من الدرجة الثالثة على مقهى آخر فكرتُ في حجم الخرق في الحائط والانحراف عن جادة الارتياح (الارتياح معهم؟ معها؟) وفي تطور غير مُثير للأحداث تذكرتُ كل الأشياء التي جعلتني أملُّها. رغبتُ في محو الساعات الأخيرة. لقد تم سحبى إلى الشرك نفسه مرة أخرى، كان الأمر كاكتشاف قطة في الحذاء، فجأة، في عرض المساء. لم يكن الخطأ اتصالي بها، كان الخطأ وضع الكتاب في القائمة بالأساس. أحه، لقد تمت غوايتي بواسطة مشروع رواية لن يتَم، أهذا ما تفعله السجائر الكليوباترا في ابن آدم؟
وكما لو أنها سمعتني عندها. بالضبط كما لو أنها كانت داخل رأسي وسمعتني؛ في التاسعة صباح اليوم التالي، كموظف دؤوب في مصلحة المعاشات، اتصلت بي وفي اقتضاب شديد الثقة بنفسه ألغت موعد الليلة. لم أشعر بالغضب، نسيم من الارتياح راقص أسفل ظهري. منطقي وعملي، هذا ما كنته ولم أترك الموبايل ينزلق من يدي؛ عتبة التاسعة من عمري، أول وآخر حفل عيد ميلاد، لم أمتلك وقتها غير صديق واحد رفض أهله، بصورة عنيفة، مجيئه. ما الذي تتوقعه من شخص يريد الوقت المرح غير أن يتصل بواحد آخر من المدرسة، منبوذ ومهجور، غريب ومطمور في رمال الوحدة، طالبًا منه مشاركة كعكة رديئة الصنع؟ هل كانت أربعة عشر عامًا تالية من خبط الرأس بالحيطان لتغير شيئًا؟
لا، أبدًا. لكن يحدث أن تمر سيارة يصرخ فيها عمرو دياب أنا رايح فين؟ في أطراف بنها، يعيش كائن يسهل التنبؤ بحركاته لكنه، الكائن نفسه، الملون بتراب الشوارع الخلفية وأغاني جورج هاريسون، قادر على هز الطاولة من حين لآخر بحركة تجعل أكثر اللاعبين عبثًا يحك رأسه. أنا راجع تاني. ها هو ذا الكائن، الذي تقبّل بسعة صدر إهانة في الصباح ثم قام على إثرها بثورة ذكورية مضادة، يتقبل عصرًا، بابتسامة تجاه موج متخيل، تغيرًا محسوسًا في المسار الديمقراطي. خلال دقيقتين، لم يحدث فقط إلغاء موعد مع صديق قاهري لمشاهدة ثلاثة أيام في كويبرون بل أيضًا موافقة رمت في النيل كل التشبث بأمن الأراضي المحايدة، موافقة على مباراة على أرضه وبين جمهوره من المقاعد الفارغة وأسراب مالك الحزين التي هجعت مُبكرًا إلى أشجارها ترتقب خسارة مُخزية في عقر الدار وانسحاب مُتوقع من المدينة.
ارتديت اللقاء الأخير، بيدي كتابٌ بدأتُ فيه الليلة الماضية. مديح الخالة. سائق الميكروباص شرطي ومواطن شريف، راقب في مرآته بدقة ووجه عبوس، المسار الذي ترسمه أيادي عاشقيْن في الكنبة الخلفية ومحاولةً مني لأكون نصيرًا للضعفاء وفي صف الغلابة حاولت صرف انتباهه عنهما بقصة تقبيل مصطفي النحاس ليد الملك فاروق والتي لم أكن مُتأكدًا من صدقها. ردَّ عليّ: أنا مالي بمصطفي النحاس والملك فاروق؟ ثم مين مصطفي النحاس ده أصلًا؟ ترجلتُ. مشيتُ أفكر في الأيام الخوالي والناس من الأيام الخوالي كما لو كان كل شئ سهلًا ويرتقب حدثًا. ما تبقى منها مثل ما تبقى في نفسي من قراءة بطيئة لأعمال باتريك زوسكيند، حين آوى جان بابتيست غرونوي إلى حفرة في الأرض واختفى العالم. أردت أن أتذكر؛ هل كانت رائحتها نفاذة أم كانت كأفلام الكارتون؟ السين تنطق بشفاه ملتوية وبقع تراب وضعت عن عمد على حذائها الأبيض؟ طريقة تعلقها بيدي حيث لا تحتاج إلى مساعدة لعبور الطريق؟ أغنية حب أخرى غير التي كنت أهمهمها؟ أشعلتُ سيجارة للخطوات المُتبقية واستكانة نهر النيل، كنتُ حيوانًا أليفًا يبتلع غيمات من الهُنا والآن ويتتبع مسارًا غير خطي للأحداث. هناك جدّات يقسمن أن احتلال مصر كان البارحة وأن صلب المسيح لم تمر عليه دقائق معدودات. أنظر إلى الخلف، الأبيض الكثيف. البارحة، قالت لي، تشاركنا ليل المدينة نفسها. حفل زفاف. صديقة قديمة لم أعرفها. بيت الخالة. تجمع مثالي لثنائيات ملساء. وددتُ أن أسألها هل ليل بنها يُشبه ليلي لبنها؟
تقدمتُ ساعة كي أستطيع أن أعود بالوقت وفي الوقت نفسه أُحدد أفضل طرق الهروب. في الدغل البرتقالي والرمادي في كافيه شجرة القهوة، مكاني المفضل (لا يلمس حذائي أرض الملعب / لا يمكن اعتباري منهم إذا ما قامت الثورة) ناداني من يميني ولسه بيناديني. تجاهلته، كما لو كان خطأً إملائيًا في رسالة طويلة من صديق اعتاد أن يسرق سندوتشاتي في المدرسة، وجلستُ إلى طاولة لشخصين، لظلّين مُتعبين من الاستمناء على أقدام الخلق، لفلّاحين مجدورين يُمسكان في خجل بعوارض المعدَّية، لخياليْن يلعبان الغميضة في عقل عسكري مشاة، لأقدام حافية على الأسفلت أمام مدرسة أطفال أو لذبابتين أنهكتهما مشقة البقاء في أوتوبيس مُتجه إلى وسط البلد. مكانك يا كابتن؟ نبهني النادل بسماجة إلى خيانة تقع في الوراء لكنّي، نافضًا عن فرائي روتين الكتّاب الحمقى وذبذبات ماضي مُصطفي كامل(المغني لا الزعيم)، ومُحتاطًا تجاه دفعة زرقاء وفوز التاء المربوطة بمكان عزيز، طلبتُ قهوة بالبندق بدون سكر وسبابتي تنقر مُنتصف الطاولة. هنا. الآن. أشعلتُ سيجارة كليوباترا، لا لشئ غير رغبة في ازعاج الطلاء البرجوازي في المكان، بين يديّ في الكتاب كان فونتشيتو يقول لدونيا لوكريثيا آه إنه بذئ بالطبع ومع أنه كذلك، إلا أنه الحقيقة يا خالتي.
تعرفتُ عليها في حفل لعبدالله المنياوي في مسرح الجنينة. كان الحضور قليلًا وضجرًا. جالس على طرف صف وجالسة هي على الطرف الآخر، بيننا كُل المقاعد الفارغة التي أتاحها الإنفلات الأمني والحاجة إلى الانزواء. حبر جاف على جينزي الأبيض، نسيم بارد في ليل يونيو وسماء بلون مقتبل الشباب والكرز في العتمة والتطوّح. طويتُ المقاعد، ثملًا، بشكل مناسب، لحماقة صغيرة. كانت ترتدي حجابًا وتتمايل كفرع توت فتي، حتى بعدما توقفت النغمات في إشارة أذان العشاء. قُلت شيئًا. ضحكت. كقلعة حوت ليلةً كل عشاق البلد السُذج والآن تضيق حُجراتها بالوحدة والصور المُعلقة. بعد الحفلة استمعنا إلى الأغنية على هاتفي. هير ماننيلغ، عارفة قصتها؟ ارتسمت لا في الجلد العارى بين طرحتها العابثة والبلوزة الكريمية. زعقت في كُحل عينيها: لا تعرفين الوثنية التي عاشت في حفرة اللعنة القاهرة التي لا يمكن التحدث عنها في العشاءات الطويلة، حيث تلوك الجميلة الأمل القليل الذي لم يُغطّ الطبق المسطّح وأنّات الحسرة في الأكواب الخشبية. كلنا قرويون ساذجون في ارتباك أضواء المدينة، شماليون تربوا على ضوء النيون والخوف من ظلمة الكهف وجلد البشر، السخرية من الغربان على أطباق الاستقبال و كراهية الفئران والقطط السوداء التي لا تدخل المساجد، نبيع ونشتري الشفقة في الموالد وأسواق الجمعة، نرى لمحة من الضوء في المرآة فنرتدُ إلى زجاج ميكروباص الثانية بعد منتصف الليل إلى الأراضي الهادئة. أكشف لكَ ساقين أنهكهما المشي على الأسفلت وعشب أخضر بين رجليّ تنعي الطبيعة عدم حرثه، أنفاس الإله اصطياد الفراشات من على عروق ثدييَّ والنوم مع الشيطان التواءَة نفسي المسكينة كل مساء أسكبُ عليك مائي ولا تبرد. نسخة من ميرامار ترقد في حجرك حيث ينثني البنطال كالنيل في بنها و الفتيات المُحجبات وسط الحلفا والبوص، لك مني قميص جديد، أكثرها زهوًا لترتديه، هل تقبلني؟
لا، لم تكن تلك هي الأغنية التي تُلعب في شجرة القهوة ولكن ليس مُهمًا مادام لن يلحظ ذلك أحد؟ فنجان القهوة بيني وبين آخر نهار نخر أنفه مطمئنًا لانشغال المارة بينما سُحب العودة إلى غُرفة فارغة تجمعت في عقلي. وددتُ أن أتخلص من كل تلك الكتب التي قيدتني، أن أقف على أي كوبري وأنفض يدي من وخز المشقة إلى قاع النيل. ما أبقانا كان دومًا الإيمان بأن الحفلة في نهايتها ولا ضير من الاستمرار في الركن نفسه لبعض الوقت. آه، لِمَ فاتني – كما فاتني دخولها المُفاجئ إلى البرتقالي والرمادي – أن الحفلة دائمًا كانت في نهايتها منذ قال آدم لحوّاء وهو على بطنه متوسدًا يديه، أن هُناك رائحة غريبة في السرير؟ كل أول يوم تقول؟ كان عمرو دياب يُغني إلى حفريتين بصدريتين كبيرتين فشلتا في الإغواء، كان عمرو دياب يغني إلى مراهق ضلّت أصابعه الطريق إلى مخفوق الحليب في أزرار جينز الخصر العالي لأفروديت، كان عمرو دياب يغنّي إليّ حين وقفتْ في تيشيرت أبيض وبنطال قماشي مُرقط (يدان حُرتان، لا حقائب). هناك الواقع لم يكن في يوم من الأيام كاملًا مثل الخيال يا لوكريثيا. تركتُ الكتاب من يدي – مرة واحدة، وللأبد، دون اكتمال – ملطخًا الطاولة برذاذ مفاجأة بنكهة البندق حين انزلقت نظراتها إلى وجهي وما زاد الطين بلةَ، أن الرجل الذي يحارب مرور الأيام، عمرو دياب بشحمه ولحمه، انسلّ من على كرسي مجاور للحفريتين وبابتسامة بعرض حائط مدّ يده البيضاء ناحيتي في إشارة فهمتُ منها أن التاريخ السري لاحتلال انجلترا لمصر لم يكن عِندها قَط: كُل ده علشان بتهرب من الحقيقة، الحقيقة يا خالتي؟
صورة الشريط © حيدر ديوه چي