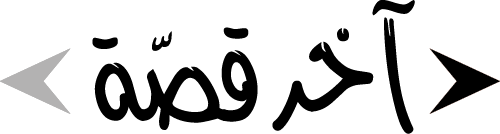الساعة المصلوبة على الحائط تشير إلى الثانية عشر. الجو عادي. والموسيقى على الاذاعة كلاسيكية. يدور حديث بين رجلين يبدو على نبرتهما التعب. لكنه مع ذلك تعب يومي روتيني وعادي. لم يكن الحديث ذا طابع جدلي. لكن فجأة يرتبك أحدهما، تتغير ملامحه قليلاً، وتهبده موجة قوية من الحماقة، فيرتعش صوته وهو يردد بلا منطق اسم أنثى كان قد ورد للتو على لسان الرجل الآخر ضمن لائحة معتبرة من الأسماء المؤنثة والمذكرة المدعوة إلى حضور حدث ما، لن يذهب إليه على أي حال، وفوق ذلك لم يدعى إليه.
لم يعلق الرجل الآخر على الواقعة، بل راح يواصل حديثاً قديما، منتهيا ومحسوما، كمن يصب ماءا في كوب ممتلئ بالفعل، وهو بهذه الوصلة المترهلة، الممطوطة، الزائدة عن الحاجة والمدفوعة برغبة قوية، رعناء وساذجة، في عدم التعليق وإخفاء معرفته بشيء، أو ملاحظته لشيء، قد تورط في النهاية في التعليق بطريقة ما على الواقعة.
الساعة المصلوبة على الحائط تعمل بالبطارية القلوية. بطارية واحدة وقطبان. قطب موجب وقطب سالب. تختزن طاقة كيميائية تقوم بتحويلها إلى طاقة كهربائية. والطاقة هي إحدى صور الوجود. والزمن هو حركة مستمرة في ملعب الوجود إلى الأمام، لا رجعة فيها، ولا سبيل لإيقافها. لكن البطارية القلوية المزنوقة في مؤخرة الساعة المصلوبة وتدفع عقارب الساعة في حركة دائرية دؤوبة ومنتظمة حتى أنها تبدو لا نهائية ولا رجعة فيها ولا أمل في إيقافها، لها عمر افتراضي، تتميز بأنه طويل، لكنه مع ذلك، نهائي ومحدود.
يتوقف الحديث تماماً، مثل آلة تعطلت. وبسرعة، يتم التواطؤ من الجانبين، باتفاق خفي، على موته. وبعد دقيقة واحدة يتم إعلان الموت رسمياً بخروج الرجل الآخر من الحجرة. ينفرد الرجل الأول – الذي لن يُدعى منذ هذه اللحظة بالأول، وكأنه بموت الحديث صار رجلاً وحيداً، وبوحدته صار مجرد رجل – بنفسه، أو بالتليفزيون. وفي معركة مادية بين التليفزيون والنفس – باعتبارها الروح، لابد أن يربح التليفزيون، لأن للتليفزيون وجود مادي، وكينونة واضحة، ثابتة، ومحددة، تتجلى متربعة على المنضدة، بعكس الروح التي تفتقر لأي من ذلك.
الريموت في يد الرجل. وهو لم يكن قد فارقها منذ اللحظة الأولى في القصة. لكن وجوده ينتقل من مرحلة إلى أخرى. من مرحلة كان فيها مثل عضو خامل أو معطل أو معطوب في جسم الإنسان ، إلى مرحلة جديدة صار فيها كأنه أُكتَشَف أو بعث مرة أخرى. بثلاث تكات في اتجاهات مختلفة، لكنها متقاربة، ومدروسة جيداً، على جسم الريموت، يتغير وجه الشاشة. لوجو جديد، صورة جديدة، صوت جديد، وروح جديدة. روح جديدة بمعنى أن الجو العام في الحجرة تغير، تجدد، كأن تيار هواء نقي ومنعش ضرب المكان، بعد دقيقة واحدة في عصر القناة الجديدة. هذا ما بدا على سحنة الرجل الذي راح ينفعل ويغني على حس السيدة فيروز، على ما يطبع أغنيتها من قتامة: «ما في حديث. والجو تعيس. ضيعانو كيف؟ خلص الحب!».
في أبعد نقطة ممكنة على يمين الشاشة من تحت، ترتكز ساعة رقمية، لا تنزاح، لكنها تنبض كل دقيقة بالحركة. فركة كعب في مشوار الزمن المفتوح بلا مواربة. الساعة الرقمية تشير إلى الواحدة والربع تقريباً. أي بفارق ساعة كاملة عن التوقيت الذي تشير إليه الساعة المصلوبة على الجدار. يتوقف الرجل أمام فرق التوقيت، متأملا، متمهلاً، شاحباً ومتألما لحقيقة نحالة الستين دقيقة، الساعة الكاملة، أمام ضخامة الزمن، ليس الزمن في صورته المطلقة، بل الزمن الخاص اليومي المحدود الذي هو بصدد قطعه في هذا المكان. قبل أن ينزلق في حلم قديم.
انتصب جدار، بدا كأنه قطعة ديكور في مسرح عبثي. إذ لم يكن يرتفع عن قاعدته بأكثر من متر ونصف. ولا يمتد بما يكفي ليصل بين حدي المجال المفتوح في كادر الحلم. وعلى ضموره، تسنى له أن يعزل بين جسدين تشبثا به كأنهما على وشك السقوط من على حافة، لكن أيضاً بحذر بالغ وكأنهما يخشيان عليه من الإنهيار. كان الوجهان العاريان الطليقان يقفان في مواجهة بعضهما عبر الفضاء الذي لم يبلغه الجدار، كما يقف الواحد أمام مرآة الحمام الصغيرة فيرى وجهه دون سائر جسده. على جانبي الجدار، كانت مرسومة لوحة للفنان التشكيلي خوان ميرو، هي «رجل وامرأة أمام كومة من البراز».وبدلا من الرأسين المعلقين على الجسدين المصلوبين في لوحة خوان، كانت هناك الساعة نفسها المصلوبة على الجدار في الحجرة. وكانت كل واحدة تشير إلى توقيت مختلف، بفارق ساعة كاملة.
صورة الشريط © حيدر ديوه چي