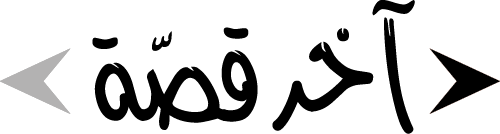أسير على الرصيف عائدًا إلى البيت. ينبعث فجأة من أحد المتاجر ضوءُ النيون. يندفع في عيني. يشوّكها. يهبط على أذني كصفعة، ورغم أنّي بعيدٌ كل البعد عن المكان أنظرُ إلى شرفات المبنى في الاتجاه الآخر.
كنّا في الثامنة. لا. في التاسعة. وأخبرنا ولد من آخر الفصل أنه احتضن وقبّل فتاة تكبرنا بسنتين وراء حمّام المدرّسات. قام أيضًا بإقناعنا، أنا وشريكي في المقعد، أننا لو دفعنا له جنيهين فسوف نحصل على المتعة نفسها. كنا في الحصة الأخيرة، كلانا أطلق على العضو الذكري تسمية صديقة للأسرة، قبَّلنا فقط المرايات وظاهر أيادينا و الكائنات الحية سوى أهالينا لم نحتضن. كرمشنا جنيهين في جيبه ومشينا خلفه. بعد ساعة من التخريم في شوارع ضيقة وأراضٍ غير مألوفة انتهينا إلى شارعه حيث أخبرنا، مقشرًا شفته السفلى، أن عليه الصعود إلى شقته. سرعان ما فهمنا ما كان يحدث وتصرفنا بناءً على ذلك. كان مقدرًا أن يلاقي مسعانا الفشل من البداية، مع ذلك، بينما شاركت قطط وكلاب الشارع في ضرب الطفلين الغريبين الذين عكرا صفو المكان، لم يسعنا سوى الشعور بالمفاجأة. بعد حوالي أسبوع مات والد شريكي في المقعد، كانت هذه أيضًا مفاجأة. كنت أزوره بعد المدرسة وأجد بقايا شرائح بيتزا في كل مكان في غرفته. على المكتب. على السجّادة. على السرير. تحت الوسادة. كان لا يأكل شيئًا غيرها و أنا اعتقدت أن هذا ما يحدث: يموت أبو أحدهم فتُقدّم له البيتزا دون انقطاع. كنت مخطئًا؛ لم تكن البيتزا ما حصلت عليه بموت أبي.
إنه الحظ أولًا وأخيرًا، دائمًا قال واحد منّا إلى الآخر؛ نجحتُ في تهريب قطعة ضخمة من ساندويتش إلى فمي وفي اللحظة نفسها دخلتْ إلى الفصل سيدة ترتدي فستانًا طويلًا مشجرًا وتحرك أصابعها فوق كتف صبي صغير. ظننتُ أنها وَشت بي لمّا أشارت ناحيتي لكن المدرس بدلًا من أن يأخذ العصا الملفوفة بالبلاستر أخذ الصبي وأجلسه في المكان الفارغ بجانبي. أمرنا أن نكون حلوين مع بعض، لم أستطع أن أفتح فمي، أحنيت رأسي. بعدما ذهب، أخرج الصبي كرّاسةَ وقلمًا من حقيبته ثم وضع على المقعد بيننا علبة عصير وساندويتش. أحضر دائمًا ساندويتشات لانشون وجبن بيضاء وفيما بعد عقدتُ صفقة معه. «اسمي رائف». أخبرني أنه قد أتى من المدينة وفي الفراغ بين الحصة والحصة أضاف أن السيدة في الفستان هي أمه وأنها اختارتني لأني ارتديت ربطة عنق مثله تمامًا. أمسك طرف ربطة عنقه ومسح نظارته. تفحصت التلاميذ، لم يكن أحد دوننا يرتدي ربطة عنق.
لقد رأيته يرتدي ربطة عنق في البيت أيضًا. كان الناس يأتون لتأدية واجب العزاء وأرادت الأم أن يظهر أمامهم دائمًا بالشكل الذي أرادت. هكذا أجبرته على ارتداء بذلة كاملة طوال اليوم. بعد وقت، استمع إلى نصيحتي وصار يخلع الحذاء الأسود والجوربين على الباب ويضع الچاكيت وربطة العنق على السرير. كنّا نجلس في الشرفة نلعب الشطرنج وعندما كانت الأم تنادي كان لا يذهب قبل أن أقسم له أنّي لن أغير أماكن القطع. كنت أفكر في أثناء غيابه أنه حتمًا يقف الوقفة نفسها التي تعجبتُ منها عندما زرته وأمي اليوم التالي على وفاة والده. أحيانًا كان ينحني بميكانيكية قبل أن يفتح الباب، عاقدًا كفيه على بطنه ووجهه يستحضر الجمود من الوجوه في اللوحات في الطرقة المؤدية لغرفته. خمس دقائق وكان يعود حاملًا طبقًا مكدسًا بشرائح البيتزا وزجاجة بيبسي. كان يشد يدي لأنضم إليه لكنّي لم أفعل أبدًا. كنت أحضر في جيب قميصي كيسًا من البسكويت وأجلس في الجانب الآخر من الغرفة. في إحدى المرّات نسى رائف ربطة العنق وبدلًا من البيتزا والبيبسي عاد بعلامة لأربعة أصابع حمرا ء على خدّه. سألته عمّا حدث، لم يجب. لابد أن الصداع كان يتملك رأسه؛ كان دائمًا ما يطلب منّي ألا أضربه على وجهه لأن ذلك يسبب له الصداع. قمت من على الكرسي، كررت سؤالي. كانت ربطة العنق محشورة في الفراغ بين سريره والجدار، نظر إليَّ كما لو كان يسأل كيف انتهت إلى هناك. لاحقًا، ونحن نتشارك كيس البسكويت أخبرني أنه لن يخلع ربطة العنق. وقد فعل؛ حتى الليلة التي قررتُ فيها التوقف عن زيارته، لم أره دون ربطة العنق.
كان العيال في المدرسة يومئون إلى الفراغ في المقعد ويسألونني «هو إللي سمعناه إزاي حصل؟» كنتُ أميل عنهم وأعلن عدم معرفتي. ما الذي انتظروه منّي؟ ما الذي دار في أدمغتهم وأقنعهم أني أعرف شيئًا زيادة أو أني بطريقة ما شاهد على مأساة من فصلين؟ كنت فقط ألعب معه الشطرنج وبينما كنّا نلعب الشطرنج كنت أحكي له ما حدث في مسلسلات الكرتون. في بيته غطت شاشةَ التليفزيون قطعة قماش ثبتت بمجلدين ضخمين ومنفضة سجائر، وعلى الحائط برواز احتفظ بابتسامة والده مع شريط أسود مائل. كان رائف، بعد اطمئنانه إلى غياب الأم في النوم، يقلب البرواز ويرفع عن التليفزيون المجلدين والمنفضة وقطعة القماش ويخفض الصوت إلى أقل درجة. لتأخر الوقت لم يكن يجد مسلسلات الكرتون لكنه، بما أنه لم يوجد لديه شئ آخر ليفعله، كان يبقى هناك.
«عمرها ما صحيت من النوم ولقيتك؟».
«.لا»، هز رأسه، «ماما بتقول إنها بتقعد تحلم ببابا طول الليل.
إذا لم نلعب الشطرنج، فتحنا كراساتنا، كتبت واجب اليوم ونقل هو ما فاته في المدرسة. إن أصابنا الملل، وكان دائمًا ما يصيبنا الملل، تركنا مرافقنا تنام على جدار الشرفة القصير وأنظارنا تعلقت بالعائدين من العمل وآشعة آخر اليوم ضفرت حركتهم. أبواق السيارات كأنما أعيد اكتشافها والمتاجر استعدت للحياة الليلية. كانت الإشراقة الأولى لأضواء النيون الملونة في واجهة متجر ما تشبه لوهلة اشتعال ألعاب نارية. محملين بالدهشة، كنّا نهتف ونضع رهاناتنا على مكان الإشراقة التالية. كان رائف يترك ربطة عنقه إلى الهواء يعبث بها، «بُص» أخرج لسانه بميل إلى اليسار، «الكرفتة دايمًا بتروح الناحية دي بُص». قلت «أيوه» على الرغم من أني لم أكن أتذكَر أين ذهبت ربطة العنق في اليوم السابق.
كنت ألتفتُ إليه وأقول أشياءً من قبيل أن لاحق أفضل من سابق أو أن تكون طفلًا وحيدًا أفضل من أن يكون لك أخ. اختلف معي. قلت «الوقت ده أحسن وقت في اليوم».
قال رائف «صح، أحسن وقت في اليوم» ثم وهو يدخل إلى الغرفة، «عاوز بيتزا؟»
«لا»، دخلتُ وراءه، «أكلت مكرونة بالبشاميل في البيت».
من موقعي في الجانب الآخر من الحجرة لم ألحظ بكاءه في البداية. هل كان يبكي بلا صوت أم أن تهشم قطع البسكويت بين أسناني ابتلع ذلك الصوت؟ قفزت ناحيته. كانت الدنيا تمطر في طبق البيتزا. وضعت يدي على كتفه. أخبرته أن كل شئ سيكون على مايرام. ناولته آخر منديل ورقي معي. وضعت يدي الأخرى على كتفه الآخر. وقع المنديل ثقيلًا بالبلل إلى الأرض وانزلقت شريحة بيتزا من على الطبق. مسحت وجهه بربطة عنقه. قلت له «كفاية. بص لي.» لم يفعل. خبطته على رأسه. خبطة أخرى ثم أخرى. أخرى ثم أخرى. صرخ رائف. كعب حذاء الأم في الطرقة. كنّا قريبين من باب الغرفة فخبطنا. وقعنا جوار المناديل والحذاء والجوربين. الدموع في عينيه. يداي على كتفيه. دفعتني أمه بعيدًا عنه. اصطدمتُ بحافة السرير. اقتربت مني كقطة سوداء غاضبة. طعنت بسبابتها الصفراء الهواء أمام عيني. خاتم زواجها في إصبعها، نّظرت إليَّ كما لو كانت ستلتهمني. رائف صرخ ثانيةً. وقف بيننا وقال «مفيش حاجة. كنت بعيط وبيقولّي ماتعيطش»، ارتعشت شفتاه الملطختان بالدسم.
بأحمر في الجلد وملابس ممزقة، كنا اتفقنا على قصة بديلة نحكيها للبالغين في غرف المعيشة. لم يكن يصح أن نقول أننا سرنا في أجزاء لا نعرفها من القرية لأجل أشياء أغمضنا أعيننا إذا رأيناها في التليفزيون وكانوا حاضرين. أردت قصة عن البهدلة والتكدّس في زحمة الخروج من المدرسة وأراد رائف قصة عن التشعلق على عربة نصف نقل. نقرنا قطعة نقود فجاءَت في صالح الزحمة والتكدّس. لكن يبدو أنه استثمر كثيرًا من خياله على الوقوع على الأسفلت للدرجة التي أنسته ما اتفقنا عليه. في الوقت الذي لاقت فيه قصتي شعبية جيدة في بيتي لم تلق قصته أي قبول في بيته. وأمام تقطيب أمه لحاجبيها وكزّها على أسنانها اختلق قصة أخرى، على السريع، لتبرير اختفاء ثلاثة أزرار من قميصه. لقد أخبرها أنه تشاجر معي. لماذا تشاجر معي؟ لأني أخذت قلمه الرصاص المفضّل. لماذا أخذتُ قلمه الرصاص المفضّل؟ لأني كسرت قلم الرصاص الخاص بي. لماذا كسرت قلم الرصاص الخاص بي؟ لأني متخلف فاشل في الإملاء. أيضًا كانت هناك شجرة في القصة وقد جعلتُه يصطدم بها.
«يمكن فكّرت اننا بنتخانق تاني. معلش، أنا كنت فاكر إنها مش واخدة بالها مننا».
كنتُ أرن الجرس فتفتح ليَّ الباب. تحطُّ عيناها عليَّ فتتوقف عن تسوية تنورتها وتنزوي نصف الابتسامة على وجهها. «إزيّك يا طنط؟»، دائمًا ما اصطدمت تحيتي بمؤخرة رأسها. كنتُ أراها في خطواتي من وإلى الحمام، جلست على كرسي من كراسي السفرة جوار نافذة عالية، قطعت حزمة ضوء رقص فيها الغبار، بين اصبعين سيجارة مشتعلة وفي حجرها منفضة سجائر. كنت أومئ لها. لم تنتبه. ارتدت الزيّ نفسه وعصابة سوداء حول رأسها لكنها لم تكن المرأة التي شدّت على يد أمي ومسدت شعري عندما قلت «البقية في حياتِك يا طنط» وبالطبع لم تكن المرأة التي وقعت من الضحك حينما عرضتُ عليها رسمتي لحرب أكتوبر ورأت رجلًا يقذف كرة سلة في جانب الورقة. لقد كانت النوافذ مفتوحة لذا لم يكن غريبًا أن أجد عصفورًا يطير في الصالة أو يأخذ وقتًا مستقطعًا على مزهرية. ما الذي كانت تراه في الناحية الأخرى عبر النافذة العالية؟ لا بد أنه كان شيئًا مهمًا لأنِّي مرة لمحت عصفورًا ينكش بين أعقاب السجائر في المنفضة.
مسحتُ عيني وقلت «وأنا كمان».
التقط رائف شريحة البيتزا من على الأرض وقال «تقريبًا انهارده مفيش تليفزيون».
بعد وقت قليل من رحيلي كانت تغلق النوافذ، تنظِف المنفضة وتذهب إلى النوم أول الليل. في أيام أخرى كانت تَظل هناك على الكرسي.
«لسه بتقول بتحلم بباباك؟»
«لا»، هز رأسه، «زي مانت شايف ماما مبقتش تتكلم كتير».
رجعنا إلى الشرفة. تحت رعاية أصفر أعمدة الإنارة أخرج البعض كراسٍ خشبية وجلسوا أمام البيوت، بعض الأبواب مفتوحة وأصوات خارجة من تليفزيون أتت من مكان ما وكانت هناك بنت على دراجة، كلما مرّت بعمود إنارة، رنّت جرسها.
قال «محدّش جِه النهارده».
لم يكن الأمر وكأنه أسِف أن أحدًا لم يأتِ. كان يفكّر في شئ ما، رأيتُ ذلك بين حاجبيه. كان يقطِّبُ فلا تظهر خطوط رأسية بل كرة صغيرة من الجلد بين حاجبيه. تحت زجاج موضوع على مكتبي هناك صورة لنا، تدلت يد أحدنا على كتف الآخر، ناظرين إلى الكاميرا، أمام سور الشرفة القصير، كان مقطّبًا. حكَّ شعره فتساقطت القشرة البيضاء على حافة السور. فكّرت أنه ربما غير سعيد ببقائه في البيت. نفخ القشرة إلى الهواء ثم كرر العملية.
«انت زعلان؟»
«عاوز بيتزا؟»
«لمّا أرجع من الحمام»؛ شريحة واحدة لم تكن لتؤذي أبي.
تمدد ظلّي في الطرقة على ضوء النيون القادم من الغرفة. كان الكرسي فارغًا خلا المنفضة، منها تسلل خيط رفيع من الدخان إلى أعلى، وفي المطبخ، أشباح الأطباق المتسخة على الحوض وعلب البيتزا الكرتونية البارزة من سلة المهملات استمعتْ إلى هدير الثلاجة. كانت الأم في الحمّام.
حدث الأمر مسبقًا تحت سطوة ظُهرٍ يوم ما والنور يملأ المكان. لكن، هذه المرة، لم تستخدم الأم مسّاحة بسرعة لتغلق باب الحمام ولم تسقط رأسي في صدري. ظهرتْ، على ضوءٍ قادم عبر زجاج نافذة الحمّام الصغيرة، ساقاها العاريتان.
تجمدت أمام الباب المفتوح، مرّت سيارة في الجوار فانعكست أضواءها على السقف. على التنّورة المتكورة على قدميها الحافيتين رأيت قطعة مستطيلة بيضاء من القماش وعليها بقعة حمراء داكنة بدت كبلد على خريطة. اصطدم شئ صلب بالمياه ومع ذلك بقى وجهها على حاله. تملكني خوف. وعلى الرغم من أنّي أعجز الآن عن تحديد ممّا كان ذلك الخوف (هل كان مما حدث قبل قليل أم بقعة الدماء وصوت الخراء وهو يخبط المياه؟ هل كان انفصالها الظاهر في تراخ جسمها أم الطريقة التي ضرب بها الضوء وجهها؟) فإني أتذكر تمامًا أن ما هَبط على رأسي باصطدام قطعة الخراء بالماء هو الرغبة الجارفة في العودة إلى البيت.
الوجوه في اللوحات صارت أكثر تجهمًا في الرجوع. لطالما اعتقدتُ أنها كانت تحدّق في بعضها من على الجدارين. بعدما قدمتهم أمه لي سألتني ما إن امتلك أحد في عائلتي هواية. قلت نعم، أمي تقرأ الكتب وأبي يحل الكلمات المتقاطعة. في عصر أيام الخميس، بعد أن نعود من لعب كرة القدم في ملعب المدرسة وبعد أن نغسل أرجلنا جيدًا في الحمّام، كانت تسمح لنا باللعب ساعة على الأتاري وإن لم يكن زوجها مشغولًا، أخرج رقعة الشطرنج. كان لا يتكلم كثيرًا لكنه أضحكنا. أحيانًا هزنا في أكتافنا، وهي مقطبة في اللوحة أمامها، وأطلق ريحًا. غاضبةً، كانت تنظر إلينا، ثم تتفتح كوردة وتضحك.
ابتلع صوت طرّاد المياه جرس الدرّاجة وعندها لاحظت أن الوجوه في اللوحات كانت تحدق في.
حملت حقيبة ظهري وقلت له «أنا اتأخرت».
قال «والبيتزا؟» واضعًا شريحة لم تؤخذ منها غير قضمة على السور.
قلت «بطني وجعاني».
أشار إلى الجهة الأخرى من الشارع، هناك بقت بقعة وحيدة مظلمة،
قال «استنى لحد ما ينوّر».
«بس ده محل مقفول»، انحنيت إلى الهواء.
«قلِّي إللي حصل في أدغال الديچيتال؟»
«ما قلت لك.»
قال «هتصل بطنط».
عندما اتصل بعد زيارتنا لم تعطني أمي السماعة. بعد أن أقفلت السكة، أخبرتني أنه يمكنني زيارة رائف بعد المدرسة، وان وجدته حزينًا فعليَّ أن أقول له أن كل شئ سيكون على ما يرام، وأن أباه في مكان جميل. عندما كان يحين موعد عودتي إلى البيت كان يتصل بها ويستأذنها في نصف ساعة إضافية. كانت توافق.
قلت «لا».
ما حدث بعد ذلك لم يكن ضربًا أكثر منه محاولة لإجباري على البقاء. وأنا أهجر ضوء نيون الغرفة شدني من الحقيبة. كان هزيلًا فرمي جسده إلى الوراء وجلس على كرسي متخيل في الهواء. مدهوشًا نظرتُ إلى وجهه فبدا كما لو كان فقط يدعوني إلى دور آخر من الشطرنج. «استنى شوية». ارتعش جسده ، هل كان يقدّم عرضًا لجمهور من الوجوه في اللوحات، بآذان بالغة الصغر وأنوف ضخمة في الطرقة؟ «إيه إللى حصلك؟»، كلما تخلصت منه ومشيت خطوات عاد وأمسكني وصارت مؤخرته أقرب إلى البلاط. «سيبني»، الأم على الكرسي بيدها سيجارة، «سيبني»، حاولت أن أبدو بريئًا أمام ابتسامة الأب في الصورة. تعلق بي أكثر. كانت المروحة تدور فحركّت قطعة القماش التي غطت التليفزيون، لثانية ظهرنا على الشاشة السوداء. أكنّا عصفورين أم أنها أرادته أن يتعادل؟ تشبث بيدي، قال «استنى». زعقت «سيبني» وتفلّتُ. ربما كان يحاول التمسك بشئ ما قبل أن يصطدم ظهره بالبلاط لكن ما حطَّ على أذني بالتأكيد صفعة. رأيت دموعًا خلف النظّارة. غرست الأم السيجارة في المنفضة وسوّت تنورتها.
خرجت إلى الشارع. صرعتني الدرّاجة. أصدر جرسها رنّة غريبة وطارت فردتي حذائي من يدي. سألتني البنت «انت كويس؟».
«آه»، كان باطن الجوربين متسخًا.
«ابقى خلّي بالك»، حركت عجلاتها.
«معلش»، التفتُّ إلى الشرفة في الطابق الأول، وضع رائف مرفقيه على سورها وتدّلت ربطة عنقه. تداعى صوته «حقك عليّا». أردت أن أخبره كم هو غبيَّ؛ لقد ذهبت ربطة عنقه في الاتجاه الآخر.
ينمحي غضب الطفولة بوضع الأيادي المتسخة تحت المياه الفاترة وتظهر المشاهد من هناك كفقاعات في هواء الذاكرة نفخ فيها الحلم. مع مرور الوقت تنفجر فقاعات وتختفي فقاعات لكن ما لحقه الخوف التصق بالجلد كعلقة لا تريد الفراق.
تلك الليلة بدأ الخوف كشريحة من الطماطم في طبق ثم كبر كالليل إلى أن ابتلع الكومودينو والدولاب في غرفة النوم، كلما أغلقتُ عينيَّ، تدلت وجوه شريرة، من الأعماق السحيقة لسبت غسيل تراكمت فيه أقوال العيال في المدرسة، من الأركان المظلمة في الحمّام حيث يحدث الإخفاء و أبواب غرف نوم الأبوين التي أغلقت بالمفاتيح، من حقيقة أننا كنّا نوضع في الأسرة مبكرًا فكانت كل حركة أثر عفريت ومن تبقع خلايا الدماغ بدماء سكبت في الشارع أو بصقها طفل خسر ضرسًا، مدَّ الخوف يده وقرصني تحت الغطاء.
في اليوم التالي سألتْ مدرّسة «رائف هيرجع إمتى؟». نظر الجميع ناحيتي. قلت «يوم الأحد». كنّا في يوم الخميس وقال ولد من ورائي «هنلعب بعد المدرسة» وهكذا لعبنا.
جلس الأولاد والبنات على المقاعد حول ملعب المدرسة، تحت الأشجار وفي الأركان جوار أهرام حقائب الظهر. بعض التلاميذ أمسكوا كتبًا وأقلامًا وآخرون كانوا يتحدثون فيما بينهم، لكنّهم، إذا دخلت الكرة إلى المرمى وجرى محرز الهدف وخلع تيشيرت المدرسة في أحضان فريقه، كانوا يصيحون فكان المدرسون المتقاطرون إلى الخارج يتوقفون للحظة ويتابعوننا.
أحيانًا، كانت الكرة تخطئ المرمى وتصطدم بالسور الأبيض خالقةً دائرة من التراب حول شعارات المدرسة المكتوبة وأحيانًا والكرة في طريقها إلى الشباك كان أحد المدافعين يمد يده ويمنعها من الدخول، وكقاعدة معروفة، يُطرد المدافع من الملعب.
مَرْكزت الكرة في بقعة بيضاء في منطقة الجزاء، رجعت خطواتٍ إلى الوراء، رأيت أبي.
أستيقظُ بعد منتصف الليل. تطالني الدهشة حيث أتبين جواري على السرير زوجتي. ها هو خوف أعرفه، اعتاد أن يأتي إذا فتحت عينيَّ إلى انقطاع الكهرباء وأن يذوي إذا ثبتت أمي الكشّاف جوار سريري. أتبول جالسًا. أعود إلى السرير. أتمدد على ظهري.
أرى رائف يتسلل إلى الغرفة. ثلاثة أزرار غائبة عن قميصه. يسألني «انت زعلان؟».
وقد كنت زعلانًا، لأن ولدًا من آخر الفصل أخذ جنيهين منّا وضربنا بمساعدة عيال شارعه.
يقول «ما تزعلش»، ويخرج من جيبه جنيهين، «أخدتهم وهو مش واخد باله».
نشتري مثلجات ينقبض وجهه تحت صداعها. أضحك.
يقول «يوم حلو» ونحن نمشي على أرض مرشوشة بالمياه. أقول «آه».
كان عامل توصيل البيتزا يأتي الظهر بثلاث علب وزجاجتي بيبسي، تفتح له الأم الباب، تحاسبه وتخبره أن يأتي في اليوم التالي بالطلب نفسه. آخر يومين، بابتسامة على الوجه، فتح له رائف الباب وظُهر الخميس لم يفتح له أحد. وضع أذنه على الباب فخبطته رائحة غريبة، تواصل مع أحد الجيران، قال أنه يشم الغرابة نفسها. كسروا الباب. بالداخل، تكفّلت عين الموقد بالموت، محاولة فاشلة لطبخ سهل. كان التليفزيون شغالًا ورائف مستلقٍ على الأرض أمامه، يرتدي بيچامة مقلمة وبجواره قطعة قماش ومجلدان ضخمان والمنفضة، وفي حجرة النوم الرئيسية كانت الأم، نائمة على جنبها، في زيها الأسود، بسلام مناسب على وجهها جعل واحدًا ممن رأوها يحكي ويقول «زي ما تكون بتحلم».
لا يزال الناس في القرية البعيدة يستخدمون تلك الجملة.
صورة الشريط © حيدر ديوه چي