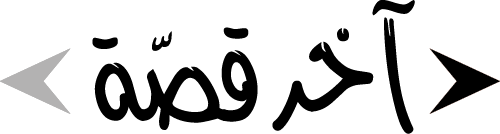أعرف سرا جوهريا عن الرسم: لا أجيده. قد تظنها معرفة هينة، لكنها في رأيي تضاهي في عظمتها ما ينكشف للرسامين الكبار من أسرار، فتجاهلها غافلا أو عن عمد قد يضيع حياتك إلى الأبد، ويجعل منك ألعوبة في يد ربات الفنون وشراكهن التي لا تنتهي، والتي لا هدف منها سوى أن يضحكن قليلا في نهاية المساء.
يا لقسوتهن، يبدين لأحدهم في طفولته أو مراهقته أو حتى في منتصف عمره لمعانا خاطفا وغير أصيل لكنه كافيا لقنص روحه، فإذا ما ابتلع الطعم لا يتوانين عن مده بظلال من سراب العظمة وأوهام الموهبة ووعود المجد الكاذبة، لا يتوقفن قبل أن يحولن ضحاياهن إلى مهرجين ومخبولين وقتلة، إلى أرواح تعيش عذابا سرمديا، يُجلدون فيه بسوط من الشوق العفي، بينما تجثم فوق صدورهم صخرة ثقيلة من العنّة القاتلة.
أدركت مبكرا عجزي عن الرسم إلا أنني لم أسلم من مس الغواية، الفارق بيني ومن وقعوا في الفخ، أني نجوت، وإلا ما كنت لأقص عليكم بأريحية تجربتي العجيبة التي حاولت فيها خداع ربات الفنون ردا على تسليتهن القاسية. نجحت بطريقة مذهلة، وانتقمن بما يكفي لحفظ كبريائهن، لكني أعتبر نفسي الفائز الأكبر، ففي النهاية – ومهما أنكرن- قد أفلت بحياتي من أحابيلهن، وصرت بفضل تلك التجربة ما أنا عليه الآن، الرجل الذي أفخر بمواجهته في المرآة كل يوم.
بدأ الأمر كله من حصة الرسم بالمدرسة، عذاب أسبوعي تتفاقم حدته عاما بعد عام، لم أنتبه إليه في المرحلة الإبتدائية، حيث يكفي أن تجيد رسم الشمس.
لا شيء صعب في أن تعلق بشرق الورقة البيضاء دائرة تنبعث منها بضعة خطوط، أي شخبطات تحت تلك الشمس ستؤدي الغرض. هل ترغب في رسم رجل؟ عصا فوقها كرة صغيرة، ذاك جذع ورأس، اثقب الكرة مرتين، ثم ضع خطين طولين قصيرين في المنتصف، أسفلهما نصف دائرة مقلوبة إلى أسفل إن كان سعيدا، وإلى أعلى إن كان حزينا، ها قد جعلت له عينين وأنفا وشفتين، خطين كذراعين ومثلهما في الأسفل كساقين، ما الذي يتبقى سوى أن تنفخ فيه الروح! يمكنك بلمسة ساحرة أن تحوله إلى امرأة، بأن تضع فوق الكرة كتلة من خيوط متشابكة، وأن تجعلها تتدلى. أما المكان فلم يكن من الصعب تخيله، بضعة خطوط متموجة في الخلفية، ها قد حصلت على شاطىء وبحر.
عندما كان يطلب منا رسم موضوعات أكثر تعقيدا، كحرب أكتوبر على سبيل المثال، كنت أستعين بالكتابة لأفسر ما يعجز الرائي عن فهمه، ذلك الصندوق دبابة، وذلك المسجي على الأرض غارقا في دمائه جندي إسرائيلي لعين، صيحة: الله أكبر دليل على مصرية الجندي، المثلثات التي تزين السماء، طائرات، أما تلك الدائرة التي تسكن أعلى منتصف الورقة، فلم تكن بالطبع إلا شمس الثانية ظهرا.
هكذا مضت أيامي، لكن في المرحلة الإعدادية صار المدرسون أكثر تطلبا وكفوا عن الرضا بأي شيء تضعه تحت الشمس، يسخرون ممن يكررون رسمها، الكل يفعل، عدا الموهوبين بالفطرة بالطبع، أولئك اللذين ينبثق السحر من بين أصابعهم كخرير الماء. لم أكن أحمل تجاهم أي حسد أو كراهية، على العكس كان فرحي بما ينتجونه حقيقيا وأظنني كنت أملك التمييز الصائب بين الجيد والردىء والعبقري.
كان مقعد المتفرج هو مكاني الأصيل، لولا أن ظهرت تلك الملعونة والفاتنة كشأن كل مدرسات الرسم، مس هند.
كانت مس هند شابة في العشرينات من عمرها، تخرجت حديثا من كلية الفنون الجميلة، حلوة ومصبوبة كتمثال حي وملون لامرأة ناضجة ذات جسد ممتلىء ومدملج، وعلى عكس أغلب مدرسات تلك الفترة، كانت تضع تبرجا كاملا وأنيقا، محسوبا بدقة كأنه ضربات فرشات حاذقة لفنان كبير، كانت فساتينها أقصر مما اعتدنا رؤيته، ويبرز من فتحة صدرها بياضا ساطعا يغشي الأبصار، كان عطرها يسبق حضورها فيشتت أرواحنا.
اتصالي الأول بها كان أسطوريا، لن أنساه ما حييت، وكان مبعث حسد من أعين سبعين طالبا يتحسسون طريقهم إلى المراهقة لكن بالنسبة لي كان مصدر ارباك وحرج وكدمة لا تبلى.
في حصتها الأولى، تخيرتني لتشرح عبري شيئا عن أبعاد الجسد، تحسسته بقوة، ضغطت على وجهي وصدري وذراعي، بل فخذي ومؤخرتي، كانت أنفاسها تلفحني من الخلف فتدميني، هل حدث ذلك فعلا أم أنها أضغاث أحلام وشهوات تنتحلها الذاكرة؟ يقيني الوحيد أنها فعلت ذلك بأريحية ودون اكتراث كبير لمشاعري ولا تورد وجهي بحمرة من الخجل والغيظ، ولا سريان كهرباء صاعقة بسائر أنحاء جسدي، ولا ضحكات زملائي الساخرة التي تخفي الحقد، حينها رغبت في شيئين متناقضين أن تنشق الأرض فتخفيني، أو يغيبني كهفها المسحور، ذلك الجزء الغامض من جسدها إلى الأبد.
عدت إلى مكاني في الصف، مرتبكا، مشوشا، غاضبا ومفتونا، أدركت مس هند أن انتهاكها – الفاضح في رأيي – لجسدي، سيجعلني مضغة في أفواه السفلة، فاختصتني بالاهتمام، وفي تلك الليلة عشت أوهام الوقوع في الحب وحظيت بأول حلم جنسي في حياتي.
ألهذا أتخيل ربات الفنون على شاكلتها؟ لأنها أول عهدي بالجمال الحسي، أم لظني أنها مثلهن، قاسية، متلاعبة تهب الأحلام كسراب كاذب، ثم تنبذك فجأة في هوة نسيان أبدية، لكن إذا أحبت وتخيرت، فعندها فقط تمنح بلا حساب.
فعلت كل شيء كي لا ترى رداءة رسمي، نسيت الإسكتش والألوان، تحايلت بربط ضمادة وهمية على يدي. بعد ثلاث حصص، فقدت انتباهها بالكامل، لصالح عبد الرحمن زهير، أفضل رسامي الفصل.
كان عبد الرحمن بالغ الوسامة، كل شيء فيه كان ناعما ورهيفا، ملامحه وشعره الأشقر، صوته وحركاته وأصابعه التي تجترح المعجزات ببساطة مشي المسيح فوق الماء، أتذكر أنه في إحدى المرات، حضر معي مجموعة تقوية بإحدى سناتر الدروس الخصوصية، دخل في منتصف الحصة، لا أبالغ إن قلت أن الزمن توقف عند دخوله، استدارت أعناق الفتيات، سالت تنهداتهن كلبن مسكوب، ذهلن كأنهن نسوة يوسف، لم يشفق عليهن حتى بالالتفات، ليس عن زهد، أدركت من الابتسامة المغرورة التي علت شفتيه أنه يعي تأثيره وأنه يستمتع به، وأنه كربات الفنون كان قاسيا بدوره، غير مبال، وقد أثبت ذلك لاحقا، حين كانت تبلغني حكاياته بالجامعة مع فتيات ونساء أكبر سنا، كان يتلاعب بهن دون رحمة، يغويهن، ثم يتركهن كجرحى ومخابيل وقتلى تماما كأنصاف الفنانين ومعدومي المواهب، على الأقل دفع اثنتين إلى الانتحار، إحداهن قطعت معصمها بسكين، لعلها فعلتها ذاهلة كنسوة يوسف لتتحقق النبوؤة.
لم يشغلني أبدا تفوقه في ملاحة الوجه، فشأن ذواقة حقيقي ومتفرج موهوب، كنت مشغولا أكثر بلوحاته البديعة التي تكاد أن تنطق بالحياة والحيوية، فاعتبرت وسامته الرهيفة محض لوحة عبقرية حصلها بلا جهد منه.
لم أنزعج إلا عندما فتنت به مس هند، وكرست له اهتمامها ووقتها، نستني تماما، بل لم يعد يشغلها إن أحضرت إسكتش الرسم والألوان أم لا، لم تتنبه حتى إلى أني نزعت الضمادة عن يدي، تلك اليد السخيفة العاجزة.
سرعان ما تبين أنها كشأن كل مدرسي الرسم اللذين سبقوها، ساخرة قوية من رداءة العاجزين عن الرسم، ينسون شيئا بديهيا، أنه ليس من الطبيعي أن نملك جميعا الموهبة، وأن أحدنا لم يطلب أن يوضع تحت ذلك الضغط المذل: اجتراح نفس معجزات الموهوبين، كان بإمكانها بدلا من ذلك التركيز على تعليمنا أساسيات تمكنا من رسم بلا فضيحة، أو مساعدتنا على تطوير ذائفة فنية تدرك مكامن الجمال.
لم أعرف ما الذي تحرك داخلي ليحيطني بيأس معتم، الغرام أم الحقد، أظنهما الشيئين معا، فهما متشابهين، لكنك لاتدري أيهما الأصل وأيهما انتحل صفته ليغطي وجود الآخر.
لكن ذات يوم حدثت معجزة، قلبت كل شيء رأسا على عقب.
كنت عائدا من المدرسة في طريقي إلى المنزل بمزاج عكر وقلب مكلوم، فوجدت تلك الورقة المتسخة على الأرض وعليها رسم لجسد إنسان. عندما أمسكت بها، أدركت أني عثرت على كنز، فلم تكن مجرد صورة بل شرحا مفصلا وواضحا لطريقة رسم الرأس والجذع والذراع والساق والأنف والعينين، كل شيء أهملت مس هند شرحه، لأن عينيها معلقتين بفتى واحد مدلل.
نمت، صحوت، تأملت الورقة طويلا، حمت حولها في مزيج من الفرح والرهبة، لم تفارق عيني لساعات مفتونا باللمعان الخاطف الذي كشف لي شيئا من الأسرار الكبرى، سهرت طيلة الليل أتدرب على فهمها وتقليدها، وفي نهايته رسمت شخصا كاملا وحقيقيا للمرة الأولى في حياتي.
في الأيام التالية، حدقت في كتب المدرسة وأغلفة كتب أبي وقصصي المصورة التي أشاركها مع شقيقي الأكبر وألبومات المسابقات التي كنت أحرص على جمعها كسائر أقراني في ذلك العمر.
نظرت إلى كل صورة وفهمت كيف أرسمها، كأن عيني تبدلت، رأت السر الخارق في لحظة إلهام ربانية، صرت قادرا على نقل ما أراه، محتفظا في لمسة أراها عبقرية بالخطأ البشري الذي يجعل من تلك الكذبة الصغيرة حقيقة كبرى، أليس ذلك مبدأ كل الفنون؟
هكذا استطعت أن أرسم شجرة وبيتا وامرأة وتعقيدات أخرى.
بعد أسبوع، أحضرت إسكتشا جديدا نظيفا كالماء لم تلوثه سوى لوحة واحدة تعلن هويتي كرسام موهوب. لوحتي الأولى.
رسمت امرأة معجونة بملامح ربانية وشيطانية في الآن عينه، ممتلئة، تقرفص في وضع الكاتب المصري، مرتدية جلبابا ينبثق منه وجه دائري يفوح برعونة طازجة، ذات ثغر يحمل ابتسامة من اختص وحده بسر تافه وبهيج، ابتسامة من لم يختبر الآلام بعد، يتكور داخل الجلباب ثديان أموميان بلا صلابة أو رخاوة، بل في لين العطاء وثبات عزمه. في خشوع يجثو أمامها طالب قميصه المدرسي الأزرق ملطخ بقطرات من الدماء، وفي يده مشعل متقد بالنار، ولم أعرف بالضبط إن كنت أقصد به نورا يبدد الظلمة، أم أنه كان يهدد بحريق هائل.
لم أنجح أن أجعلها تشبه مس هند، ولا التلميذ كذلك كان يشبهني من قريب أو من بعيد، كانا مزيجا من رسومات عدة قمت بنقلها، جسد السيدة الممتلئة المقرفصة، نقلته من صورة المرأة المرسومة على محاليل علب الجفاف التي تعطيها أمي لشقيقي الأصغر، أما باقي ملامح الوجه، خاصة العينين الواسعتين وشكل الأنف والشعر، فقد استعترهم من أغلفة جمال قطب بمكتبة أبي، أما التلميذ فنقتله من كتاب تعليم اللغة الإنجليزية، والمشعل من كتاب العلوم.
أدركت سريعا أنه لا يمكنني الرسم من الذاكرة أو الخيال، كل أملكه أن أنقل ما رأيته مرسوما، وكي أمحو أثر الجريمة، كنت أصنع مزيجا من عدة صور، لكني رضيت وقبلت الصفقة الملعونة. ألن تعيدني لوحتي إلى مرمى بصر مس هند؟ ألن ترفع عني الحرج والعذاب الأسبوعي الذي أتكبده أمامها وأمام كل مدرسي الرسم؟
قدمت اللوحة إلى مس هند بأنفاس محبوسة وقلب محموم، حدقت فيها طويلا بعينين متشككتين يفرزان العناصر على حدة، يعرياني ويعيدان اللوحة إلى عنصر واحد أصيل، جوهري الذي أرواغ لإخفائه: الرداءة، ثم سألتني: هل متأكد إنك أنت من رسمتها؟
تطلعت إليها بوجه حزين وعينين محبطتين، يغور فيهما الشعور بالخذلان عميقا، قلت بصوت خفيض منكسر ردا على اتهامها الخسيس: بالطبع أترغبين أن أعيد رسمها أمامك؟
أربكتها لمسة الصدق الوحيدة وسط طوفان من الأكاذيب، فقالت: لا.. إنها لوحة جميلة.
ظننت أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد، لكنها ظلت تحوم حولي بنظراتها المتشككة، تراقبني وأنا أواجه زملائي اللذين يعرفون عن يقين رداءة رسمي، كان اتهامهم أكثر جرأة ووضوحا، فأجمعوا أن شخصا أكبر سنا في عائلتي هو من رسم اللوحة.
كان تفسيري لذلك التحول ثابتا: الإلهام. ثم رويت أغرب حكاية ممكنة: كنت أسير في الشارع ثم تعثرت بحجر، وقعت على رأسي ورحت في إغماءة لم أعرف أبدا إن كانت طويلة أم قصيرة، أفقت لأجد نفسي وقد انكشفت لي أسرار فن الرسم.
ستظن أن من الصعب على أحد أن يصدق قصتي الساذجة، لكنهم فعلوا، لقد أرادوا تصديق شيئا كهذا لطالما رأيناه في الأفلام وقرأناه في قصص المغامرات وتناقلناه كأساطير عن أناس لم نقابلهم في حياتنا ولو مرة، كانوا في حاجة إلى قصتي لتثبت لهم أن الغرابة أمر حقيقي، ففي ذلك السن، كان يحدونا الأمل أن تكون القصص العجائبية ونظريات المؤامرة وحكايات الخوارق ممكنة الحدوث، أن صخرة العالم الجامدة والنهائية– كما بدأنا ندرك في أسى- لم تكن هي كل شيء. لقد فهمت جمهوري، ومنحته ما أراد، لو قلت لهم إني اختطفت عبر فضائيين ثم أطلقوا سراحي بعد أن أودعوا في عقلي السر والموهبة، لصدقوني، لكن السبب الأهم لابتلاعهم سذاجة قصتي، هو أني سردتها بالوجه الظريف والواثق لنصاب، بالعقل البارد والحدس الحاد الذي لا يتوافر إلا للص أو لجرذ، بغريزة اكتشاف المهرب عند الحصار عقب اقتحام جرىء، كنت مقنعا، أشعر بالسحر يلفني ويحيط بحركاتي وكلامي. يا لتفتح مواهبي المكبوتة، التي لم يعطلها إلا عجز واحد سخيف.
في نهاية الحصة، اقتربت مني مس هند، ثم طلبت مني اللوحة، قالت أنها أعجبتها لدرجة أنها قررت أن تشركها في مسابقة الرسم التي تعقد على مستوى المدارس بالمحافظة، كدت أن أصدقها، لولا أن لمحت ذلك الطيف اللعوب والساخر في عينيها، كان بإمكانها فضحي بإصرارها على أن أرسم أمامها، لكنها لم تفعل، لم أفهم مغزى لعبتها، حافظت على هدوئي، حاولت التملص، لكني أعطيتها إياها بالتحدي نفسه الذي طلبت به اللوحة.
تلك السخيفة القاسية، التي جثوت أمامها في اللوحة خاضعا، بدلا من أن تنتبه وتمتن لمعناها كقربان وهدية تخصها وحدها، كل ما همها إن كنت رسمتها بنفسي أم لا، وقد كرهتها في تلك اللحظة حقا، ألم أقل لكم أن الغرام ليس إلا الحلوى التي تغلف مرارة الحقد.
في الحصص التالية، لم يتذكر ولو طالب واحد الماضي المخجل لرداءة رسومي، كأنما وقعوا في إغماءة عقب تعثرهم في حجر، فأفاقوا منها بذاكرة جديدة، لا أثر فيها إلا لهويتي كموهوب، لم يطرح سؤال واحد متشكك عن الإسكتش الذي ملىء بنسخ متقنة من صور الأبطال الخارقين وشخصيات الكارتون التي سحرتنا في تلك الفترة، كسلاحف النينجا وكابتن ماجد وأفروديت الفاتنة وجراندزير الجبار، اختطفت الانتباه من رسومات عبد الرحمن التي ظلت متشبثة برهافة المناظر الطبيعية، للمرة الثانية أمنج جمهوري ما أراد.
ولأن الله ولي من آمنوا( وهي الآية التي ستظل شعاري الأول في الحياة عندما أكبر، لأنها تهبني الثقة، وترهب اللذين آمنوا في مواجهتي) فقد رسخت ضربة حظ فجائية أسطورتي في الرسم، عندما طلبت منا مس هند أن نرسم شيئا عن التوعية بمخاطر الإيدز، كان واحدا من الموضوعات السخيفة والجافة التي تفرضها الوزارة من وقت لآخر على الطلبة، والتي تحير الموهوبين أصحاب الخيال، لذا أعجزتني طويلا قبل أن يأتيني الإلهام.
كان الإيدز هو موضوع الساعة، طاعون العصر، يحذر منه رجال الدين والأطباء والصحفيون وصناع الأفلام، كأن وجوده هدية السماء التي تثبت لهم أن الجنس شيء قذر جدا، بالطبع لم أحلل الفكرة هكذا حينها، لكني التقطت ولو بطريقة غائمة جوهر ما أراد الجميع قوله، ما أراد الجميع رؤيته مرسوما.
رسمت بورتريها نصفيا لوجه رجل وسيم وآخر لامرأة فاتنة، وضعت كل منهما على حدة في صندوقين زجاجين يواجهان بعضهما البعض، بينهما حية في فمها قنبلة قد تهشم الصندوقين إذا ما مارسا اتصالا مخيفا.
حظت تلك اللوحة بنجاح فاق كل رسوماتي السابقة، ليس لفكرتها – التي أجدها الآن – ساذجة، لكن بسبب الصدفة التي جعلت من ملامح الرجل مطابقة لمدرس العلوم الذي كنا نكرهه جميعا لتسلطه وعنفه، وقد جعلته مدانا بشكل غامض، كما كانت هناك إشاعات أن شيئا ما بينه وبين مس هند. لم أؤكد أو أنفي أنه هو.
تضاعفت الهالة الأسطورية للوحة عندما رآها مدرس رسم شاب، كان قد حضر مكان مس هند في ذلك اليوم الذي تغيبت فيه، توقف كثيرا أمامها وأثنى عليها بشدة بسبب ما أسماه” الرؤية الفنية”، بل واستدعي زميلين له، وتناقشوا حولها طويلا، ولم يلتفت للوحة عبد الرحمن التي لا أتذكرها، لكني أظنها كانت شيئا سخيفا باهتا، يفتقد للعمق.
انهال علي زملائي بطلبات لرسم الوجوه، لكني استطعت التملص بتحديد سعر مبالغ فيه، فلا يمكنني تبديد طاقة فني على كل عابر.
علمت مس هند بأمر لوحة الإيدز، وهالها ما سمعته من زملائها عن الطالب الموهوب في فصلها، بعدها ضبطتني في الفناء أكثر من مرة وأنا أساوم الطلبة على بيع رسومي الدقيقة ذات الألوان الزاهية للأبطال الخارقين، فعلمت أن سمعتي تجاوزت الفصل.
ساعدني شقيقي الأكبر الذي كان في المرحلة الثانوية حينها بفكرة ذكية، طباعة تلك الرسوم على تي شيرتات، بل سوّقها في صفه الدراسي، ساعدتني أمي على ترويج المشروع لدى الأقارب والجيران.
بالمال الذي التهما أمي وشقيقي أكثر من نصفه، اشتريت دراجة حديثة استعملتها في الذهاب إلى المدرسة، كانت موضع حسد زملائي. لم يفسد هنائتي سوى نظرات هند الماكرة، التي تعرف الحقيقة، لكن ما الحقيقة إلا تراكمات صغيرة من الأكاذيب، حصن وحشي صنع لحماية كذبة واحدة تافهة، لم تكن لتضر صاحبها لو انفضحت باكرا.
لم تنفذ حيلي أبدا في عدم الرسم مباشرة بالفصل، لكن أفضل تكتيكاتي على الإطلاق كان التماهي مع الصورة التي كونوها عني، وأن أتقبل بلا تواضع الافتتان والإعجاب، أن أنخرط في النقاش والتنظير حول الفن، أن أشكو من الرداءة، أن أتحدث وأتصرف كفنان كبير، وألا ألعب أبدا دور الضحية كما فعل عبد الرحمن زهير، الذي شكك في موهبتي، فهزمته بحركة واحدة: التلميح بإصابته بالغيرة، ثم طورت هجومي، لأشكك في أصالة رسومه ومعناها، معلقا في عنقه كل إثم يمكن اتهامي به.
لم يصدق أنه يُهزم وأن نجمه قد انطفىء، وحل محله كوكبا زاهيا تحتشد من أجله الجماهير، كنت أقرب لنفوسهم، ألبي لهم شيئا لن يدركه أمثال زهير، أصير ما تمنوه، أرسم كما تخيلوا الرسم، فلم يروني كسيّد بل كمخلص لهم من أسر الفاتنين المتعجرفين، كنت أشبههم، مسيح العاديين البررة، آكلي الفتات والحشائش، المهرولين بلهفة إلى هاوية النسيان والجحيم، أنا السارق الحقيقي للنار، ربما لو لم تنته رحلتي سريعا لساعدتهم على انجاز انتحال لا يكشف، ففي مملكتي كان الكل مقبولا، لا يملك الصالح نجاته بصلاحه، ولا يخشى الطالح أن يقترب.
ظهرت نتيجة المسابقة التي أشركتي بها مس هند، ما لم يتوقعه كلينا أني فزت بالمركز الأول، بينما لم تصب لوحة عبد الرحمن الذي اشترك في المسابقة أي من المراكز العشر المعلنة. فازت لوحتي لأنهم أساؤوا فهمها كلية، فقد ظنوا أن المرأة ترمز للوطن، والطالب الذي يجثو أمامها هو مواطنها المثالي، الدماء على قميصه رمز لما هو مستعد لبذله، فسروا المشعل الذي يحمله، على أنه يقود الوطن عبر العلم من الظلمات إلى النور، يا للشناعة، لقد أهانوا فني. ابتلعت رأيي ووافقت على تكريمي الذي حضره وكيل الوزارة ومدير المدرسة ومس هند، كما أن شهادة استثمار بخمسمائة جنيه لم تكن شيئا سيئا.
لم تتخل مس هند عن نظراتها التي اكتسبت تهديدا شيطانيا، ثم ضغطت أكثر عندما اتفقت مع المدير على أن تقيم معرضا صغيرا للوحاتي بغرفة الكمبيوتر، كنوع من التقدير لموهبتي المميزة، لأدرك للمرة الأولى مغزى لعبتها، كلما كبرت الخدعة، صار انكشافها كفضيحة مدوية، وانسحقت تحت الجبل الذي صنعته من الأكاذيب.
ربما ظنت أني سأتراجع وأعترف ولو بدعوى الخجل، لكنها لم تعرف ما صرت عليه، لم أعد ذلك الخجول الذي يقع في الغرام من اللمسة الأولى، لقد أعاد الشيطان الذي قبلت صفقته اختراعي، ثقتي مطلقة، وإيماني وطموحي لا حدود لهما، لذا قبلت فكرة المعرض بتواضع مزيف وعينين مغرورتين قاسيتين، كتلك التي تملكها ربة الفنون والسيد المدلل المخلوع عن عرشه: عبد الرحمن زهير.
كان على مس هند أن تختفي، وقد وجدت طريقة.
أشعت عبر همس متقن أنها تذهب إلى شقة مدرس العلوم وحامل مرض الإيدز في لوحتي. لم تكن إشاعة بلا أساس، كانا يقفان معا كثيرا، يضحكان ويتبادلان الغزل وكانت تتغير لدى رؤيته، تصبح أكثر غنجا ولينا، وقد رأيته ذات مرة أثناء تدافعنا بعد أن ضرب جرس الخروج من المدرسة وهو يلح عليها كي تأخذ مفتاح شقته (أو ما ظننت أنه كذلك)، ربما كانت نظرتي المسمرة تجاهها هي ما جعلتها تأخذ المفتاح في جرأة وتحدي.
انتشر الهمس كعشب شيطاني، فصار من الصعب اقتفاء مصدره الأول، أثمرت الفضيحة عن اختفاء مس هند، تضاربت الأقوال عن مصيرها، قالوا أنها حولت للتحقيق، وأكد آخرون أنها نقلت إلى مدرسة أخرى، أشاعوا أنها في إجازة لتخفي فضيحة الحمل، وأقسموا أن أهلها اللذين ينتمون إلى الصعيد قد دفنوها حية، أما أنا فوضعت لمستي الفنية الساخرة، فقلت: إنها في النزع الأخير بعد إصابتها بمرض الإيدز الذي انتقل إليها من مدرس العلوم، ولم أندهش عندما وجدت كذبتي مؤيدين وذابت وسط الجماهير كحقيقة.
بعد اختفاء مس هند كنت أجلس طيلة الفسحة في غرفة الكمبيوتر أتأمل بفخر أعمالي المعلقة، رفعت أسعار رسومي، عينت مساعدا لي، فقد صار الاختلاط بالعامة يشعرني بالقرف، كنت كالمخدر، لا أكف عن الرسم، لكن ذات يوم، تعثرت بدراجتي في حجر، وقعت، أفقت بعد إغماءة قصيرة، مشمولا بالرعب، بيقين لم أذكر مصدره أن العقاب آت، وأن ذاكرة أصابعي نست مئات اللوحات التي تدربت على نقلها، أن عيني فقدتا السر الوحيد الذي سمحت لي ربات الفنون بمعرفته، ربما لن تصدق أن ذلك ما حدث فعلا لأني استخدمتها ككذبة من قبل، لكن ذلك ما حدث.
كان العقاب يتحسس طريقه بالفعل على هيئة امتحان مادة الرسم الذي اقترب بشدة، كنت أعلم أنه قادم لا محالة، إلا أني لم أفكر في الأمر طويلا، كنت مشغولا بملاحقة نجاحي وحمايته، بلغت من الثقة حد أني نسيت الحقيقة الأولى: لست فنانا ولا أجيد الرسم.
نبتت في ذهني خطة، أن أتدرب على رسم العناصر الشائعة، يكفيني أن أجيد رسم رجل أو امرأة من الذاكرة، ثم أغير ملابسهما فيتحولا إلى كل شيء، موظفين، عمال، فلاحين، فكرت ما الذي قد يكون شائعا أيضا فتوصلت إلى أشياء عدة، واستبعدت الشمس. وضعت قائمة بالعناصر التي علي التدرب عليها: السيارات، إشارة مرور، الأشجار، عواميد الإنارة، قطط وكلاب، عربات الكارو، فكرت أن عربة الكارو التي يجرها حمار مفتاح مهم، فسواء كان الموضوع المطلوب رسمه عبارة عن سوق أو غيط أو شارع أو مولد، فوجود حمار هو أكثر العناصر شيوعا، حتى لو طلبوا رسم مزار سياحي كالهرم، يمكن تطوير الحمار إلى حصان، أو الادعاء أنه كذلك.
سهرت طيلة الليل أحاول رسم حمار، كلما فشلت، كلما ازداد هوسي واصراري على رسمه، أدركت المجاز والنكتة، لا أشك أنه من وضع ربات الفنون وخيالهن القاسي في الدعابة.
في الثانية صباحا، بعد فشل عريض في رسم الحمار، أدركت أنه لم يعد لي الوقت للتدرب على باقي عناصر القائمة، استسلمت، صليت، دعوت، لكني أبدا لم أرتعد، لقد تجاوزت الشعور بالخوف، هذا العصب تم قتله فصار باردا كالثلج، كأنياب مسنونة ستفتك دون رحمة بمن يقف في طريقها، غدا سأفلت مهما كانت الظروف، سيجاورني زميلين، سأمزج ما سيرسماه وأنتج شيئا خالصا لا يمكن اقتفاء أثره.
قبل أن أدخل إلى اللجنة كنت بالغ الثقة في نجاح خطتي، ما أربكني أن المشرف على الامتحان كانت مس هند، لا أعرف كيف عادت، لكن عينيها كانتا مستعدتين لمتعة معركة أخيرة وفاصلة.
لا أذكر الموضوع الذي جاء في الامتحان، لكنه قطعا لم يكن يصلح لرسم حمار، عندما فشلت في اقتفاء أثر زميلي المجاورين لي، حاولت رسمه، مرة تلو مرة تلو مرة، لم أنجح في ضبط أي جزء فيه، لا الرأس والا الجذع ولا المؤخرة، فكان أقرب إلى كائن خرافي، لذا أشرت إلى نوعه كتابة، لاحظ من يجلسان بجواري أزمتي، تهامسا بالسر، فانتشر بين الفصل كله قبل أن أخرج من اللجنة، لم يشفق علي أحد سوى مس هند، وقد مسني ذلك، ووددت لو اعتذرت لها عن نشر أمر علاقتها بمدرس العلوم، لو أخبرتها صراحة بما لم تفهمه، أني ما ولجت النار إلا لأني وقعت في غرامها بالمقام الأول، نصحتني أن أرسم أي شيء أجيده كي أحصل على درجات تمكني من النجاح.
تغيبت بعد إجازة الترم الأول لشهر ونصف، بعد أن أدميت يدي العاجزة، ضربتها غاضبا في الحائط عشرات المرات، عندما عدت كنت آمل أن ينجيني فقدان الذاكرة من سخرية زملائي، لكني وجدت معرضي مازال قائما في غرفة الكمبيوتر، وهو ما أدهشني، لكني فهمت كل شيء عندما وجدت بين لوحاتي الرسمة البائسة التي رسمتها بالامتحان، وحش خرافي قبيح الهيئة تعلوه الشمس، الشيء الوحيد الذي أجيد رسمه، وقد حصلت بسببها على درجتين.
كانت اللوحة الوحيدة الأصيلة والحقيقية الموقعة باسمي، كذلك كان توقيع المصحح بجواره بارزا مع ابتسامة: مس هند.
يالقسوتهن.
صورة الشريط © حيدر ديوه چي