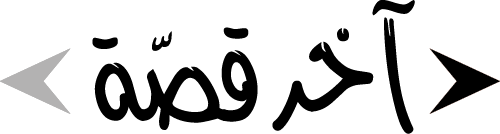١
في الأسابيع الأولى من دراستي في المدرسة الإعدادية كان كل تفكيري ينحصر أثناء حصص الصباح الأربعة في إيجاد طريقة كي لا أتعرض للضرب في فترة الفسحة. هكذا، بالتجربة وقليل من الحظ، وجدت الملاذ في مكتبة المدرسة.
يستغرب البعض حين تكون هذه إجابتي على سؤال كيف وجدت طريقك إلى الكتب؟ لا توجد إجابة أخرى. لقد عملت أمي لسنتين قبل أن تتزوج في مكتبة ضخمة في المدينة، وغير مرة زعم أبي أنه كان يقرأ في صغره، لكنّي في الحقيقة لم أر أيٍّ منهما ينحني على كتابٍ قط. أجل، كانت هناك مكتبة كبيرة تحتل الطابق الأرضي من منزلنا، لكن جدي، الذي قضى أيامه الأخيرة يقرأ مجلداتها الضخمة في ركن من حديقتنا، لم يكن يسمح لأحد منّا بالاقتراب منها مخافة أن نتلف ما فيها؛ كانت تلك المجلدات إرثه الغالي من أب وأعمام وأجداد تتلمذوا في أروقة الأزهر. كان بإمكاننا أن نعبث معه لكننا لم نفعل، لقد كنّا نعرف أنه لم يكن يستطيع أن يأخذ معه ذلك الإرث إلى القبر. كل ما علينا فعله كان أن ننتظر.
بعد يومين من وفاة جدي، وبإيماءة على فطور هادئ، نبهنا أبي إلى خطئنا. كان مدفوعًا بأمواجٍ من الامتنان والحب الجارف الغير مشروط تجاه والده ولأن المجلدات القديمة أغلبها دينية تبرع بالمكتبة كاملةً إلى أحد المساجد المجاورة صدقة جارية على روح جدي. بأصابع تحتضن مسبحة، بارك إمام المسجد ما قام به أبي وانتهت المكتبة كديكور في المسجد. لفترة كنت أتباهى أمام زملائي بأن الكتب كتبنا والرفوف رفوفنا، ثم توقفت عن ذلك، فرغم ترددي كثيرًا على ذلك المسجد في تلك الفترة، لم أجد مرة كتابًا خارجها.
استقبلت التغيّرات الجغرافية المصاحبة في المنزل بانزعاج ثم لا اهتمام. كان طبيعيًا حلول نيش أمي مكان المكتبة كي يفسح مجالًا لترابيزة سفرة جديدة وكبيرة. إنه السور الذي ضربه جدي هو ما أثار اهتمامي، فباستثناء الكتب الدراسية (ليست الحكومية منها) وصفحات الفن والرياضة والملفات المثيرة في مجلات روز اليوسف وأكتوبر، لم أقرأ شيئًا، والحقيقة أن ذلك لم يخلق نقصًا أو عائقًا أراه بيني ونفسي أو من حولي؛ بدا وكأن القراءة كانت شيئًا بإمكاننا الاستغناء عنه.
ليس في نشأتي ما نبأ بالذي سأكرس له حياتي الفارغة هذه، ولك أن تتخيل شعوري أول مرة دخلت فيها مكتبة المدرسة، محاطًا بالكتب الراقدة على الأرفف وملزمًا بالجلوس الهادئ حتى يمر وقت الفسحة بسلام. في ذلك الوقت لم تكن لدي نية في سحب كتاب. لم يكن لدي الفضول؛ كان يلزمني أن أرى عددًا لا بأس به من الناس يفعلون شيئًا ما حتى أفكر أنا أيضًا في فعله.
أيًا يكن، كان الجلوس بلا حراك أهون عندي من تحرش المتنمرين. آثار يدي الملولة على خدّي خير من أصابع حمراء لمتنمر على قفاي. فمنذ انتقالي إلى المرحلة الإعدادية، وإلى مدرسة أخرى بسعة طلابية أكبر، غير مشتركة، يغلب عليها طابع ذكوري حاد وتحكمها الفوضى، كنت عرضةً، لأسباب مهما حاولت تقصيها لا أعرفها، لشتى أنواع المضايقات، بدءًا من سخط المدرسين وحتى عمال المدرسة ومعاملتهم الوسخة لنا. لقد كان حقًا لهم سبنا وضربنا بأيديهم وبالخيرزانات الملفوفة بالبلاستر والمساطر الخشبية، أو كما في حالة المدير، ماسورة معدنية كالتي تستخدم في الغسالات القديمة. ثمة كذلك البواب الذي قذف قفلًا كبيرًا على طالب، والمدرس الذي كان يمسح السبورة بالطلاب، حرفيًا، وهنالك آخر كان يسر إلينا برغبته في نكح إحدى المدرسات، أو يطلب منّا الدعاء له في مهمته السريرية مع زوجته في المساء (ربنا يوفقك وتعمّر يا أستاذ)، أما الجائزة الكبرى فكانت من نصيب الناظر؛ لقد جعلت طريقته السادية في الضرب بيدين مشعرتين على الوجه بينما يغنى «الدبة وقعت في البير» أحدَ الطلاب يسمع الكلام ويحاول أن يقع في البير من شباك الدور الأول.
بعد الدبة والبير يأتي المتنمرون من الطلبة من نفس الصف، أو من صفوف متقدمة. فجأة تجد نفسك وقد هوت عليك قبضة أو صفعة أو لكمة. قد يختطف أحدهم الشطيرة من يدك ليأكلها أو يرميها على الأرض وقد يضع آخر إصبعًا في مؤخرتك لأنه أراد ذلك. كل تلك الأحداث التي تليق بفيلم أمريكي ردئ عن المدارس موجه للمراهقين وبطله دائما ضعيف. الفارق أن الأمر في مدرستي الإعدادية بشكل مركز (لم أر مسابقات استمناء في الحمامات الخلفية لأطفال عمرهم إحدى عشرة سنة) وأني كنت أعلم يقينًا استحالة انتصاري لأحصل على الفتاة.
سرعان ما تحولت من تلميذ إلى هدف. حاولت وأقمت الخطط لتخفيف الأمر؛ صرت أصل متأخرًا لأتجنب طابور الصباح، أتلكأ عند الانصراف، لا أذهب مطلقًا إلى الحمامات الخلفية، وفي الفصل ألتزم بالجلوس في المقدمة، أمام المدرس، ومع ذلك بقيت فترة الفسحة والحصص الفارغة منغصًا لا مفر منه.
جربت البقاء في الفصل، التسكع في الممرات أو القبوع في فصل آخر فارغ. كانت أيديهم تصل إليّ في كل مرة وكنت أعود إلى البيت متسخًا وملطخًا بالكدمات، ومهما اشتكيت أو جئت بأمي إلى المدرسة – لم يأت أبي ولو مرة إلى مدرستي – لتشتكي للمدرسين والإداريين، لم يتغيّر شئ.
وذات صباح بينما كنت أسير في الطرقات محاولًا تضييع أكبر قدر ممكن من الوقت أثناء حصة فارغة لمدرس بأجر تزوج حديثًا ولم يأت منذ أسبوعين، اصطادتني مدرسة أمام المكتبة بالضبط، كانت تعرفني، اسمها نادية، ترتدي بالتناوب خمارًا كحليًا أو أخضرًا وتحتفظ بشعيرات تحت أنفها كشارب مراهق، تدرّس المواد الاجتماعية وتردد بعفوية أن المصريين لا يمشون إلا بالكرباج. مبتسمة أعطتني زجاجتين فارغتين عليهما شعار كوكاكولا وأمرتني أن أملأهما بالمياه من المبرد ثم مالت عليَّ وسبابتها في وجهي حسك عينك المستر عاطف يشرب من الإزازتين. فاهم؟
٢
زواج أبي خطأه الأكبر. لماذا؟ أولًا لأن الرجل الذي سمعت عنه قبل الزواج لم يكن بشكل أو بآخر الرجل نفسه الذي عرفت. ثانيًا لأنه في حالة عدم حدوثه كان سيجنب نفسه وأمي قبله أعوام وحدة طويلة وعزلة مُرة وشجارات عديدة. وفوق ذلك إنها طريقة بسيطة تضمن عدم وجودي في هذه اللحظة لأحكي لك هذه القصة.
لقد أعرض كلاهما عن حكاية قصتهما لنا. لا أعلم إن كان ذلك عن إرادة أم أنه انطلاقًا من مبدأ أن الطبقة الوسطى هنا تتزوج غالبًا بالقصص نفسها والأسباب نفسها وبالتالي لا داعٍ إلى سرد ما هو معروف وشبه متماثل مع غيره. لكن حين كنت في سن التاسعة، صادفت حقيقة أن أمي في البداية لم تكن تبادل أبي الحب؛ كانت أمي – والتي قبل الزواج بأبي كانت قد فسخت خطبتين وتتأرجح في نهايات العشرينات من عمرها مما يعدها عانس في قرية مثل قريتنا في التسعينات – تحاول أن تقنع قريبة لنا بالزواج من شخص يشبه الحاج متولي وحين اعترضت قريبتنا بأنها لا تحبه ردت أمي يعني هو أنا كنت بحب يحيى قبل ما أتجوزه.
نظرت إلي، بيدَ أنها لم تعتقد أنها قالت شيئًا غريبًا.
مع مرور الزمن، وغالبًا في غياب أبي عن غرفة المعيشة، اعتدنا سماع اسطوانة أمي حول خطئها بالزواج، وعن شبابها المفقود، ونضال (حفاء، الكلمة المستخدمة بكثرة) أبي ليتزوجها. بتلك الطريقة عرفنا كيف كان ينتظرها طويلًا على ناصية الشارع حيث تسكن حتى تطل عليه ولو مرة، وكيف انتهت المحاولة الأولى للمس يدها قبل الخطوبة بضربة في صدره.
تحكي أمي وهي تحرك يديها بسرعة، كأنها تحاول أن تثبت شيئًا ما.
على الضفة الأخرى، وفي المرات القليلة التي انساق فيها الحديث إلى مثل تلك الأشياء، كان أبي يومئ لنا في رضا. كنا ننتظر ردة فعله، لكنه، أعتقد، كان يشعر بأنه غير مطالب بالرد، أو أنه لم يحس أن تلك الضربة في الصدر تستحق أن يخجل المرء بشأنها.
نسأله بسذاجة إن كان قد أحبها بالفعل، فيجيب وكأنه يجيب على سؤال بشأن إمكانية تغيير القناة على التلفاز.
طبعًا يا حبيبي، حبيتها.
حتى وإنت عارف إنها ممكن ماتكنش بتحبك؟ تستفسر أختي الصغرى.
ولو؟ يقول وهو يضع كوب الشاي على حافة الطاولة.
٣
لم تكن هناك حجرة للمدرسات. الحجرة التي تخص أعضاء التدريس لم يكن اسمها حجرة أعضاء التدريس، كان اسمها حجرة المدرسين ولم تكن هناك قابلية للاختلاط، لذا اعتبرت المكتبة ضمنًا حجرةً لهن؛ لخلوها من الطلاب معظم الوقت، ولدماثة وحسن خلق أستاذ إبراهيم منسي، أمين المكتبة.
هناك، تحت أعين الكتب الساكنة، على الأقل أربع أو خمس مدرسات، رائحتهن تعبق المكان، يلكن الكلام عن أحداث الأمس، يتبادلن الضحكات ويتنازعن العبوس فيما بينهن. أجتر الآن تلك الذكريات، سذاجتهن، عفويتهن، كيف عبّرن عن المشكلات اللاتي كن يقعن فيها وحتى طريقتهن البكر في نطق الكلام، كيف لشئ انتهى منذ زمن أن يكون حاضرًا داخلك ولو محاطًا بغبشة فجر هكذا؟
حين عدت بالزجاجتين، كانت المدرسات قد أنهين فطورهن وتجمعن حول شوقية، مدرسة صغيرة في السن، لها جسد هزيل يحمل آخرًا قيد التكوين. كنّ يتحسسن بطنها المكور الكبير في انتظار ركلة بدا أن كل شئ حولهن كان أيضًا في انتظارها. قلت شيئًا أو لم أقل، لا يهم، نظرن مجتمعات نحوي وأصدرت إحداهن ششششششش، فحبست أنفاسي.
أشار أستاذ ابراهيم منسي إلى مكان فارغ على مكتبه فوضعت الزجاجتين ووقفت أتابع المشهد. لم يكن هناك شيء مفتعل، كطفلٍ يمسك جلباب أمه في خوف أن يتوه في الزحام، لا شيء مفتعل في طفلٍ يمسك جلباب أمه في الزحام. لم يمض وقت طويل حتى أحست أنامل بعضهن الركلة، صرخن بفرحٍ وضحكن، ضحكت أنا أيضًا وكذلك ابتسم أستاذ إبراهيم منسي.
كانت شوقية لطيفة، بروحٍ جميلة وآثار لا تكاد ترى على الأرض، شئ مشترك في أولئك الذين تركونا ورحلوا مبكرًا. لسوء الحظ ماتت أثناء الولادة، ظللنا لفترة نتنسم بصماتها الشاحبة التي علقت بالأحداث اليومية المعتادة والمحيط حولنا، قبل أن تفلت وترحل عنّا قسرًا للأبد.
٤
بإمكاني القول أن المكتبة كانت معسكرًا نسائيًا بامتياز وكوني جئت من معسكر نساء أنا الآخر فقد ألفته مباشرة. لقد استعمرن المكتبة بنجاح وأيًا كان ما تستعمره النساء، فإنه سيظل معبقًا بالحميمية وقابلا لتسميته وطنًا.
كن يتبادلن الأدوية، وصفات العطارة، النصائح الطبية الغير موثقة والتجارب الحياتية الخاصة. كن كذلك يحضرن الأقمشة، الملابس الجديدة والمستعملة، المفارش، الكاسات ولوازم المنزل ويعرضنها بينهن، كذلك أمددن المكتبة بخط من المشروبات والأطعمة المعدة في البيت، كالبيتزا التي أحضرتْها مس رحاب وأعطتني منها قطعتين، سأكون كاذبًا إذا قلت أن طعمها لا يزال في فمي، لكنّي أتذكر أني استمتعت بها.
بعد أن شرّفت ركلة الجنين بحضورها، أتت أبلة نادية.
حملت الزجاجتين ونظرت إليّ نظرة لها معنى، قلت وأنا أتجنب التحديق في شنبها الصغير: أستاذ عاطف ماكنش بره. رفع أستاذ إبراهيم حاجبًا بينما قالت هي طيب وانصرفت بالزجاجتين إلى إحدى الطاولتين في المكتبة.
سألته ينفع أقعد هنا؟ رد طبعًا، بس اكتب اسمك في الدفتر ده.
جميع من في المكتبة كان لزامًا عليهم أن يكتبوا أسماءهم في الدفتر ده: المدرسات، المدرسون وكذلك الطلاب القلائل وحتى أستاذ إبراهيم منسي نفسه.
كانت صفحة الدفتر مقسمة إلى خانات. خانة للاسم، خانة للفصل أو المركز، وأخرى للتاريخ وأخيرة لكتابة ما تم قراءته. وقد كان الجميع يكتبون إما قراءة حرة أو يرسمون خطًا أفقيًا. أن تجد اسمًا يخص كتابًا واحدًا في الأيام العادية هو رابع المستحيلات. فقط في أيام التفتيش من الإدارة التعليمية، حينها – وياللمفاجأة – نعرف أن أبلة نادية قرأت المجلد الثاني من شخصية مصر، وأبلة راضية ومس رحاب قرأتا ديوان المتنبي و الفلسفة الحديثة لتاتاركيفتش بالتناوب، نكتشف أيضًا أن أستاذ حسن قرأ كتاب الكبائر مجددًا – كتاب لم يكن بالمكتبة أصلًا – وأن مستر عاطف بيشوي عاد لأقباط ومسلمون.
كتبت اسمي، ورسمت خطًا محل عنوان الكتاب والتاريخ وجلست في ركنٍ منزوٍ لا أعرف ماذا أفعل.
المكتبة حجرة مستطيلة في الطابق الأرضي، يطل بابها على حوش المدرسة والذي لم يتسن لأي طالب من فصلنا، طوال ثلاث سنوات، فعل شئ فيه سوى لم القمامة وتنظيفه. للمكتبة نافذتان كبيرتان في الجدار اللصيق بحقل ذرة، وفي الداخل تتراص الكتب على الأرفف فتزين ثلاثة جدران وطاولتين مستطيلتين بعرض المكتبة بمفارش خضراء تتحلق حولهما مقاعد خشبية سيئة الصنع. هناك أيضًا طاولة صغيرة يجلس عليها أمين المكتبة وبجانبها دولاب معدني عليه جلادٌ ورقي رخيص، وثمة بضعة لوحات ورقية سيئة الجودة تغطي الظاهر من الجدران فوق وحدات الكتب عن الإرشادات الواجب اتباعها، بالاضافة إلى رؤية المدرسة ورسالتها.
لم يكن هناك شئ آخر ألاحظه. لم أفكر في المكتبة كملاذ، ما شغلني حقا كان عيون الكتب، لقد كانت غريبة.
توسدت يديّ على الطاولة، محدقًا عبر النافذة في بيت طيني وسط الحقل، أسمع بغير اهتمام أصوات من حولي في انتظار أن يمر الوقت.

٥
في الفترة نفسها، كان أبي وأمي يتشاجران لدرجة أنّي وأختيّ كنا نقسم أنفسنا فرقتين، من سيذهب مع من في حالة الانفصال. كانت ياسمين أختي الصغرى في فريق بابا دائمًا، بينما كانت ورد في فريق ماما، وأنا حسب الحالة المزاجية، لكنّي كنت أميل إلى فريق ماما. لم يكن هناك سبب لذلك سوى أنه سيتسنى لي اللعب مع أولاد خالي؛ لم يكن مسموحًا لهم أن يأتوا عندنا.
عكس ما كنا نتوقع في كل مرة، لم يكن يحدث شئ. هدوء تام ومريب بعد العاصفة. يكمل أبي مشاهدة فيلم على التلفزيون وتكمل أمي محادثة صديقة لها كانت قد اقتطعت في المنتصف.
في الحقيقة، لقد جربنا الفرق مرة واحدة.
كان يوم جمعة، في صالة منزلنا كنت أتابع شيئًا ما يذاع على القناة الثانية. ورد كانت جواري وياسمين في غرفة البنات نائمة. كانت الساعة تشير إلى العاشرة مساءً وكنت أحاول بشدة ألا أسقط فريسة للنوم في اليوم الوحيد الذي يسمح لي فيه بالسهر. كان أبي قد خرج عصرًا وأتى منذ ساعة. منذ دخل إلى أمي المنتظرة في غرفة نومهما بدأ صوت جدالهما يشاركني مجلسي في الصالة. ذهني كان مقسمًا بين ما أراه على التليفزيون، وكذلك في جريجور سامسا الجالس على كرسيه ذي المسندين يحدق في ليل المدينة النائمة، وفجأة صعقتني صرخة أمي.
جريت وفتحت الباب. كانت أمي جالسة على طرف السرير، شعرها الفاحم يود الهرب من رأسها الصغير. ظهرها محني وتبكي. رأيت دموعها تنزلق على خديها قبل أن تستقر في راحتيها المفرودتين على حجرها ثم نظرت إليّ. كنت لا أزال ممسكًا بمقبض الباب غير فاهم، أنظر إليها وإلى أبي الواقف خلفها يحاول لمسها، احتضانها، تهدئتها بدون فعل أي شئ من ذلك.
قال لي على أوضتك ووضع يده على كتف أمي.
لكنّي لم أبرح مكاني. زعق: قلت لك على أوضتك، في نفس الوقت الذي تملص فيه كتف أمي من يده. أغلق أبي الباب على عدم فهمي فرجعت إلى الصالة. كانت ياسمين قد استيقظت، وسألتني ورد إيه إللى بيحصل؟ لم أعرف كيف أجيبها. كتمنا صوت التليفزيون وجلسنا نفحص ما يصلنا من التلعثم في كلام أبي والحرقة في شهقات أمي.
بعدها خرجت أمي من الغرفة يتبعها أبي. كانت ترتدي زيّ خروج وتتأبط حقيبة قماشية متوسطة الحجم. قالت قوموا البسوا، وأخذت ياسمين من يدها تجاه غرفة البنات.
حاول أبي إمساك يدها، خليكي، نترت يده، خليكي قال وهو يتبعها، خليكي، قال وهي تساعد ياسمين في ارتداء ملابسها ثم تنتقل من حجرة البنات إلى حجرتي، خليكي، قال وهي تأمرنا أن نأخذ حقائبنا وأدواتنا المدرسية، خليكي.
لم ترد أبدًا.
بدأت أختاي في البكاء وكذلك أنا، حاولنا ثني أمنا عما تنوي فعله.
متروحيش، قال أبي ونحن نجتاز الباب الداخلي. البرد غلّف حديقتنا الصغيرة.
هس، متعيطوش، أمرتنا أمنا في حزم. نزلنا السلم الرخامي. بينما كنا نسير عبر الحديقة، صرخ أبي من خلفنا، في محاولة يائسة أخيرة لإجبارها على البقاء.
– لو خرجتي من الباب مش هاجي أرجّعك.
سكنت أمي واقفة، أغمضت عينيها للحظة، ثم مشت وفتحت الباب الخارجي.
كان الشارع خاويًا. إنه الشتاء والناس في قريتنا دجاج ينامون من المغرب. نظرتُ إلى ضوء خافت من إحدى النوافذ المفتوحة في مبنى مجاور، أحسست بأحدهم جالس على كرسيه خلفها. مباشرة تذكرت الكتاب الذي كنت قد استعرته من المكتبة، بينما موكبنا الباكي يسير، جميعنا صرنا فريق ماما.
تملكتني الحيرة، هل أرجع لأحصل على الكتاب؟ موعد تسليمه للمكتبة يوم الأحد، لكن ذلك لم يكن السبب، لقد أردت إكمال قراءته.
لازم أرجع، كتاب مهم من المدرسة وهمتحن فيه، كذبت. بهذه الطريقة فقط كان يمكنني العودة.
كانت غاضبة وسبّتني. يدها مرفوعة في الضوء الأصفر لعمود الإنارة، كانت على وشك ضربي. ثم أخذت أنفاسًا طويلة متقطعة.
نفس. كانت هذه طريقتها كي تتمالك نفسها. نفس. طريقة تعلمتها من متابعتها لإبراهيم الفقي. نفس.
روح هاته، قالت.
وضعت حقيبتي المدرسية أرضًا وجريت. حمل الهواء صوتها من خلفي، هفضل واقفة هنا أستناك.
آخر مرة رأيت الكتاب كان على مكتبي جوار مذكرة اللغة الإنجليزية. لم أكن أريد أن أرى أبي لأنّي كنت خائفًا من ردة فعلي وفعله. الباب الداخلي كان مفتوحًا، دخلت خلسة. التليفزيون مكتوم الصوت ما زال شغالًا، أتذكر الآن أنه كان يبث فيلمًا بطله فريد الأطرش.
لم أكد أتقدم خطوتين في حجرة المعيشة حتى صدمت بأبي ممددًا على جانبه الأيسر على الأريكة البنية، ظهره لي وهو يبكي. اقتربت منه، كان ينتفض على فترات ويلمس بيده ظهر الأريكة. وضعت يدي على كتفه، ببطء التفت إليّ. مالك يا بابا؟ كانت المرة الأولى التي أرى تلك النظرة في عينيه. مفيش، اعتدل ومسح دموعه في كم قميصه واحتضنني قائلاً بصوت مختنق: أنا آسف ماتعيطش. حينها عرفتُ أنّي سأبقى معه.
من الحديقة أتى صوت ورد، كان الهواء يراقص شعرها. أخبرتها أنني لن آتي، ظلت واقفة لثوانٍ ثم ذهبت. توقعت أن تعود لتخبرني أن أمي تصر على مجيئي. انتظرت لبعض الوقت لكنها لم تعد.
في الداخل، كان أبي جالسًا على الأريكة، يستجمع شتاته. سألني إن كنت أريد أن آكل، أومأت. أعدّ لنا بيض عيون وجبنة وزعتر وجلسنا نأكل ونحن نشاهد فيلمًا آخرًا على نايل سينما لإسماعيل ياسين. كنت أختلس النظر إلى أبي بين كل حين وآخر. بدا لي عجوزًا وليس حاضرًا، يمضغ طعامه بآلية وينظر إلى التليفزيون بعينين زجاجيتين. سألته إيه إللي حصل؟ قال حاجات تخص الكبار، ملكش دعوة بيها. سمح لي بالسهر أكثر من المعتاد وأمرني أن أغسل أسناني قبل النوم ولما تكدست في سريرى جاء وقبلني قبلة على جبهتي، وقال تصبح على خير.
في الصباح التالي أعدّ لي فطورًا كالعشاء. لم ينبس بكلمة إلا عند الباب وحينما عاد من الخارج لم يكن بخير، مالك يا بابا؟ مليش، دلوقتي هنام وهكون كويس. كان دائمًا هكذا.
على المكتب، كان المكان الذي كنت أتوقع أن أجد فيه كتابي المستعار خاليًا. قلبت المنزل ولم أجده، رجحت أنه في الحقيبة المدرسية التي أخذتها أمي معها، ثم أخذت أفكر في أمي، هل ستعود؟ وإن عادت هل ستكون غاضبةً مني؟ كيف حال أختيّ؟ هل حصلتا على قسط من الراحة كالذي حصلتُ عليه؟ التليفزيون لم يكن يعرض شيئًا يستحق المشاهدة فصار لديّ اليوم بطوله لأفكر فيهن. لكن أمي لم تدعني للأسئلة؛ وأنا مثقل بالندم من قرار البارحة، في الساعة الحادية عشرة عادت. كان وجهها هادئًا ومظهرها حسنًا، في حين كان مظهر أختّيّ مثيرًا للشفقة.
من اللحظة الأولى التي أعقبت دخولها من الباب الداخلي عرفت أنها لن تسامحني على البارحة. سألتني عن أبي. نايم، تلقتها بتنهيدة، ظلت تروح وتجئ في الصالة بلا هدف قبل أن تحسم قرارها وتقصد غرفة نومهما. في داخلي، كنت أرجح أن أبي قد يكون مستيقظًا ويستمع لكل شئ. ربما كان ينتظرها.
سألت أختيّ عن تفاصيل ليلة البارحة، كانتا متعبتين ولا تعرفان شيئًا. وقفت وراء الباب لبعض الوقت، كنت أتبين نبرة الصوت لا الكلمات. يتحدث هو لبعض الوقت ثم تتحدث هي. أوقات يتقاطعان وأوقات يبقيان فيها صامتين . ظلا على هذه الحالة لوقت طويل وحين خرجا كانت البارحة كأنها لم تحدث. انتهى الأمر وسيكون عليَّ أن أتأسف لأمي طويلًا على ما فعلت.
في منتصف غرفة المعيشة، كانت ضمن الحقائب حقيبتي المدرسية. لم يكن الكتاب داخلها.
٦
الطريقة التي تحدثت بها عن مدرستي الإعدادية قد تعطي انطباعًا خاطئًا بأنه لم يكن لي أصدقاء في تلك الفترة.
لقد ورثت أشياءً كثيرة عن أبي: الذقن العريضة، الضحكة المعطوبة، القولون المضطرب والرغبة في الجلوس وحيدًا. كذلك كان لديّ مثله أصدقاء طفولة راحوا لحالهم مع الوقت وقد كان يحدث ونحن نسير أنا وأبي في شوارع القرية أن نقابل صدفة أحد هؤلاء الذائبين فيسلم عليه أبي بحرارة، عمك كذا كان صديق تختة. حدث ذلك بضع مرات، مع أناس مختلفين ودائمًا كانوا أصدقاء تختة ما جعلني أسأله مرة عن حجم هذه التختة. لكن بوضع أصدقاء التختة هؤلاء جانبًا، لم يكن هناك صديق لأبي سوى بابا محمود إسكندر.
بالنسبة لي، كان لديّ صديقان في تلك المرحلة.
الأول اسمه حاتم، يماثلني الطول والذكاء، كلانا ارتدى عوينات وكنا متلازمين، هذا في رأيي ما جعل الناس يسألوننا انتم اخوات؟ كان بارعًا في الهرب من المدرسة، بعد الحصة الأولى وأخذ الغياب؛ أنظر حولي فلا أجده. حاول غير مرة أن يسحبني معه إلى الوقت الخالي بالخارج، ولأنّي أميل للمشي جنب الحيط لم أسمع كلامه.
الثاني، أحمد خليفة، كان أكثر أطفال المدرسة وسامة ويعرف طريقه مع الفتيات، غادرنا بعد الابتدائية ليدرس بالشبان المسلمين الخاصة ببنها مما يعنى عدم رؤيته إلا في الصيف.
كنت وحيدًا في ساعاتي في المكتبة. تجدر هنا الإشارة إلى طبيعة الطلاب القلائل الذين كانوا يترددون على المكتبة. في الأغلب، أوائل المدرسة أو أولاد المدرسين. أحيانًا الاثنين معًا. لقد كان أوائل المدرسة يفضلون مراجعة الدروس في أحد الأركان، أما في حالة كونك من أولاد المدرّسين فهذا كان يوفر لك درسًا خصوصيًا مجانيًا من أحد الأساتذة المتوفرين في المكتبة ولأني لم أكن من أولئك ولا من هؤلاء فإن رحلتي في القراءة بطيئًا أبحرت.
كانت الكتب مقسمة حسب طبيعتها تقسيمًا متواضعًا في وحدات خشبية من خمسة أرفف.
الوحدة الأولى كانت معنونة باللغة تليها وحدة الديانات فالأدب فالفلسفة فالاجتماع فالتاريخ والكتب المتنوعة ثم الكتب العلمية.
لقتل الوقت، صرت أتخبط بين تلك الوحدات. فتحتُ أجزاءً من لسان العرب والأغاني والمعجم الوجيز والقواميس الضخمة، وكأي طفل فضولي بحثت عن الكلمات المحرمة، وأمسكت رسالة الغفران للمعري لأن ذلك قد يثير ضحكات البعض، وقلبت صفحات لم أفهم منها حرفًا لمؤلفين لم أعرف كيف أنطق أسماءهم، ثم استهدفت لفترة المجلدات التي تحتوى على صور ملونة أتذكر منها واحدًا عن حيوانات الغابات الاستوائية وآخرًا عن حيوان الباندا. هناك أيضًا مجلدات للرؤساء، السادات ومبارك (غالبًا بالألوان) وناصر الذي كان أبي يكرهه (بالأبيض والأسود) ثم وقعت يديّ على مجلدات ناشيونال جيوجرافيك للشباب بالعربية، صفحاتها الملونة حسنة الملمس ومواضيعها الممتعة سهلة الهضم. لأيام صار لي برنامج قراءة منتظم. عرفت أن عمرالفهد قد يصل إلى خمس عشرة سنة، وامتصني مقال عن هجرة السلمون، واكتشفت أن مكاني في الأبراج الصينية هو برج الخنزير، مما جعلني مستاءً لفترة قبل أن أجد العزاء في أن جميع من ولدوا في ١٩٩٥ هم كذلك برج الخنزير.
بعد انتهائي منهم كلهم حاولت إعادة قراءتهم لكن ذلك لم يكن على القدر نفسه من المتعة السابقة.
سبحت في فترة جديدة من التخبط السخيف بين صفحات كتب عشوائية حتى حدث صدام مبتذل للغاية بين أستاذ إبراهيم منسي وأستاذ حسن شعبان. كان الأستاذ ( يغضب ممن ينادونه مسيو) حسن مدرس اللغة الفرنسية قد توصل إلى اتفاق ودّي مع مدير المدرسة على إزالة كتب نجيب محفوظ من المكتبة بدعوى أنها تدعو إلى الفسوق والفجور والإلحاد، كلمات كانت تأتي معًا. في رأيه، كانت كتب نجيب محفوظ لا تليق إلا ببيوت الدعارة.
متمالكًا لأعصابه بالكاد، حاول الأستاذ إبراهيم منسي بشتى الطرق منع تلك المهزلة، لكن هيهات أن يقف ذلك أمام خطب الأستاذ حسن المطولة عن مدى فجور الرجل وما يدعو إليه في كتبه، حتى عندما حوصر بسؤال الأستاذ إبراهيم إنت قريت الكتب؟ ها رد عليَّ؟ إنت قريت الكتب؟ قريتها؟ أجاب بلا مبالاة: وأقرأ حاجات وسخة زي دي ليه؟ المدرسات كن يستغفرن الله، لقد كنّ ينشدن فقط الهدوء السابق في المكتبة. ومستر عاطف بيشوي فضّل الحياد الصامت، ربما لمعرفته بما قد تجلبه المشاركة من عواقب. والأساتذة الباقون والطلاب يروحون ويجيئون.
لقد كان منظرًا مثيرًا للشفقة. الأستاذ إبراهيم متعثرًا في الكلمات، يحاول أن يستميل البعض بقراءة أسطر متفرقة من كتابات محفوظ لدحض كلام الأستاذ حسن: «عندما يحل الخلاء بالأرض فإنها تمتلئ بدفقات ذي الجلال.» لكن كل ذلك كان يذهب هباءً أمام الكلمات السحرية الثلاث وأشياء مثل فاز بنوبل مكافأة على أولاد حارتنا، صدق على العلاقة الغير شرعية بين الرجل والمرأة، آمن بانتصار العلم على الدين، صور العاهرات والراقصات بصورة حسنة.
بعد تأزم الموقف وتهديد الأستاذ إبراهيم بكتابة مذكرة إلى الإدارة التعليمية؛ – عرفتُ بعد ذلك أنه كتبها وأرسلها فعلًا ولم ير العاملون هناك في الموضوع ما يستحق الانتباه – استدعى أستاذ إبراهيم إلى مكتب المدير (الذي كانت تشغله أمور أخرى) ومكث طويلًا هناك ثم عاد وجلس بلا كلمة على مكتبه وجعل يعبث بالأقلام الموجودة داخل كوب خزفي ثم قام وأخذ كتب نجيب كلها ووضعها على الطاولة أمام الأستاذ حسن.
– خدهم، صرخ في وجهه، أنا هتحمل المسئولية، ارميهم، احرقهم، مادام هيريحك. أقولك على حاجة؟ احرق كل الكتب اللي في المكتبة.
لم يؤثر هذا في الأستاذ حسن. دفع كرسيه إلى الوراء وحشر بكل همة كتب محفوظ (طبعة مكتبة مصر) في حقيبته. غاب حوالي ربع ساعة قبل أن يعود نافخًا ريشه يحكي لنا بالتفصيل الممل وبسخف من يتحدث عن نصر مبين ماذا فعل في تلك الكتب.
هناك درجة أخرى من السخف الشديد هنا، المكتبة كانت تزخر بكتب، حسب وجهة نظر الأستاذ حسن شعبان، أخطر من مؤلفات نجيب محفوظ. أستاذ إبراهيم كان يستغل جهل الناس في المدرسة بالقراءة ليجلب من الكتب ما يشاء إلى المكتبة، ففي الوقت الذي كان أستاذ حسن يرسل زخّات الحكمة اللانهائية في بصاقه إلى المفرش الأخضر، كانت كتب نصر حامد أبو زيد تتأمل جمال قفاه. لكنّي لم أعرف ذلك وقتها.
أظن أن ما تملّك الأستاذ إبراهيم وكان ظاهرًا في عصبية حركاته والعبوس في وجهه، بجانب توقّعي لإحساس بالعجز والهجر والغضب بسبب رضوخه لحكم بمثل هذه السخافة هو القرف. نظر إلينا جميعًا بقرف وكأنه على وشك أن يغرقنا في بحر من البصاق. ثم دفن وجهه الأحمر في كتاب أمامه، ساقه اليمنى لاحظتها تهتز وظننت أنه ربما سيظل هكذا إلى آخر السنة، لكن بعد حوالي أسبوعين ماتت الأستاذة شوقية أثناء الولادة وقد غير ذلك مجرى بعض الأمور.
بسبب تلك المجادلة ولأنّي فضولي، أردت أن أعرف ما كتبه الرجل ليعمل كل هذا القلق. كان كل ما أعرفه عنه أن معه نوبل وأنه مات في الصيف الماضي. أردت أن أعرف أكثر، لذا بعد يومين وقبل موعد الانصراف ولا أحد غيرنا في المكتبة، سألت الأستاذ إبراهيم منسي بصوت خفيض، وكأنني أشتري مخدرات، إن كان يمكن أن يجعلني بطريقة ما أقرأ أحد أعمال نجيب محفوظ ده.
– أولاد حارتهم ممكن؟
– أولاد حارتنا؟ رفع حاجبيه وصحح لي.
ربت على كتفي وهو يبتسم ويردد بيتًا من الشعر ضاع من رأسي وقال حاضر، وفي اليوم التالي سلمني زقاق المدق قائلًا إنها من المجموعة الخاصة بوالده أعيدها متى انتهيت منها شرط أن أحافظ عليها.
٧
لقد كان أستاذ إبراهيم منسي يشبه أبي في كثير من الأشياء ولا يشبه أحدًا ممن أعرف في أشياء أخرى.
كان نحيفًا، في الأربعينيات، شعره أسود متوسط الطول ناعم، وعلى الرغم من أنه كان يعبس أحيانًا إلاّ أنه لا يمكنني تذكره دون ابتسامته، ابتسامة شخص سمع للتو مزحة محكمة تعبّرعن بؤس حياته. قليلًا ما تحدث عن حياته الخاصة. لم أعرف عنه سوى أنه كان متزوجا بلا أولاد ويسكن بعيدًا على الجانب الآخر من الترعة، وبقيت لفترة طويلة لا أعرف غير ذلك. منزله زرته مرة واحدة فوجدته محاطا بسياجٍ عالٍ من الورق الأخضر وخلفه تقع جنينة برتقال عرفت فيما بعد أنه ورثها عن والده.
قبل انتقالي للقاهرة كان هو أكثر من أعرفهم قراءة. كان يكتب قصصًا قصيرة، لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، ربما لأنّي لم أفهمها، وتشبه قصص إبراهيم أصلان المبكرة بحوارات أكثر غرابة. هو نفسه كان يبدو كشخصية خارجة من قصة لإبراهيم أصلان أو ربما كإبراهيم أصلان نفسه: الردود المختزلة والعجيبة، التأمل الغامض للمحيط وانطباع يسري فيك أنه يُخفي سرًا ما. حتى نهايته كانت أصلانية بامتياز، لقد تلاشى بلا أثر في عام الثورة، بشهادة البعض، أكثر الأعوام ربيعية في حياته، فص ملح وذاب، كأي قصة قديمة عن الاختفاء المفاجئ لشخص ما، خرج ولم يعد حتى الآن.
في يوم جمعة قبيل مجئ عيد الأضحى ببضعة أسابيع، الجمعة التالية لخروج وعودة أمي من المنزل، ماتت أبلة شوقية.
لم أكن أتخيل أن المكتبة سوف تفتح لفترة. لم أكن أفهم كيف تسير الأمور. الأساتذة يتحركون ببطء، يعزون بعضهم ويرحلون عن الفجيعة بحياة ابنتها الصغيرة والتي سميت باسمها، شوقية، اسم مريع لطفلة لكنه وبشكل إلزامي صار محببًا. كانت أبلة نادية تعرف تفاصيل موتها بحكم أنها جارتها لكنها أعرضت عن الحديث وحتى المشاركة في الإفطار وشرب الشاي، بل طلبت من أبلة راضية أن تحل محلها في حصص ذلك الأحد.
جلستْ قريبًا منّي ويدها على خدها تنظر إلى المفرش الأخضر أمامها، وحين ظننت أنها قد تظل هكذا لأخر اليوم قامت وعلى خدها أثر كفها. أخذت شنطتها، أنا ماشية يا رحاب.
رايحة فين؟ تساءلت مس رحاب معبرة عن دهشة وليس في انتظار أي إجابة.
مروّحة.
قامت مس رحاب في إثرها. كانت ترتدي إسدالًا طويلًا يقبل ذيله الطويل الأرض.
خرجتا عبر الحوش ناحية البوابة، كانت السماء بلا سحب والصقيع يجعلنا أكثر شحوبًا. أستاذ إبراهيم كان يتابعهما عبر الباب وأنا – الذي كنت قد قررت بعد تردد طويل أن أعود للفصل الأخير من تحول كافكا – توقفت عن القراءة.
لم يعد في المكتبة سوانا وكنت أرشق في عينيه نظرات مرتابة. مال بجسده ليحصل على رؤية أفضل ثم اكتسى وجهه الجدّ. وعندما أسرعَ إلى الخارج أوقع زجاجة بلاستيكية عليها شعار كوكاكولا.
بعد فترة لم تسمح لي بمد تساؤلاتي رجعوا ثلاثتهم. الأستاذة نادية وجهها أحمر كثمرة طماطم، كانت تبكي وخمارها قد اختل شيئًا بسيطًا فظهر جزء من شعرها المصبوغ بالحنة. كانت غاضبة وترتجف، وكانت تكرر أنا كويسة يا جماعة سيبوني.
أجلسوها على أقرب كرسى وأستخدموا الزجاجة البلاستيكية من على الأرض كي يمسحوا وجهها حتى فرغت فأمرتني مس رحاب أن أملأها.
حين عدت، تطوع أستاذ إبراهيم الذي كان واقفًا أمام المدخل لا يدرى ماذا يفعل وصنع لها كوبًا من الماء بالسكر. عندما أخرج الملعقة الصغيرة من الكوب رن جرس الحصة الثالثة، توسلت أبلة نادية لهم أن يجعلوها تمشي، لم ترغب أن يراها أحد هكذا، وافقت مس رحاب بشرط أن تذهب معها.
في اليوم التالي لم تأت الأبلة نادية. سأل الناس مس رحاب عنها فقالت بخير، هترجع بكرة ولا حاجة، هي بس متأثرة بموت شوقية، إنتم عارفين إنها كانت بتعتبرها زي بنتها مش بس جيران. قعدت معاها لحد الساعة اتنين لحد ما بنتها جت من المدرسة، كل ما تفتكر شوقية تعيط وتقول ذنبها إيه لسه صغيرة وغلبانة أقول لها استهدي بالله كده ووحديه تقول لي مانا موحداه بس ذنبها إيه المسكينة ماتت لوحدها، محدش معاها أقول لها ده قضاء الله وقدره تقول لي ولدوها في عيادة دكتورة وروحت في نفس اليوم، سموا البنت في الأول سارة، كانت قاعدة مع اخواتها وفجأة حست بتعب، خافت تقلقهم فقفلت على نفسها الحمام وجالها نزيف. فيه إيه يا شوقية مفيش، طب افتحي، أنا كويسة يا جماعة سيبوني، كسروا عليها الباب لقوها غرقانة في دمها الكلام ده بعد نص الليل. مش لو كانوا ودوها مستشفي من الأول كان يمكن عاشت، أقول لها وحدي الله مينفعش كده تقول لي مانا موحداه بس مش لو كانوا ودوها من الأول مستشفي مش كان يمكن عاشت.
اضطرب وجه الأستاذ إبراهيم، طلب من أحد الحاضرين أن يأخذ باله من المكتبة بحجة أنه ذاهب للحمام، خرج بسرعة وعاد بعد ساعة.
أتذكر أنه بعد ما يربو على السنة، دخلت علينا أبلة نادية في يوم تحمل شوقية الابنة، شوفوا معايا مين؟ كانت ترتدي فستانًا أبيضًا مزينًا بورود بنفسجية وتزين رأسها توكة وردية. الجميع أجمع أنها تحمل ملامح أمها لكنني لما اقتربت منها لم أر ذلك. جميلة كانت وهي تمسك بخمار أبلة نادية، وتختبئ في حضنها كلما حاول أحدهم مداعبتها. بكت في أيدي أغلب من حملوها وسال لعابها على قميص مستر عاطف بيشوي ولما حملها الأستاذ إبراهيم بيديه نظر إليها وبكى هو.

٨
البارحة على الإفطار قالت أمي وهي تضع طبقًا صغيرًا من الزيتون الأخضر على طاولة المطبخ: لازم تروح لعمتك نوال، محمد ابنها كلمني وقال لي إن حالتها تعبانة من بعد يحيى. نظرت في عيني ترى أثر كلامها. سألتني إيه؟ مالك؟ ثم أنّت وهي تجلس قبالتي.
أوضحت لها: انت قلتي لي الكلام نفسه إمبارح.
غرقت داخلها لوهلة ثم بكت بلا صوت. كان لديها ذلك الهوس من الإصابة بالألزهايمر، كأن تجذب يدي في المطبخ وتقول لي أنا حاسة إني هيجيلي زهايمر، أنا بنسى حاجات كتير ما ينفعش أنساها، امبارح نسيت شنطة الخضار في السوق وروحت البيت.
قمتُ إلى جوارها واحتضنتها، همستُ لها بكلمات التهدئة المعتادة وعرضت عليها أن نذهب لأي طبيب، وعكس كل المرات السابقة وافقت.
كانت قد ازدادت حجمًا في السنوات الأخيرة وصارت أبطأ. طلبت مني أن أحضر كيس الدواء وأوقظ ورد وياسمين. ثم قالت لي بعد أن ألقت بكبسولة ملونة في فمها، إمبارح قبل ما أنام وأنا على السرير نسيت شكل أبوك يا علي، مكنتش قادرة أفتكره، اتجنّيت وحسيت نفسي مخنوقة، قمت وفتحت الصور بتاعته وقعدت أعيط. أبوك وحشني بسرعة يا علي.
دخلت ياسمين إلى المطبخ واحتضنتها. قمتُ إلى غرفتي، بنصف انتباه أقرأ في حديث شخصي لبدر الديب وأدون في الهوامش رغبتي في الرجوع إلي القاهرة.
كانت الساعة تشير إلى التاسعة حين قررت أن أذهب لعمتي. مشطت شعري وارتديتُ تيشيرت أبيض وجينز أزرق وأخبرت أمي وياسمين عن وجهتي وسألتهم لو عايزين حاجة من بره. مشيت في حواري ودروب ببيوت قديمة وشرفاتٍ من الخشب، توقفت أمام فرشة جرائد، كانت الصفحات الرئيسية طافحة بأنباء عن انقلاب فاشل في تركيا. سألني البائع العجوز إذا ما كنت أحتاج شيئًا. قلت شكرًا.
تسكن عمتي في شقة صغيرة بإحدى العمائر القديمة المبنية على عجل في الثمانينات مع ابنها الوحيد محمد. ضربتُ الجرس ففتح لي في بيجامة مخططة. سلم عليَّ وقبلني. سألته عن عمتي، كانت نائمة. عرض أن يوقظها فرفضت وأخبرته أنني ربما أعود في وقت لاحق، سلم عليَّ وقبلني ثانيةً ثم أغلق الباب. فكرتُ في ماما شادية التي تسكن في الشقة المجاورة وتمهلتُ وأنا أسير أمام بابها مع يقين بأنّي لن أدق على الباب المترب.
وأنا أهبط بطيئًا فتح الباب من خلفي. ده انت يا علي؟ الصوت يحمل أثقالًا واليد مرتعشة تمسك بمقبض الباب من الداخل، كان صعبًا عليَّ كل مرة أن أحس أنني آخذ وقتًا كي أتعرف عليه. قلت وأنا ابتسم بابا محمود. فابتسم وتقدّم خطوة. أنا حسيت إن ده إنت، ادخل، قال وهو يحرك يده الحرة ناحية الداخل المعتم، وقفت حائرًا.
– علشان خاطري.
كان بابا محمود إسكندر، صديق أبي الوحيد، يسكن مع زوجته ماما شادية في الشقة المجاورة لشقة عمتي. سألته عليها فأجاب بأنها خرجت للتسوق. كان الراديو القديم يصدح بأغنية لفيروز، عديت الأسامي ومحيت الأسامي، بابا محمود قال لَمؤاخذة وأغلق الراديو، لم أخبره أنّي كنت في انتظار: أنا عندي حنين وما بعرف لمين.
أجلسني في الصالة على كرسى مريح وسألني أعمل لك شاي؟ كان مرتبكًا، أنا فاكر إنك مش بتحب الكركديه، ابتسمت وقلت ماشي شاي. كالنطقة ونهاية الجملة، كانت زيارة أبي لعمتي نوال تتبع دائمًا بزيارة لبابا محمود. كان الكبار يخبروننا أن نناديه هكذا، ربما ظنّوا أنها طريقة جيدة للتسرية عنه لأنه لم ينجب أطفالًا.
الشقة حميمية بشكل محبب، أثاثها بسيط وكأنها شقة من شقق الأرمن العجائز التي اعتدت أن أقرأ عنها في الكتب وأراها في الأفلام. في صغري، كانا يقدمان لي البسكويت المعمول في البيت، والكركديه الذي لا أحبه كان علامتهما المميزة؛ في كل البيوت التي دخلتها لم يكن الكركديه المشروب الأساسي للتقديم، كنت أغضب فتعرض ماما شادية عليَّ زجاجة كوكاكولا و لعب الدومينو، أتمنّعُ حبة – كما علمتني أمي – ثم أقبل مداريًا سروري، تاركًا الآباء إلى لعب الطاولة.
انقطعتُ عن رؤيتهما لفترة بعد أن قاطع أبي عمتي بسبب خلاف على الميراث، ثم بتعليمات من أمي أصبحت أزور عمتي سرًا مما عنى زيارة لبابا محمود. آكل البسكويت المعد بيتيًا وأتعلم لعب الطاولة وأتحدث عن علاماتي في المدرسة ومغامراتي الخاصة التي كانا بسعة صدر يصغيان إليها.
لو كنت بعرف أعمل قهوة حلوة كنت عملتلك. وصلني صوته المتعب من المطبخ. قلت مفيش مشكلة وأنا أتأمل لوحة صغيرة الحجم داخل برواز متواضع، كوخ من الخشب على ربوة خضراء وأطفال يلعبون في الخارج. كانوا يبيعونها بعشرة جنيهات في السوق. في غرفة معيشتنا رقدت واحدة وعلى الحائط في صالون عمتى نوال ترقد أخرى. جوار اللوحة بورتريه لأبيه إسكندر في شبابه، الرجل الذي نزح بعائلته من السويس إلى قريتنا في أواخر الستينات ومات وبابا محمود في المرحلة الإبتدائية.
يجب أن أعترف بأن لدي خوف من البورتريهات والصور الفوتوغرافية وكل ما يستطيع المرء دفس ولو ثانية من حياته فيه. ربما أبدو مبتذلًا لكن أليس هذا شكلًا لطيفًا من خيانة الحياة؟ لقد كان الوجه عريضًا ويشبه نسخة أكثر خشونة من سليمان نجيب مع شنب دقيق ونظرة تائهة.
على الحائط أيضًا، بعض البراويز الصغيرة والصور المصفرة بينه وبين ماما شادية، غالبًا بدون حجاب وترتدي فساتين تجعلني أتساءل لم وكيف اختفت من الشارع؟ بابا محمود بشعر كابتن شطة والقمصان مفتوحة الصدر والبنطال ذي الحجر الضيق. كل صورة نضحت بسعادة كائنيها، وبعثت في الوقت ذاته الكآبة في نفسى.
ممكن تستنى شادية لما ترجع وهي تعملك أحسن قهوة. قال وهو يضع صينية عليها كوبا الشاي وطبق صغير به بعض القراقيش الباقية من رمضان على طاولة خشبية أمامي. جلس قبالتي على كرسي مثل الكرسي الذي جلست عليه وأشعل بعود ثقاب سيجارة من علبة كيلوباترا ولم يعرض عليَّ واحدة وهو يعرف أنّي أدخن.
سألته على صورة الزفاف الكبيرة، قال حطيناها في أوضة النوم، كده أحسن. سألني على حال أمي وأختيّ وأخذ يتحدث قليلًا عن أبي وكيف أنه قبل الوفاة بوقت قصير كان قد قال لماما شادية أنه يفكر في زيارة محمد (قال لي الكلام نفسه في الدفنة) ثم سألني عن حاله قبل الوفاة فحكيت له. بان عليه التأثر، بلع ريقه ثم قال هو أبوك على طول كده، الله يرحمك يا محمد، كنت أنا وهو كده – وأطفأ سيجارته وأشار بسبابة يمناه ووسطاها ناحيتي – لولا اللي حصل وخلاه ياخد موقف من عمتك ولما وقفت جنبها زعل منّي أنا راخر- قال وهو يمسح عينيه – الله يرحمك يا محمد.
كعادته كان يشير إلى أبي دائمًا باسمه الذي يرقد في سجلات الحكومة، الاسم الذي لا يعرفه إلا الأقربون وحتى من يعرفه لا يستخدمه. كنت متأثرًا وقتها ولم أكن أريد الرحيل، طلبت منه أن نلعب عشرة طاولة، استغرق وهلة قبل أن يرحب بذلك.
نحى صينية الشاي جانبًا ووضع صندوق الطاولة. سألني محبوسة ولا واحد وتلاتين؟ قلت واحد وتلاتين، قال ماشي، بس خلي بالك.
بين اصطدام الزهر بداخل الصندوق ونقل القطع كان يتحدث عن قصص ومواقف متذكرًا أبي، ينسلخ من قصة ليدخل في أخرى، وهذه القصص كنت أعرفها ولكن الاستماع إليه وهو يحكيها بصيغته الخاصة وكونه كان طرفًا منها يجعلها حية: كيف انكسرت رجله قبل زواج أبي بأسبوع، والمقلب الذي نفذوه في فلاح جارهم اعتاد أن يقفز على السرير قبل نومه فما كان منهم إلا أن تسللوا إلي حجرته واستبدلوا مُلّات السرير بحطب هش، وذهابهم إلى المهزلة المقتبسة عن مسرحية ليوسف إدريس – هذه القصة عرفتها من أبي، ذلك أنه إثر انضمامي إلى فرقة المدرسة الإعدادية المسرحية قال أبي بأنه كان يحب المسرح في صغره ودلل بذهابهم إلى تلك المسرحية.
هناك قصة معينة كان يعود إليها، بإلقاء تلميح عليها أو ذكر تفصيلة جديدة. كان سعيدًا وهو يتحدث عن تلك القصة بالذات. في شتاء في أواخر السبعينيات، هو وأبي وزميلتان – لم يفصح عن شخصهما – كانوا عائدين من السينما (كانت تقع في أقصى أطراف القرية على مقربة من معسكر الجيش وصار محلها مخزن للأعلاف) عبر طريق الغارة (سمى بذلك لأنه استهدف في غارة للإسرائيلين) في آخر النهار ثم أمطرت السماء ثقيلًا وأصبح متعثرًا عليهم السير فالتجأوا إلى كوخ فلاح فارغ وقضوا فيه وقتًا طويلًا يتحدثون حتى انتهى المطر.
حين يتحدث بابا محمود عن أبي أحس أنه يتحدث عن شخص آخر ليس ذلك الذي عشت معه أكثر من عشرين سنة. شخص له حياة حافلة سابقة، لا ذاك الذي كان يعود من العمل ليشاهد التلفزيون ويتابع مباريات نادي الزمالك، لا يتحدث مع أحد وبين حين وآخر يلقي تعليقًا على الأخبار بكسل ويحثني على المذاكرة. من الصعب الجزم لكنّي أعتقد أنني كنت البادئ بالحديث دومًا مع أبي، أحيانا كنت أتعمد السكوت. إنه هناك، يجلس في غرفة المعيشة، ينظر إليّ ويرغب في الحديث ولا يتحدث. لم يكن هناك خيط أراه يربط أبي بمن كانه في الماضي. لو كان في الماضي كالرجل الذي عشت معه وعرفته لما اشتكيت، حقًا، كيف ينقطع إنسان فجأة عن كل شئ كانه؟
خسرت العشرة ولم أحرز ولو نقطة، عرض عليَّ أن نلعب عشرة أخرى، رفضت. ربما رأى في عينيّ شيئًا ما جعله يسأل مالك؟ قلت مفيش وأنا أتشاغل عنه بقفل صندوق الطاولة. نظرت في ساعتي وقلت هقوم أمشي أنا بقى. استنكر ذلك، هو أنا بشوفك كل فين وفين، ده انت كده هتزعل ماما شادية. قلت أنا أقدر؟ وكذبت أصلي تعبان علشان مانمتش من إمبارح. اصطحبني إلى الباب، ودعني قائلًا ماتقساش على نفسك يا علي.
عائدٌ إلى البيت، لم أمش في شارع السوق كي لا أقابل ماما شادية.
٩
أشرت سلفًا إلى ميلي إلى المشي جنب الحيط، لذلك قررت ألا أقرأ زقاق المدق في المكتبة. كنت أقرأ مقتطفات من هذا أو ذاك لكن ليس الرواية، الرواية تظل في الحقيبة، لا حاجة لمشهد مبتذل آخر.
في البيت وأنا في غرفتي كنت ألتهم صفحات الرواية، لم أكن مهتما بما قد يظنه أستاذ حسن شعبان فجورًا وفسوقًا من شخصيات في القصة؛ كنت أقرأ على فترات الملفات الساخنة في مجلة روز اليوسف وأشاهد في الخفاء أفلام سهير رمزي. أسرتني مسارات هؤلاء الأشخاص المثيرين للدهشة، ورغم صعوبة الأسلوب عليَّ وقتها إلاّ أن الأمر كان مسليًا. سرعان ما وجدت نفسي ضيفًا على عالم ممتع ينبض بالحياة، عالم، برغم وجود كاتب له، من خلقي.
أتساءل لماذا لم تكن قصة كزقاق المدق هي المقررة علينا في المدرسة. كنا نعرف – أتحدث عن من كانوا مثلي في العمر حينها – أماكن بيوت الدعارة في قريتنا ونشير إلى من تم إمساكهم في أوضاع مخلة، نراقب منحنيات المدرّسات المعينات حديثًا، الدكك في مؤخرة فصلنا كانت تنظم مسابقة للفتى صاحب أكبر عضو، وأحدهم بينما نسير سوية تجاه درس الرياضيات – طفل بأحد عشر عامًا لا يعرف عن النساء شيئًا – يخبرني بأن المرأة تحت عضو الرجل تصير مثل الكلبة.
في تلك السنة كان مقررًا علينا قصة عقبة بن نافع وكانت مملة ولم يكن يهمنا سوى الأسئلة من قبيل ما اسم أبو عقبة؟ ما اسم أم عقبة؟ حتى عندما كنّا نقرأ النص الموجود المدفوع إلينا من الوزارة لم يكن هناك سوى الملل. في تلك الفترة عاش داخلي عباس الحلو وسنية عفيفي وحميدة والمعلم كرشة وعم كامل وزيطة وسليم علوان بشكل ملون وحيوي أكثر مما عاش عقبة وأصحابه. كنت لا أتوقف عن القراءة إلا وأنا أفكر في متى سأعود إلى القراءة، لم أكن أعرف حينها شيئًا مما كان يمكن أن يقوله واحد مثل جابر عصفور، كنت فقط أشعر بالمتعة.
ذات يوم في وسط أسبوع زقاق المدق لم تفتح المكتبة – على غير المعتاد – وقت الطابور. قدرت أنه سيتم فتحها فيما بعد. في الدور الأول حيث فصلي أخذت حصة لغة إنجليزية طعمها كالخشب، وحصة رياضيات ظللت فيها منكمشًا حتى لا أسأل من المدرس الذي يمسح بالطلبة السبورة. كان الطلبة متحمسين لأنه في الحصة الخامسة، بعد الفسحة مباشرة، لدينا حصة ألعاب. توغل الأمل داخلهم ككل مرة بأنهم سيلعبون الكرة بدلًا من لم القمامة والجلوس بلا حراك. أحدهم أحضر جلد كرة به كرة بلاستيكية في حالة عدم قبول مدرس الألعاب (أو لم القمامة والجلوس بلا حراك) إخراج كرة المدرسة.
جاءت الفسحة وباب المكتبة لا يزال موصدًا. انزعجت، في حصة الألعاب كنت أنسل إلى المكتبة. عدت إلى الفصل وأخرجت شطيرة صنعتها لي أمي – غالبًا ما كانت تصنع لي لانشون أو جبنة بيضاء، فتحت الرواية في حجري وأنا حذر كي لا أبقع الكتاب، عين على باب قد يدخل منه المتنمرون وعين في الكتاب. قرأت بضع صفحات ثم قرع جرس انتهاء الفسحة وبداية الحصة الخامسة، وهي أطول الحصص في المدرسة، كأنهم كانوا يعاقبوننا على الفسحة. عاد الطلبة إلى الفصل وأخذوا حقائبهم إلى الحوش، المتنمرون لم يهتموا بي بل باللعب، حتى حاتم بقى ولم يهرب، هنلعب يا عم؟ إيه مش جاي؟ هتقرا؟ خلاص خليك. بعد ربع ساعة، نظرت من الشباك المطل على الحوش، كانوا يلمون القمامة.
بعد صفحة أو صفحتين دخل أستاذ غانم الفصل في حلة رياضية واسعة تحمل شعار مانشستر يونايتد وحذاء رياضي. كان قصيرًا وحركته سريعة وفمه صغير على نحو عجيب. ما يتداول عنه في المدرسة مخيف؛ يقولون كان مدرس رياضيات، اعتقل في أوائل الألفية من قبل أمن الدولة لسبب غير معلوم، حيث قاموا بضربه وتعذيبه (أحد الطلاب تطوع واصفًا أنهم كانوا يكهربونه في خصيتيه) ثم رموه أمام باب منزله حيث ظل يردد متتكاتروش عليا يا ولاد الكلب حتى استيقظ الجيران، أعصابه تلفت وصار كالمجاذيب لكنه ظل على طاقة المدرسة لا أعرف كيف، لم يكن يدرس أو له عمل إداري، يبقى في الدور الأخير، لابسًا الحلة الرياضية ويتأمل الحقول. في أوقات كان يتشاجر مع الهواء، يشوح بيديه بعنف وأحيانا يركل خصمًا متخيلا ويقول بصوته الرفيع كلمات غير مترابطة، وحين كانت تمر طائرة – أي طائرة – كان يلوح لها بعصبية. الطلبة اعتادوا مضايقته والسخرية منه. كل صباح كان يهرول بين الحقول في الطريق إلى المدرسة، والطلبة يهرولون جانبه ويقلدون صوت الطائرات.
كنت خائفًا منه، أن يغضب فجأة، أن يظنني الهواء ويتشاجر معي. كانت يداه خلف ظهره وعيناه تحدقان في السقف وهو يتجول بين التخت. لف وجاء من خلفي ثم جلس جانبى دون أن ينظر إليّ. راقبت يده وأنا موقن أنها ثوان وستهوي عليَّ. معاك سجاير؟ سأل بصوت طفل بخمس سنوات. إيه؟ وضع سبابته والوسطى على شفتيه سجاير، ها، معاك؟ قلت لأ. قال يا خسارة. لمحت الحسرة بادية على وجهه القمحي، يا خسارة. وقع نظره على الكتاب في حجرى. إيه ده؟ وريني كده. سحبه من حجري، تأمل غلافه محافظًا على صفاء وجهه وقلّبه ثم أعاده لحجري وقال بالحسرة نفسها على عدم وجود سجائر، يا خسارة، هيموت، هو في الاخر كمان هيموت.. وقام صوب الباب.
١٠
حين أعدت زقاق المدق إلى أستاذ إبراهيم كان لا يزال منزعجًا من حادثة كتب نجيب. كان يتابع تحركات الأستاذ حسن شعبان والقرف باد على وجهه وكنت أقول في نفسي إنها مسألة وقت قبل أن يقوم أستاذ إبراهيم ويفتعل صوتًا رخيمًا وهو ينظر في وجه غريمه قائلًا وجودك هنا غير مرحب به يا سيد، كما في الأفلام الأمريكية. كان عنده طابع حسن يظهر بشكل أفضل وهو عابس، وفي تلك الأيام كنت لأقول أني أصبحت طالبه المفضل، برغم أننا لم نكن نتحدث كثيرًا. أعرف ذلك لأني حين كنت أتغيب عن المكتبة كان يسألني عن سبب غيابي.
بدافع من الفضول وأنا أعطيه الكتاب سألته عن أستاذ غانم. تعرفه؟ قال أعرفه ثم أردف وعيناه تتابعان غريمه، في الحقيقة ده المدرس الوحيد إللي كان بيجى هنا علشان يقرأ، بتسأل ليه؟
أصله قاللي إن عباس هيموت.
عباس مين؟ استحوذت على اهتمامه.
عباس الحلو.
ضحك، هيّ الرواية عجبتك للدرجة دي؟
أيوه، وتكلمت عن الرواية.
كنت عازمًا على طلب رواية أخرى تشبه زقاق المدق لكنّي فضلت أن أنتظر قليلًا حتى لا أبدو ثقيلًا كقفل. كان الكلام يأخذنا بعيدًا عن أستاذ غانم فسألته مجددًا عنه فلم يزد عن أنه كان هادئًا ولطيفًا، يأتي إلى المكتبة كل يوم ليقرأ حتى حدث ما حدث. ما حدث؟ ماعرفش. طلبت منه أن أرى تلك الدفاتر، من جهة كنت أرغب في رؤية ما كان يقرأه أستاذ غانم، ومن جهة أخرى أتسلى. كان يمكنه أن يقول لا، لكنه قام يرسم حركاته وأحضر دفترًا مماثلًا للدفتر الذي على مكتبه، والفارق أنه يعود لسبعة أعوام مضت، وضعه أمامي وفتح صفحة عشوائية وأشار إلى منطقة معينة، شايف، غانم محمد سلامة، تسعة مارس سنة ألفين، عودة الروح، أربعتاشر مارس نفس السنة، ديوان أبو نواس، صدّقت يا سيدي؟ أخبرته أنّي كنت أصدقه منذ البداية، قال ماشي وناولني الدفتر.
نادرًا ما كان اسم الأستاذ غانم غير موجود في صفحة، كان قارئًا سريعًا لا يمكث الكتاب في خانته أكثر من بضعة أيام. آخر مرة كُتب فيها اسمه كان في نهاية إبريل. أرجعت الدفتر وشكرت الأستاذ إبراهيم ثم جلست أفكر في الأستاذ غانم وآسف عليه. تخيلتني أتتبع ما قرأه الرجل، كتاب بكتاب، ثم وأنا أقرأ الكتاب الأخير يحدث لي ما حدث له. فكرت أن هذه قصة قد تصنع فيلمًا جيدًا وقررت في غمرة النشوة أن أقوم فعلًا بتتبع قراءاته، ولأني كسول ولدي من الإصرار القليل، فضلت أن أبدأ بآخر كتاب قرأه، التحول لفرانز كافكا.
بحثت عن الكتاب في قسم الأدب ولم أجده. سألت الأستاذ ابراهيم عنه فأخبرني أن أحدهم ربما وضعه في قسم آخر بالخطأ. بعد تعب وجدت الكتاب في قسم الديانات، بين قصص الأنبياء لابن كثير وخشب وحدة الكتب. كان الغلاف كئيبًا وبه خنفساء عملاقة تحمل رأس إنسان وممددة على سرير معدني عارِ وفي الخلف تعريف موجز بكافكا – والإشارة الدائمة إلى يهوديته – وبالمترجم رابح حسيني (ذكر أنه مواليد بنها ١٩٣٦ وله عدد من الأعمال المترجمة ومجموعة قصصية وحيدة بعنوان أشياء فكرت فيها عندما رأيت القنبلة اليدوية تسقط أمامي وأنا حبيس الدبابة) وفي الداخل كان تاريخ الطبعة الأولى يشير إلى أغسطس ١٩٧٨.

١١
مات أبي على سريره منذ عشرة أيام، وكنت أنا على سريري أفكر في العودة إلى القاهرة. كنت قد اعتدت بعد اختباراتي النهائية أن أعود إلى قريتي لأقضي رمضان والعيد وأيام قليلة ومن ثم أرتد إلى القاهرة. لم تحب أمي ذلك ولا القاهرة؛ كانت تظن أنها المرأة التي أغوتني وأخذتني منها. كثيرًا ما رجتني أن أبقى، لكن كيف أبقى وكل شيء حولي هنا مجاز عن العجز؟ بيد أن القاهرة لا تختلف، لكن هناك دائمًا إمكانية الضياع فيها.
قرأت مرة أن موت الإنسان يشبهه، قالها أحدهم عن موت تشيكوف. آمنت بهذه الجملة بشكل ما، هكذا صار موت أبي يشبهه. كان جالسًا في الحديقة ذاك المساء، وأمي الممجدة للقيم الأسرية، والتي ربيت على الطريقة القديمة (محاولات غير متعمدة لتحطيم فرديتنا) طلبت مني عندما كنت في غرفتي أقرأ من القصائد المختارة للوركا أن أحضر كرسيًا لأجلس معهم في الحديقة. كدت أرفض، لكن شعرت بالذنب ووخزني ضميري حين فكرت في أنّي لم أمض مع أبي وقتًا يذكر في الصيف.
كان يرتدى بيچامة وينظر ناحية البوابة الحديدية، جلست قبالته ولم نتحدث. قشرت برتقالة وعرضتها عليه فقال لا. سرعان ما جاءت أختاي وأمي وفاضوا علينا بأحاديثهن عن زيجات وخطوبات واختبارات الثانوية ونتائج الجامعة. عبرت أختاي عن رغبتهما في الذهاب إلى دهب، رد أبي أنه سيفكر في الأمر.
كان مساءًا هادئًا وعاديًا حتى نبح كلب في الجوار نباحًا طال وأزعجنا. وما بدت أنها ابتسامة صغيرة على وجه أبي تحولت إلى ضحكات هيستيرية. قالت أمي بتضحك ليه يا يحيى؟ لم يرد. ارتديت لباسًا من الدهشة وقليلا من الخوف. ضحّكنا معاك يا يحيى؟ طيب، قال، يجي من شهر، أستاذ عزّام في الشئون قال لي بدون مناسبة إن الكلب ملوش رئة، قالي ده إعجاز علمي لإن القرآن قال إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قلت له يا عزام إيه الكلام الفارغ ده – وسقط في نوبة ضحك أخرى – قال لي سمعتها من شيخ، يهديك يرضيك، الكلب ملوش رئة. قلت له نسأل فيها طيب، اتصل بدكتور بيطري قريبه باين، كنت شايف وشه وهو بيتحول، وفكرت في إللي على الطرف التاني وبيفكر في المجنون إللي بيتصل بيه وبيسأله هو الكلب له رئة ولا لأ.
لم أكن معتادًا على أبي هكذا، أصابني – بدلا من الانغماس في الضحك كأمي وأختيّ – جزع. أكمل أبي، عزام قفل الخط من هنا وقعد يعيط، صعب عليا، أخدت أراضيه وأقوله إن كلنا بنغلط، كلنا بنغلط، فرقت إيه يا عزّام ما كلب يلهث، ما كلنا بنلهث.
سألته مالك يا بابا؟
مليش، قالها كطفل يعتذر عن كسر مزهرية. على الرغم من وجهه الضاحك، كانت عيناه ذابلتين كزهور في غرفة مظلمة توقف أحدهم عن الاعتناء بها، النظرة في عينيه ذكرتني بتلك الليلة البعيدة التي رحلت فيها أمي لأقل من يوم.
أكملنا أكل البرتقال والتين البرشومي، أكثر فاكهة كان يحبها والدي، وتحدثت أختي الصغرى عن مخاوفها من الثانوية العامة السنة القادمة. مكث معنا ساعة أو أكثر ثم قام لينام. وجدته أمي ميتًا بعد الواحدة صباحًا، بعدما فزعت في نومها. قالت لنا أنها قبل استيقاظها كانت تبحث عنه في حلم طويل.
١٢
قبل ضياع الكتاب كنت قد وصلت إلى توغل التفاحة في ظهر جريجور. أحببت الفصلين الأول والثاني، برغم عدم فهمي لبعض الأشياء وصعوبة لغة الترجمة. كان جريجور جالسًا على كرسيه ذي المسندين في هيئته الجديدة يحدق في ليل المدينة سابحًا في محيط لانهائي من الزمن – ما يزال جريجور جالسًا هناك بينما نتحدث – هكذا أتذكر جريجور حتى الآن.
لكن كيف أتذكر أبى اليوم؟ أسأل نفسي، ما الذي تبقى من الرجل الذي أحبَّ محمد عبدالوهاب وحضر في صغره عرضًا لمسرحية ليوسف إدريس، الرجل الذي بكى ليلة اجتياح بغداد، والذي ضحك ليلة موته على زميله الذي قال إن الكلب لا رئة له؟ كنت حانقًا عليه قبل موته، رأيته عاجزًا ومستسلمًا، وحيدًا بمدار خاص من العزلة وكلمات مرهقة قليلة، دون صراخ أو رغبة للنهوض. ربما أشد ما يؤلم الابن أن يرى عجز أبيه، وقد كنت ألمس عجزه في كل نظرة من عينيه اللوزيتين، والآن هو ميت، ولا أعرف الكثير مما يستحق أن أحكيه عنه. الحنق تبدد، وأنا لا أتذكر غير تلك النظرة.
١٣
ذلك الأحد، حيث كان عليَّ أن أعيد التحول للمكتبة، جثم على الأرض ضباب كثيف في الصباح. رقدت حقول خضراء عن يميني وفي الجانب الآخر نامت ترعة فصلت بيني وبين الطريق السريع حيث سيارات الأجرة والنقل تأكل الأسفلت. أمامي امتد الأبيض.
بعد دقائق من السير وحيدًا انضم إليَّ خارجًا من الضباب زميلي في الفصل حامد، والمعروف أيضًا بالفار. نحيل ويفوقني طولًا. كان ذهني مشغولًا بأمر الكتاب الضائع، أجيب على أسئلة الفار بنصف انتباه، حتى صدمتني دراجة نارية في فخذي وأسفل ظهري. سقطت على الأرض، ولسوء حظي، أمام بيت عجوز يحتفظ بأكثر من أربعة كلاب.
ابتلع الضباب الدراجة النارية واهتاجت الكلاب التي كانت نائمة أمام الدار. صرخت. حامد، وكما يليق بفأر، اختفى، فجأة صار الطريق خاليًا وصرت وحدي تطوقني الكلاب ويسيل لعابها على بنطالي الكحلي. صارعتُ الهواء لأبعدها عني، قدماي ممدودتان أمامي وعاجزتان عن الوقوف – ليس من الألم بل الأخذ بغتة – والكلاب تلهث وتقترب وتنبح في وجهي حتى لا يبقى بينها وبيني شئ، ثم تبتعد وتعاود الكرة. بقيت على تلك الحالة حتى خرج العجوز بالصديري المتسخ والوجه اليابس، أعاد كلابه إلى الدار ثم رجع فحملني لخطوات وتركني جوار عمود إنارة.
حين وصلت إلى المدرسة كان الطابور قد انتهى و بدأت أحس بألم في فخذى الأيمن وبوخزٍ خفيف أسفل ظهري. في الفصل، لم يكن المدرس قد جاء بعد. الفار يجلس هادئًا في الصف الأول وأنا عزمت ألا أسلك ذلك الطريق مرة أخرى، بقية دراستي في الإعدادية صرتُ أسير إلى المدرسة بجانب سيارات الأجرة وعربات النقل على الطريق السريع.
انحسر ألم فخذي بمرور الوقت بحيث شغلني أكثر اتساخ البنطال والقميص؛ كان الجميع يحدّقون فيَّ. أما بخصوص الكتاب الضائع، فقد قررت في البداية ألا أنزل إلى المكتبة، لكن ماذا عن الغد؟ ثم فكرت في الكذب وادعاء نسيان الكتاب في المنزل أو اتهام تلاميذ فصلي بسرقته في أثناء حصة الألعاب. هنا قابلتني حقيقة أنّي لست خائفًا من عقاب أو دفع ثمن الكتاب، بل من أن يغضب أستاذ إبراهيم ويخيب ظنه فيَّ، هذا ما جعلني أتوجه إلى المكتبة بعد رنين جرس الفسحة. أستاذ إبراهيم كان جالسًا يقرأ كتابًا لمحمد عودة، أبلة نادية تتبادل الهمس مع أبلة محروسة (أتت من المدينة خصيصًا لتخبرنا قد إيه إحنا فلاحين بنقضي الوقت ورا الجاموسة) وأستاذ عاطف بيشوي يأكل وحيدًا بعيدًا عنهم جميعًا.
وقفت أمام أستاذ إبراهيم وقلت بصوت جاهدت أن يظهر في نبرته بعض الندم، أنا آسف.
بؤبؤا عينيه تدحرجا من كتابه واستقرا عليَّ، على إيه؟
على الكتاب، كتاب التحول..
ماله؟ انت كتبت فيه حاجة؟
أنا؟ لأ خالص.
ما أنا عارف، أنا فحصته ولقيته سليم.
فحصته؟
أيوه.
فحصته إزاي؟
يعني إيه فحصته إزاي؟ كان عاديًا مرتاحًا في حديثه لا يظهر شيئا، لا أود قول أنه لم يكن مهتمًا أو أنه كان يستخف بي.
لم أرد، بلعت ريقي ودهشتي وسألته هو فين طيب؟
مال لبسك متبهدل ليه كده؟
وقعت في الطريق وأنا جاي المدرسة.
تعبان ولا حاجة، تروح؟
لأ، أنا كويس. هو فين؟
هو إيه؟
التحول.
اااه، هتلاقيه في مكانه.
وانشغل عني يقرأ في كتابه.
ذهبت إلى قسم الأدب، لم أجده. ذهب ظني بالرجل إلى المظلم والبعيد. ناديته وقلت التحول مش هنا. ابتسم وأنا فهمت مغزى ابتسامته. انتقلت إلى قسم الديانات فوجدت الكتاب نفسه بين قصص الأنبياء لابن كثير والخشب.
حكيت ما حدث لقلة من أصدقائي، خاصة بعد الاختفاء الغريب لأستاذ إبراهيم، وشكّوا في مصداقيتي في الحكي، كأني أخفي خيطًا لا أريدهم أن يروه. طالما اعتقدتُ أن الأستاذ إبراهيم يعرف كل شئ، سألته في اليوم نفسه مرة ثانية عن الكتاب، وهل وجده في المكتبة قال وهو يظهر الدهشة بأنني أحضرته يوم الخميس، بل أخبرته أنني أجد صعوبة في فهم كيف تغيرت مشاعر أخت جريجور. نفيت حدوث ذلك، أنا ماعرفش إن مشاعر أخت جريجور هتتغير أصلًا. وهو أصر على أنني أعطيته الكتاب وأبلة شوقية تشهد على ذلك. فين أبلة شوقية طيب؟ غايبة؟ أخبرته بأنني أتذكر جيدًا أن الكتاب كان معي بالمنزل، قال انت لازم نسيت أو الأيام اختلطت عليك.
كتابٌ فقدته في المنزل – عدت مخصوص لأجله من شبه خروج – ثم وبطريقة ما أجده على رف بالمكتبة، رجل كبير يؤكد حدوث حدث يتضمنني رغم أنه يوجد في رأسي ذكرى عن ذلك، فصلٌ من كتاب يفترض أنّي قرأته بل وناقشته فيه، ولا أتذكر منه لمحة، وعائلتي لا تتذكر رؤية أي كتاب على غلافه خنفساء نائمة على سرير، فيما بعد، ستقول أمي أن الكتاب ما هو إلا كذبة اختلقتها كي أعود وأمكث مع أبي. بالطبع كان عليهم أن يعتقدوا أنني أخفي خيطًا.
ضربتُ أخماسًا في أسداس. تحت عين أستاذ إبراهيم قلبت في الكتاب علني أجد أي شئ مختلف. لا شئ مختلف، قررت توخي الحذر في التعامل مع أستاذ إبراهيم وتفادي الحديث معه بقية اليوم. لاحقًا في السرير، جعلت أستعرض تفسيرات لما حدث، لكنها جميعًا كانت تصطدم بي وبسخطي أو تذهب بعيدًا حيث لا أريد لها. كان يكذب، عرفت ذلك، آأذهب وأقول له كفاية كذب؟ لكن كيف والكتاب هناك في الرف؟ ثم كيف ستتغير مشاعر أخت جريجور نحوه؟ كيف؟ أخذت أفكر في ذلك حتى نمت.
حين استيقظت شعرت بأسفل ظهري يجأر من الألم، بدا كأنه يتفسخ كلما تحركت. أبي ظن أنني أتمارض كي لا أذهب إلى المدرسة، كان معتادًا على ذلك، أخبرتهم بالقصة، فحصتني أمي فوجدت كدمات داكنة الزرقة أسفل ظهري. حاولت علاجها بما تعرفه عن الصيدلة، دهنتها بمرهم ما وأعطتني مسكنات ونصحتي بالبقاء ساكنًا وعدم الحراك. لو الألم استمر هنشوف دكتور.كان أبي يرغب بالذهاب إلى العجوز صاحب الكلاب، منعته أمي.
لم تذهب الكدمات ولم يذهب الألم، كنت أنام وأحلم كثيرًا، بأشياء غير مترابطة ومخيفة، امرأة بلا وجه وعارضة حديدية في موضع عينها اليسرى وهياكل عظمية لكلاب تتحرك حولها. سهرت أمي علي راحتي وكان أبي يطمئن عليَّ بوجه ذابل جاهدًا لينفي عنه القلق. أختاي كانتا تجلسان معي طويلًا، تتحدثان عن الدراسة وأفلامهما المفضلة. سألتهما عن يوم ذهبت أمي لخالي، قالت ورد: لما رحنا هناك طلبت ماما مننا إننا ننام في أوضة الضيوف وقعدت تتكلم هي وخالي، كنا بنسمع صوت عياطها. فكرت في غرابة الألم، مساء الليلة الماضية لم أكن أشعر سوى بشكّات أسفل ظهري وأطلال ألم في فخذي الأيمن.
أحسست بتحسن صباح الأربعاء، أصبحت قادرًا على الحركة بشكل مقبول والألم أخذ في الانحسار حتى أتى المساء وأنا بالكاد أشعر به، على الرغم من ذلك، ظلت الكدمات كما هي.
يوم الخميس وبناءً على رغبة أبي ذهبت إلى المدرسة، كنت أسير ببطء على الأسفلت السريع. لم أنزل إلى المكتبة إلا في الفسحة، تفاديت الكلام والنظر إلى أستاذ إبراهيم، سألني غبت ليه الفترة الطويلة دي؟ بفضول بدا غريبًا عليه، كأنه أراد أن يستمع إلى قصة ما، قلت له كنت تعبان بس.
لم تكن أبلة شوقية حاضرة، قالوا إنه أوان ولادتها.
١٤
بعد عودتي من إجازة نصف العام استكملت قراءاتي – بدأت في قراءة أعمال توفيق الحكيم الموجودة في المكتبة – محتفظًا بريبتي من أستاذ إبراهيم، والتي أسمنتها طريقته الودودة، الغريبة والمستحدثة.
في قريتنا لم يكن لدينا مكان لبيع الكتب، فرشة الصحف التي وقفتُ أمامها البارحة وقلت شكرًا كانت الوحيدة من نوعها وافتقرت إلى الكثير بطبيعة الحال. في الإجازة كان معي القليل من المال مما تبقى من العيدية ومكافأة النجاح فقررت أن أشتري به كتابًا. سألت صاحب الفرشة إذا كان لديه أو يعرف مكانًا في القرية يبيع الكتب، سألني كتب دراسة؟ أوضحت له نوعية الكتب فقال لأ، الحاجات دي مش هتلاقيها هنا، دي تلاقيها في بنها ولم أكن حتى ذلك الوقت قد ذهبت إلى المدينة وحدي أبدًا.
كان أبي يعمل في المعهد العالي للتكنولوجيا – سيتحول الاسم فيما بعد إلى كلية الهندسة ببنها – وكان ينزل المدينة تقريبًا كل يوم. سألته أن يشتري لي رواية، أي رواية، قال حاضر، ولمدة اسبوع كنت أنتظر عودته كل يوم ولا أجد سوى خيبة الأمل. ألححت عليه حتى انفجر فيّ ذات مرة مما دفعني، كرد فعل بسيط على الانفجار، إلى التفكير في الذهاب بنفسي ودون أن أخبره أو أمي.
تملكتني الفكرة وتحركت سريعًا، في يوم سبت وبعد كذبة متقنة عن دروس خصوصية متتالية لا وجود لها، قصدت موقف سيارات قريتنا أتلفت حولي. ركبت عربة أجرة من مخلفات الحرب وبقيت أقرأ آية الكرسى طول الطريق وألوم نفسي لأني انحرفت عن الحيط. معتمدًا على هشاشة زياراتي السابقة مع أبي وأسئلتي للمارّة، انتهيت إلى مكتبة الأهرام. كان ذلك هو المكان الوحيد في المدينة الذي أردت الوصول إليه، رغم عدم معرفتي به قبل أن أصل، مذيلًا بالخوف من أن يراني أحد يعرفني أو أن أضل هناك.
لما دخلت سألت على رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، قال الموظف السمين وهو يصب عليَّ نظراته المتفحصة: مش موجودة. أخذت أتجول بين رفوف الكتب بينما الموظف السمين يتابعني بضجر، اخترت نسخة من سارة للعقاد – حين قرأتها لم تعجبني على الإطلاق، أخفيت الكتاب في ملابسي حين وصلت البيت ودخلت مباشرة إلى حجرتي.
بعد بضعة أيام من انتصاري الصغير، وأثناء مشاهدتي للتلفزيون آخر النهار ومحاولتي أن أراجع درسًا من مادة اللغة العربية للمدرس الخصوصي، عاد أبي من العمل، حاملًا كيسًا أسودًا، بداخله نسخة مستعملة من محاكمة كافكا.

١٥
في إحدى حصص اللغة العربية لمدرّسة جديدة بالأجر (كنا، كالمدرسة، لا نكن لهؤلاء احترامًا) تحرش بي أحد المتنمرين لفظيًا فقلت له بصوت عالٍ يابن الشرموطة. سمعت المدرّسة ذلك فسحبت شهقة تصورت أنها ستموت بعدها وأخذتني إلى الأخصائي الاجتماعي الذي كان في المكتبة يتناول إفطاره. عنفني الرجل بصورة مصطنعة، كان يزعق فيَّ ثم يتابع أثر ذلك على وجه المدرسة. أحضر ورقة من غرفة مجاورة وشرع في كتابة استدعاء لولي أمري. عادت المدرّسة إلى حصتها.
كان الأستاذ إبراهيم يتابعنا من الأول، أرسلت له نظرة استغاثة. تصنَّع الانشغال في أوراق أمامه، أرسلت نظرة ثانية أطول فقام وانتحى بالأخصائي.
عاد الأخصائي ومزّق ورقة الاستدعاء وقال لولا الاستاذ إبراهيم كنت بعت الجواب لأهلك، متتكررش تاني، اطلع على حصتك يلّا. خرجت أتسكع في الطرقات.
في الفسحة، لم أقدر على استيعاب سطر واحد مما كنت أقرأ. في النهاية قمت وجلست أمامه وأوضحت له ما حدث ثم قلت ده حتى الكلمة اللي قالوا عليّا فيها قليل الأدب قريتها في عودة الروح أكتر من مرة. ضحك الأستاذ إبراهيم وظهرت أسنانه الصفراء.
عدنا، شيئًا فشيئًا، كما كنّا قبل التحوّل. أمدني بنصائح حول القراءة – نصحني باستخدام القلم الرصاص – وبكتب لنجيب محفوظ ناقشني فيها بعد إرجاعها. في كل مرة كنت أطلب منه أولاد حارتنا وكان يأتيني بكتاب آخر، مرة بداية ونهاية (أفضل كتاب قرأته له) ومرة ميرامار. معظم الأحيان كنا نتحدث عن الكتب، وفي أحايين قليلة كنا ننزلق إلى أرض غريبة. كان يقتبس كثيرًا جملة كتبها محفوظ في اللص والكلاب: من غاب عن الأشياء غابت الأشياء عنه، ومرة قال لي: عارف إحنا ليه بندفن الناس إللي بيموتوا بعيد عنّا؟ هزيت كتفي وفي رأسي كنت أفكر في رائحتهم. قال إحنا بندفن الناس إللي بيموتوا بعيد عنّا لإننا بنبقي فاكرين إننا بعد ما عملنا كده في أجسامهم ممكن نسامح نفسنا لو نسيناهم. تخلق هذه الجملة داخلي صخبًا في الأيام الأخيرة، لكنّي للحق لم أفهم منها شيئًا وقتها.
وفي يوم دخلت عليه فوجدته يبتسم في وجهي ويخبرني أنه رشحني لأستاذ المسرح للانضمام إلى فرقة التمثيل المسرحي في المدرسة الإعدادية. حظيت بوقت ممتع بانضمامي لتلك الفرقة: ينسخ الأستاذ نصًا مسرحيًا تعبانًا لأي موضوع معاصر من الإنترنت ونتدرب عليه على سطح المدرسة، حيث يمكن أيضًا رؤية أستاذ غانم وهو يصارع الهواء. صرت أخرج وأدخل إلى المدرسة حسب مزاجي وأعود إلى المنزل مبكرًا، والأفضل من ذلك، كنا نعرض مسرحياتنا السيئة في مدارس الفتيات في قريتنا والقرى المجاورة.
في الصف الثالث الإعدادي، كنت في مسرحية عن أنفلونزا الخنازير، راويًا عجوزًا وضعوا كمية لا بأس بها من الدقيق على رأسه يوم العرض وجعلوه يتحدث عن أيام زمان التي لم تكن فيها أمراض. في واحدة من البروفات فوجئت بالأستاذ إبراهيم يقاطعنا ويقول لي: بعد ما تخلص عايزك في المكتبة. نزلت إليه، بادرني انت عارف مكان بيتي؟ حركت رأسي نافيًا فرفع حاجبًا بجد؟ طب أنا هشرحلك المكان وهطلب منك تروح هناك تجيب لي طلب، طيب؟
شرح لي كيف أصل إلى بيته. ما أراده كان ملفًا، أزرقًا وبلاستيكيًا، على مكتبه، قال لي تيجي بسرعة وهو يشير لبواب المدرسة ليدعني أخرج. لم أكن محتاجًا لتلك الإشارة.
سرت على الطريق السريع، الأسفلت ملون بالتوت الساقط من الأشجار، الترعة فارغة، وبعض الناس يصطادون السمك عن طريق كهربة الماء الراكد القليل، على طول شاطئ الترعة كان يوجد من يفعل ذلك. اتبعت تعليمات الوصول حرفًا بحرف حتى وجدت منزله، كان محاطًا بسياجٍ طويل من نبات ورقي وله بوابة خشبية لونها أخضر فاتح. استقبلتني رائحة الفل المنبعثة من شجيرات مزروعة بجانب البوابة، قطفت ثلاثة أزهار، لي ولأختيّ.
ضربت الجرس المثبت بإحكام في عارضة خشبية ولم يجب أحد. عاودت الكرة ثم خبطت بيدي على البوابة قبل أن ألاحظ أنها لم تكن مغلقة تمامًا. دخلت، سرت في ممر ترابي: على يساري غرفة بيد أنها مهجورة وتكعيبة خشبية وعلى يميني سلم وأشجار البرتقال. صعدت السلم ذا الدرجات الرخامية حتى وصلت إلى فراندا مبلطة تطل على جنينة البرتقال، بها طاولة وكراسي وفي ركن من أركانها باب خشبي جواره جرس متهالك ومثبت بالكاد في الحائط، ضربته أيضًا، لم يجب أحد.
احترت، آأرجع إلى الأستاذ إبراهيم أخبره أنّي لم أجد بالمنزل أحدًا أم أنتظر؟ ركنت إلى الانتظار. البوابة لم تكن مغلقة، أيًا كان من خرج فإنه سيعود سريعًا. جلست على درجة في وسط السلم ملاحقًا بعيني العصافير وهي تتقافز على تكعيبة العنب.
بعد أقل من ربع ساعة، سمعت صوت انفتاح البوابة. وقفت أمامي امرأة، شعرها طويل بني فاتح ومنسدل في خفة، تضع نظارة شمس كبيرة ولم تحمل في يديها شيئًا، كانت زوجته. ترتدي تنورة زرقاء داكنة وبلوزة كريمية اللون، لم تكن كنساء قريتنا لكنها في الحال ذكرتني بأمي. كانت تشبهها بشكل ملحوظ، تحديدًا في جبينها، أنفها المعقوفة وعنقها الطويل.
بادرتني، كأنها تعرفني، بتعمل إيه هنا؟ كانت تسير واثقة في كعبها العالي، تخطتني صاعدة وأنا أوضح لها سبب وجودي. وقفت حائرًا حتى طلبت مني الصعود والجلوس في الفراندا ريثما تحضر الملف.
وضعت الملف الأزرق البلاستيكي على الطاولة حين عادت. لم أستطع تخطي الشبه بينها وبين أمي، سألتني بتبص لي كده ليه؟ قلت أصلك تشبهي حد أعرفه. بيد أنها أخذت بقولي لكنها سرعان ما قالت انت كمان تشبه حد أعرفه.
شعرتُ بالحرج فأخذت الملف وقمت. اصطحبتني إلى الخارج وعند البوّابة قالت: ممكن أطلب منك طلب؟ أومأت. ممكن لو سألك تقوله إني كنت في البيت؟ لا أعرف لماذا أومأت بشدة وأنا أنظر في عينيها الواسعتين وأقول حاضر حاضر. مشيت خطوتين قبل أن أسمع صوتها مجددًا، التفت فوجدتها خلفي تمامًا، خد دي، مدّت لي يدها وبها زهرة فل.
بعدما تسلم الأستاذ ابراهيم مني الملف الأزرق البلاستيكي سألني مضيقًا عينيه: هي مكانتش في البيت ولا إيه؟
قلت كانت في البيت، أنا إللي أتأخرت وأنا رايح، كنت بتفرج على الناس وهما بيصطادوا السمك بالكهربا.
حين عدت إلى المنزل، أعطيت أمي زهرة الفل الرابعة.
١٦
وجدتني أمام منزل الأستاذ إبراهيم، بدا ذلك طبيعيًا.
السياج حالته سيئة لكن شجيرات الفل كانت كما هي. انتزعت ثلاثة أزهار واسترقت نظرة من الداخل، وكالشخصية الرئيسية في قصة تتحدث عن العودة، تملكتني رغبة في الدخول.
حافظت على علاقة طيبة مع الأستاذ إبراهيم بعد رحيلي عن المدرسة وزرته في المكتبة بضع مرات – آخر مرة تحدث قليلًا عن روايات هيمنجواي وكثيرًا عن هيمنجواي نفسه – ثم جاءت الثورة واختفى، يقولون أن زوجته لا يزال يحدوها أمل ولا تدخر وسعًا في السفر الدائم بحثًا عنه.
منزلنا كان هادئًا. ياسمين فقط مستيقظة تراسل أحدًا على الموبايل. قالت: قابلت عمتك؟
لأ.
أمال كنت فين ده كله؟
مفيش، بتمشّى، خدي دول.
أمسكتْ بزهرات الفل.
ماما نامت؟
لسه من شوية، سبناها فترة في المطبخ ورجعنا لقيناها جنب أنبوبة الغاز إللي فضيت بتعيط، قالت أنا عمري ما ربطتها، أبوكم هو إللي كان بيربطها.
طيب. لبرهة وقفت هناك قبل أن أقترح عليها أن نخرج كلنا في المساء إلى أضواء بنها الصفراء بدلًا من الخنقة في المنزل. هزّت رأسها وقالت أصلا ماما مش هتوافق.
كنت محملًا بمواكب حزن وغيوم أفكار سيئة عندما تمددت على السرير. تذكرت أبي ونحن نشاهد المسرحيات، كيف كنت – حين يضج الجمهور بالضحك على إفيه ما – أنظر إلى وجهه لأرى إذا كان يضحك. دفنت رأسي تحت الوسادة وقرأت آية الكرسي وطلبت الرحمة.
كنت متعبًا لكنّي لم أستطع النوم. قمت وقرأت علي ضوء مصباح النيون من القصائد المختارة للوركا، تفحصت حسابي على تويتر ثم اندمجت في أحد أكثر الأفعال انغماسًا وتوغلًا في العزلة: الاستمناء. وقعت في النوم وحلمت بنفسي أسير في محيط من الأسود حيث لم يعد للوقت قيمة، شاعرًا بوخز أسفل ظهري. كانت هناك نقطة بيضاء شاحبة، كشمعة تحترق وُضعت على بعد أميال، مهما تتابعت خطواتي لم تكن هناك أي إشارة على اقترابي ولو بوصة واحدة. مشيت ومشيت حتى سمعت صوت حركة ما، كقلم يتحرك على ورقة بسرعة في الظلام. أرهفت السمع ثم انحرفت بعيدًا عن النقطة البيضاء الشاحبة. كنت ألهث بالكيفية نفسها إذا أسرعت أو أبطأت أو حتى توقفت وسرعان ما وجدت على الجانبين كراسٍ خشبية فارغة موضوعة أمام نوافذ مفتوحة على المحيط الأسود. جلست على أحدها ونظرت إلى النافذة أمامي، رأيت أمي واقفة، كانت تنظر بعيدًا يبدو عليها الحزن وسيماء الانتظار.
استيقظت غارقًا في العرق والليل حاضر. قمت ودونت الحلم في ورقة بيضاء. وبينما كنت أغتسل فكرت في الذي حلمت به ورسوت في مرافئ مهجورة، حرضت نفسي وأنا هناك على البكاء، ولم أستطع. تفحصت أسفل ظهري ولم أجد شيئًا. جففت شعري ورجعت إلى حجرتي، كنت فارغًا. قرأت ما دونته وأنا ممدد على السرير واسترجعت مقابلة بابا محمود والليلة الماطرة في كوخ الفلاح الفارغ، حيث اختبأ أربعة وخرجوا ليكتشفوا ألا أحد بقيَ في العالم.
كنت عاجزًا عن استحضار ملامح أبي. كان بإمكاني سماعه يتحدث عن الفيلم الذي شاهدوه في السينما القديمة، لكن وجهه، لم أكن قادرًا على استحضار وجهه، أغلقت عينيّ بشدة وعصرت حياتي لكن ملمحًا لم يخرج.
هرعت إلى كل صور أبي في المنزل، لم يكن وجهه هناك، كأن أحدهم قد نسي أن يضيف الملامح إلى ذلك الفراغ من اللون البشري. أمي كانت جالسة في الصالة وسألتني مالك؟ قلت مفيش وذهبت إلى غرفة أبي، كانت المروحة شغالة وتصدر صوت طقطقة.
بجانب السرير كومود به صندوق معدني مستطيل، وداخله صور زفاف والديَّ وطفولة أمي وصور لي وأختّي في صغرنا في الأسكندرية وأسوان، هناك صور لها قصص وهناك صور تذكرني بقصص، وكلها أخذت بواسطة كاميرا أبي التي فُقدت في رحلة إلى مرسى مطروح.
حرضت نفسي مرة ثانية على البكاء. بفضل بعض المشاهد المخزنة التي أرجع إليها لأبكي – سعادة أمي الناضحة جوار الخالي من الملامح في صورة أخذت في زفافها – تمكنت من ذرف أدمعٍ قليلة.
غصت في سيل من الأشياء التي لمستها أثناء سيري المتخبط في الدنيا، وتذكرت قصة ذكرها لي أبي كانت متوارية في حنايا عقلي، نصيحة قالها لي مرة، والمرات القليلة التي ضربني فيها.
حين خرجت سألتني أمي وأنا أمر أمامها: إنت كنت في أوضتي؟ قلت آه وأنا أخبئ وجهي منها، بتفرج على الصور. قالت طيب متنهدة. سألتها وهي تغوص في كرسيها: في صور تانية لبابا غير اللي في الصندوق في الكومودينو؟ أجابت، كشخص يخبرك بحال الطقس، في صندوق تاني فوق الدولاب، مفتاح القفل في جيب چاكيت البدلة الرمادي بتاعة أبوك.
المفتاح كان صغيرًا وصدئًا والصندوق كان معدنيًا متوسط الحجم كعلبة حذاء موشَّى برسوم باهته. لم أحتج المفتاح، لم يكن هناك قفل أصلًا.
جلست على السجادة القديمة، وأفرغت ما في الصندوق (الآن أفكر أنني ربما طرقت باب بابا محمود) ورق أصفر تناثر وقصاصات وتذاكر قطارات ومسرحيات وسينما، صور فوتوغرافية اهترأت أطرافها لأبي الخالي من ملامح الوجه في زمن لم تلمسه أمي. بلا وجه، مع جدي، مع عمي، مع أخواته، مع بابا محمود، مع دفعته في الجيش، بلا وجه، مع فتاة بدت مألوفة، في منزلٍ، أمام منزلٍ، يرتكن على سيارة، فى حديقتنا، بلا وجه.
لم ألحظ تلك الصور إلا في ما بعد، فوقت انفتاح الصندوق، كل ما رأيته كان الكتاب الذي انسل بخفة كأنه لا يريدني أن أراه. كان الغلاف كئيبًا وعليه خنفساء عملاقة تحمل رأس إنسان وممددة على سرير معدني عارٍ، ناظرة إليَّ، بعيون أبي.
الصور © حيدر ديوه چي