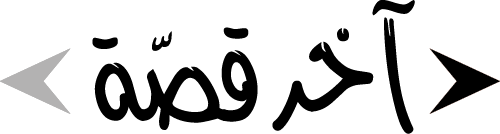قبل مدّة كان آلي مع جده، عندما بدأ الأخير يروي له حكاية عاشها في شبابه، كان يعبر طرقات بلدته المبنية من الطين، وهو في الثامنة عشرة، عام 1935، حين التقى فيما بدا له مصادفة نادرة، كهلاً داخل زقاق شبه معتمة، بدا غريبًا، بملابس رثه، وشعر رمادي مسترسل على كتفيه. «له عينين غامضتين كصوفي من الشمال وابتسامة غامضة سرعان ما تّضح إنها ليستْ سوى تكشيرة». حين اقترب من المسنّ أمسكه من ساعده، كان كهلاً قويًا، هتف بصوت قام من الأعماق: «أنت إبراهيم كادر». ولم يعرف إبراهيم إن كان المسن الغريب يخبره أم يسأله، كان إبراهيم شابًا صغيرًا، لكن الجميع يشهدون أنه قوي كالثور، هناك أشعار غير مكتملة تتداول بطولاته المبكرة، لكنه بين يديّ ذلك الكهل، أحس بنفسه مثل عصفور مبتل لا يستطيع الفكاك من الفخ المباغت. ولم يكن منه إلاّ أن أجاب: «نعم أنا هو الملعون إبراهيم كادر». برّر تخاذله لحفيده آلي فيما بعد: «كابرتُ على نفسي قليلاً إلا أنني شعرتُ بيدي تكاد تتحطم مثل خشبة يابسة».
«مابك مغرور هكذا؟» صرخ المسنّ في وجهه: «قريبك يهان من الأنذال، وأنت هنا كالبغل تقصف الأموال في الأعراس؟» جدّ آلي كان ثملاً ومع هذا لم ينس شيئًا، ترك وراءه عرسًا فخمًا لأحد الأشراف، قصف فيه رؤوس الجميلات بأموال طائلة نالها بفضل إيقاعه باحدى القوافل الكبيرة لتجار مارقين، ألقى ونثر القطع النقدية وكسر زجاجات العطور الغالية فوق رؤوس الحسان، ترك أيضاً جنونه مع رفاقه لأجل فتاة مجهولة الاسم بفستان أبيض مطرّز، ابتسمتْ لكل واحد منهم وأشعلتْ الرغبة في أجسادهم ثم هربتْ كظبية هائمة أو مهرة جامحة، اختفتْ بين الأزقة شبه المعتمة، بحثوا عنها كالممسوسين، كأنهم يبحثون عبر متاهة ضخمة، توزعوا بين الأزقة الضيقة، اتفقوا على إن من يجدها أولا يحوزها.
«كان جدي قد عبر عدّة أزقة متمهلاً.» هكذا قال آلي ورد كو وهو يروي هذه الجزئية لفتاته زارا: «حين أحسّ أنه تأنه في عتمة ضبابية غير التي تعوّد عليها حتى تلك الليلة، أخذ يدور في بقعة واحدة شاعرًا بثقل في رأسه من تأثير ما شربهْ والرعب الساكن، من بين طبقات العتمة، خرج كهل غريب بعينين كابوسيتين، ولم يستطع الردّ عليه بالرغم من الاهانات المتتالية التي كان يكيلها بلا توقف».
«من أنتْ؟» سأل ابراهيم بعد أن استعاد رشده، بصوت متردّد، مبحوح ومتقطع كالأطفال المرتعبين.
«من أنا، تسألني من أنا!» ردّد الكهل باندهاش ثم أضاف: «يتوجّب عليك أن تسألك نفسك، من أنت؟» ترك ساعد ابراهيم، بصق على الرمال، بصقة قاتمة كالدم ثم قال: «اسمع، والدك في حياته الأولى كان يعاني دينا ثقيلاً لتاجر جشع معروف بسيطرته على عدة مناطق، ولا يتساهل في تحصيل حقوقه حتى قيل: أن تموت جوعًا خير من أن تكون مدينًا له بدرهم. أنت لا تعرفه، إنه وحش في ثياب بشر، بالرغم من هذه السُمعة البشعة، استدان منه والدك، لنقل إنه اضطر لهذا، فاشترط التاجر عليه، فيما بدا كمزاح، أن يُسرح زوجته في حال انقضت المهلة المحددة دون سداد، كان والدك تزوج بأجمل الفتيات، وكان يحبّها أكثر من نفسه، لكن الوقت مضى سريعًا، لا أحد يعرف كيف تحدث هذه الأمور، لكنها تحدث بكل وقاحة، قبل يوم واحد من نهاية موعد السداد، نصب خنجره ليلقي بنفسه فوقه، بعد أن عجز عن إيجاد حل مرضي لمعضلته الأخلاقية الكبرى، وهي أحد أكبر ما قد يواجهه الصحراوي في حياته، عار عدم قدرته على إعالة أسرته، أو أن يعرف العالم بترك زوجته له بسبب دين مالي، زمن صعب وبغيض، أقول لك ما رأيته بعيني، قبل أن ينفّذ والدك انتحاره، لحق به أحد أقاربه، يحمل قيمة الدَّين، قدّمه لوالدك بكل سرور، قبل لحظات من فقدانه لكرامته.» صمت الكهل لوهلة متأملاً شيئًا ما، ثم أضاف: «أتعرف يا إبراهيم، هذا الرجل يُهان من قبل وغد هو حفيد ذاك التاجر اللص. لقد فقد تجارته بعد الحروب الأخيرة، فكوّن ما يشبه عصابة مسلحة تتبع الفرنسيس، وصار يقوم بغارات على القرى ويجمع من أهلها الأتاوات، في هذه الأيام يُهاجم قريبك الذي أنقذ والدك، انتشرت حكايته بين النّاس، يودّ أن يأخذ ابنته بدلاً من الأتاوات المفروضة ظلمًا، أيّ عار، أي مسبة في وجهك أنت بالذات، أقسم على ذلك، أنت ماذا تفعل، كالثور تقصف الأموال وقريب لك يُهان، فوق هذا ترقص في الأعراس والناس تضحك منك سرًا، كالبغل أنت ترقص.»
هذه الحكاية صارت من نوادر الحياة الصحراوية.
ففي صباح اليوم التالي، كان إبراهيم على مهريه يخترق الصحراء متّجهًا إلى بلدة قريبه، لم يفكر في شيء أخر ولم يخبر أحدًا، أخذ ما يكفيه رحلة السفر: الطعام والماء والمشروب، وحمل معه سلاحه، بعد ستة أيام وجد نفسه أمام مقهى قديم يُديره قزم من تيمبكتو، ومن ذاك المقهى جمع معلوماته الأولية عن الوغد الشقي الذي يؤذي قريبه. أخبره الكهل: شقي متمرّد على السلطنات ومنتفع من الفوضى التي خلقها الفرنسيس، يبدو مسنًا بعض الشي، لكنّه لا يزال قويًا، استعد إبراهيم للدخول في معركته، حتى إنه لم يزر بيت قريبه؛ لم يُرد أن يخبره بشيء، فقد أراد إنهاء المهمّة سريعًا ليتلاشى بعدها كالشبح، وليقابل قريبه المضطهد بعد تخليصه من كابوسه. كانت خطته بسيطة: اللثام والمباغتة والتصفية السريعة ثم التلاشي، فكرة الاختفاء تستحوذ عليه تمامًا، وهكذا احتاط بهدوء بالغ: «الأشقياء لا يتركون قاتل رفيقهم، لابدّ من الصمت التّام.» أمام أحد المجالس، تمدّد الوغد كالثور، جسد ضخم ببطن كالطبل، مستندًا بكتفه على دعامات أمام العتبة، جلسة سلطانية صارتْ قيلولة قبل الآوان. سحب إبراهيم رمحًا نحيلاً كان من بقايا أسطورة قديمة، سطرها أحد رفاق جده، هز الرمح حتى تأقلم ساعده على وزنه ونشطتْ همته، كان إبراهيم أحد أمهر من استخدم الرماح، تقدم ببطء وانبثق خارجًا من بين الأحراش، بعينين غاضبتين، تنفس عميقًا وشدّ عضلات بطنه وساعديه ثم أرخاها وأطلق الرمح بقوة، سمع صوت صفيره في الهواء، كتصفيق متواصل لمئات الأجنحة الصغيرة، أغمض عينيه لثوانٍ قبل أن ترتد يده، رأى ظلاً ثقيلاً يُحرّك الهواء ثمّ سمع صوتًا كالخوار، حينها فقط لاحظ اختفاء الوغد، كأنه لم يكن هناك، كأنه ذبابة. لم يستغرق إبراهيم وقتًا حتى عرف بتشبثه بعارضة المدخل برشاقة وقدرة بدنية هائلة، حتى بعد نصف قرن لم ينسَ إبراهيم ما حدث، روى لحفيده آلي وكان لايزال مندهشا: «.. كان سريعًا جدًا، في نفس اللحظة التي سحبتُ فيها رمحي الثاني لأطلقه ناحية الجسد المعلّق بالعارضة، اختفى ثانيةً تاركًا في الهواء صوتًا كالزئير، كالوهم، كالجبل المعتم الذي يظهر فوق السطح الخشبي للكوخ، ثم نظر لعينيّ مثل وحش، واحسستُ حينها بالرعب للمرة الثانية في حياتي، قفز متواريًا بين الأحراش المعتمة وراء المقهى، ولم أعثر له على اثر، كنت أهزّ رمحي الثالث، لكنّه اختفى كأن لم يكن.»
شاهد آلي تلك الابتسامة المشبّعة على وجه جدّه المتجعّد والمشرق أثناء روايته لحادثة مضى عليها كل هذ الوقت، باهتمام شديد وببطء، مستخدمًا كلمات موزونة من تاريخ الصحراء الكبرى، قصص انتشرتْ كالشائعات عبر القرى والبلدات والمدن التي يقطنها التبو فيما كان يحتسي الشراب عقب هجومه المباغت والفاشل. عندما وصل ابراهيم لبيت قريبه، كان قد سمع بما حدث: «ما بك، لماذا فعلت هذا؟» تساءل قريبه ولم يكن يجد سببًا مقنعًا لكل ما سمعه.
«ماذا؟» قال ابراهيم.
«في أول ساعات زيارتك تفتعل المشكلات.»
«لا تقلق، لن يقترب منك هذا الوغد.»
«لن يقترب مني؟». استنكر القريب ما سمعه ثم تساءل: «ولماذا يفعل؟». عندها عرف ابراهيم ما جعله يفكر مرتين متأخرًا. قريبه لم يكن في أي خطر، ولم يكن يعاني من أي شيء كما أنه لم يساعد والده بأي شكل طوال حياته، وفكرة تعريض زواجه للخطر بسبب المال، مضحكة لا يصدّقها حتى الأطفال.
في حوار معه حول القصص الأسطورية في أدبه، قال آلي شارحاً عن صفات آلي أليماي متمثّلة في هذا الجزء من تاريخ عائلته: «جدّي كان في الثامنة عشرة، وقد تعرض للخداع، نعم كان يستطيع رمي الرماح جيدًا، ويقصف في الأعراس أموالاً طائلة افتكها من القوافل، يُطارد الفتيات عبر الأزقة، لكنّه كان لايزال يرى الأوهام، كونه ثملاً لا يُلغي رؤيته وسماعه أمورًا غير حقيقية أو حقيقية، تلك التي شاهدها في الزقاق المعتم.» وفي مواضع أخرى من دفاتره الخاصة كتب محاولات استخراج عظمة هذه القصص: «حين روى لي جدّي هذه القصص كان قد فقد كل أسنانه ولم يكن بوسعه إلاّ أكل العصيدة ابتلاعًا وشرب اللبن ومداومة التدخين من غليونه الأسود كالجحيم، ظلتْ جدتي تقول إن من أسباب سقوط أسنانه غليونه هذا إلى جانب خطاياه الفظعية، جدّتي تمتلك موقفاً راسخًا ضده، لكنها لم تستخدم حقّها في الدفاع عن موقفها طوال حياتها بالرغم من كل ما يمكن اعتباره سيئات أقدَم عليها جدي في حقها، فقد أقدم على تطليق زوجاته الثلاث بمن فيهن جدتي، ثم تزوج بفتاة مراهقة تصغره بأكثر من نصف قرن، حينها كنت في التاسعة تقريبًا، ولم أكن أعرف ما يحدث حولي بشكل دقيق.»
في مقال عن طفولته كتب قائلاً: «حسنًا، إن كنتُ أرغب في كتابة مذكراتي عن جدي يتوجب علي فهم ما حدث معه جيدًا، وهذا ما حاولتُ القيام به طوال سنواتي منذ العشرين وحتى الثلاثين، لم يعرف جدي مطلقًا ما حدث ليلة مطاردته لصاحبة الفستان الأبيض ولقائه الغريب بالكهل الرثّ الثياب، كنتُ أمتلك قصة عنه كما إنني قابلتُ الكهل وجهًا لوجه، وسمعتُ منه ما حدث، يبدو الأمر أكثر غرابة من تلك الحقيقة التي اعتمدها جدي حتى لحظاته الأخيرة، باعتبار ذلك الكهل هو الإبليس الرجيم بعينه.»
كان هذا التفسير الذي اعتمده جدّه، إنما بالنسبة لرجال الأحياء الداخلية، فقد كان لديهم تفسير مختلف جدًا، لقد اعتبروها مكيدة ماكرة من أحدهم للنيل من ابراهيم ومن ذاك الشقي الضخم معًا، وردّدوا معًا أفضل وصف لهكذا وضع: عصفوران بحجر واحد. كان سبب الصراع بحسب رؤيتهم هو التحكم بالطرق التجارية، بشكل صار يزداد انتظامًا من بعد الفوضى، فإبراهيم المتحمّس كان يتبع دون أن يدري أسلوبًا قديمًا، من شأنه الإضرار بالمتدخّلين في هذه الشبكة المعقدة من العلاقات التي تكوّنت عبر القرون، بالنسبة لآلي فإن القضية بدتْ واضحة تقريباً بعد كل هذه السنوات من البحث والتقصّي، كان جدّه قادرًا على أمرين مهمّين في ذلك الوقت: تأمين عشرات العائلات والقدرة على تحطيم الطرق التجارية، وأن يجد دعماً في أي وقت؛ بسبب إدراك النّاس أنه لا يعمل إلاّ لأجلهم حتى عندما يبدو في أحيان كثيرة مبذرًا في الأعراس، وهذا هو ما تسبّب للبعض بالنّيل منه، ليس بشكل مباشر، إنّما باختلاق مكيدة مُحكمة، وهذا هو التفسير الذي اعتمده رجال الأحياء الداخلية طوال عقود، بسبب أن الرابط الوحيد الذي يربط إبراهيم بالشقي الضخم هي الطرق التجارية وسياسات تغيّر الأوضاع المتّبعة في تلك الفترة. الحكاية المفتعلة عن إهانة القريب والدَين المستحق ما جاءت إلا بسبب حماس ابراهيم وبُعده عن المعيشة الاجتماعية العادية القائمة على النمائم، وانخراطه في حياة ممارسة أقلّ ارتباطًا بالآخرين، العلاقات فيها تبدو أقرب إلى مصارعين داخل حلبة، فالضخم الّذي قفز إلى ما وراء أحراش المقهى لم يترك إبراهيم وشأنه، فقد تطوّر الأمر على نحو سريع أثار رعب من في القرية وما يحيطها من قرى منتشرة بمحيط تبستي.
يقال عمومًا أنّ الحادثة التي وقعتْ بعدها أنست النّاس قصة السقوط الأول للحامية الفرنسية، والتي انتهت بإعدام سبعمائة جندي سنغالي يخدمون في الجيش الفرنسي، تحدّث الجميع لسنوات عن التفاصيل الخفية والغامضة والمتشعّبة وراء الحكاية، حاولوا اكتشاف سبب حدوث كل ذلك، أعادوا ربط المشاهد التي حيكت بعناية. «أظنّني الوحيد الذي جمعها على نحو شبه مكتمل». هكذا قال آلي محتفلاً بإنجازه: «تذكرتُ بصعوبة روايات جدي عن تلك الفترة ورقمتها جميعها بلا ضبط أو ترتيب، وهكذا ظلّ كل شيء موجودًا بين الورق، ما كان هذا ليتمّ لولا تعرّفي على بركاى هامشي مي، فقد شجعني على الاستفادة من تاريخ جدي.»
عندما جاء كبار العائلة في تلك المنطقة والمناطق المحيطة، جلسوا في نصف حلقة كبيرة على الرمال الناعمة، أغلبهم يخطّون بأصابعهم على الرمال أشكالاً غير مفهومة، علامة على حيرتهم الأبدية، عندها تكلّم أحدهم، كان قد خسر عينه اليمنى في معركة كبيرة، صوته بدا حماسيًا، وكان يطرف بعينه السليمة: «هلّا شرحت لنا، لأي سبب فعلت أمرًا غبيًا كهذا؟» كاد يلقي بعمامته من التوتر، نظر مباشرة في عينيّ ابراهيم وقد كفتْ اصبعه عن العبث بالرمال، كان إبراهيم جالسًا في الجهة المقابلة له، بعيدًا، كأنه في محاكمة كابوسية، أجاب بهدوء: «أخبرني أحدهم أن قريبًا لي في خطر حقيقي، وغد تافه يهينه بين الناس.» ارتسمت ابتسامة غامضة على وجوه الأغلبية، وبدا لإبراهيم هزّ الرؤوس تباعًا والصمت من ثم أمرًا مضحكًا، لكن بسبب جلال الموقف، وكونه السبب فيه، جعلاه يكتم الضحكة التي نبتت في صدره، وظل يضحك فيما بعد لنصف قرن، كلما تذكر تلك الهزات المتتابعة للعمامات الضخمة المحيطة بالعمامة الصغيرة والقذرة لزعيم الجلسة، والتي تهتز بدورها، وقد بدا بعضهم مفحمًا من الإجابة. لكن صاحب العمامة النحيلة سأل: «فجئت تقتله!»
«ما كنت لأسكت». قال إبراهيم.
«لكنك أخطأت». قال أحدهم، فتكلم القريب: «يُدرك الجميع هنا أنه فعل ما فعل لإنقاذي، لا تنسوا هذا أبداً.»
«لكنه فعل شنيع.» قال أحد الحضور: «لا يمكن تناسي التبعات المكلفة لمهاجمة شقي لا يعترف بالسلطات.»
«مهما حدث، فإنه تحمّل المشاق ولم ينتظر لحظة عند سماعه أنني في خطر، جاء لإنقاذي وما كنت لأتركه في محنته ولا يجب عليكم تركه.»
«لن نتركه.» قال صاحب العمامة النحيلة: «لكن يجب أن نعرف من نقل إليه الخبر». عندها بدا إبراهيم محرجًا، وهو يحكي لهم بكل صراحة ما حدث معه، نظروا إليه بصمت، للإستيعاب، ثم استنتج أحدهم: «لأجل هذا تمّ تحريم الخمر.» فضحك الأغلبية، ثم شرح نتيجة بدتْ واضحة وضوح الشمس، بعد أن كسر غصنًا وأشار به: «الشيطان وسوس لك بهذا، المسألة واضحة جدًا، إنه الشيطان.» فلعن الأغلبية الشيطان في تمتمات قصيرة. «أي شيطان، إنه ملاك، شاب كهذا مكسب للعائلة، ألا تعتقدون هذا؟» قالها متهكمًا، فضحك الجميع، في حين أضاف ثالث وكان ذكيًا: «الكل يعرف أن الملائكة لا توسوس، بل تكتب ما تفعله وسوسة الشياطين». كان واضحًا أنّ القضية انتهت وما بقيَ كان مجرد تندّر، فوجد الضحك دفعة أخرى، لكن وراء تلك الضحكات تفكير جاد بعواقب ستحدث بلا شك، فلا أحد يمكنه التنبؤ بما سيقع مستقبلاً.
تنحنح صاحب العمامة النحيلة، فصمت الجميع وإزدادوا جدّية: «اسمع، لن نسمح لك بالمغادرة حتى نطيح بالوغد الذي أخطأته». هكذا قال وعبر بنظراته على العيون الجادة المجتمعة في نصف حلقة، ثم تطلّع في إبراهيم: «نطيح به؟ ظننتكم قلتم أنه بريء.» فقال صاحب العمامة النحيلة: «هذا كان في السابق، أما الآن فلن يكفّ عن مطاردتك، الذي قمت بمهاجمته البارحة، واحد من أخطر قطاع الطرق، لا يؤمن لا بالقيم ولا بالتقاليد، لا التبو ولا غيرنا، يرى أنها إخصاء متعمد، هكذا قال علنًا، لا يعترف بالسلطنات أو السلاطين، لا يؤمن بأي شرع ديني، لا يؤمن إلاّ بالانتقام، يتوجب علينا الاطاحة به.» في خصوص هذه الفقرة من قصة الجدّ كتب آلي على لسان شخصية متخيّلة في روايته المنفي الأبدي: «في تلك الفترة، تعلّم جدي معنى أن يكون الرجل في خطر حقيقي، أخبروه أن العدو قد يكون في أي شيء يتحرك، اهتزاز سعف النخيل الجاف صار رعبًا بالنسبة له، الخطوات التي في الخارج، الصرخات التي تتسلّل من بعيد على شكل عواء ذئاب في العتمة، النجوم التي تسيل من السماء، أجنحة الطيور التي تصفق في الظلام على غير هدى، كل شيء بدا أنها مخبأ أو إشارة على قاتل بارد الأعصاب، حتى صوت سرَيان المياه صار مرعبًا، وكانوا يحرسونه طوال الوقت وتشتد الحراسة عليه ليلاً، قرابة خمسين رجلا من العائلة تطوّعوا لحراسته، يحبسونه في دار صغيرة وينامون حولها، في أحد الأصباح وجدوا المكان مليئًا بأثار أقدام شخص واحد، كان القاتل قد تجول حول الكوخ مطولاً للبحث عن ثغرة صغيرة لينفذ من خلالها كالنسمة لقتله». بعد هذه الحادثة بعقود، نفث الجدّ دخان التبغ عاليًا في سماء غرفته بانتشاء، آلي جالس بالقرب منه، قال بصوته الجهوري المسرحي: «الحياة مهمّة، ولا شيء أثمن منها». ضحك لثوانِ ثم أضاف: «في تلك الأيام شعرتُ أنني لن أعيش لأحضر أي عرس آخر، لن أعيش لأبلغ العشرين، الوغد جعلني أعرف حقيقة كوني غرًا، لكنّني صمدتُ حتى تعبتُ من المراقبة اللصيقة وبدأت أشعر بالملل من هذا كله، فشرعتُ أفكر بالبحث عنه بنفسي، وهو أمر كانتْ مجموعتي ترفضه كليًا، كأكثر طلب جنوني، لتفادي الرفض تملّصت من المراقبة وبدأت البحث عنه بنفسي.» عندما بلغ الجدّ لهذا الجزء، أحسّ آلي بحماس، كان يستمع إليه وقد قرر منذ البداية كتابة ما سمعه، بدا الأمر مبهجًا جدًا بالنسبة له، آنذاك كان آلي ورد كو مولعًا بكتب الحروب العالمية المصوّرة وقصص نابليون وهتلر، مهتمًا بصور جنود هتلر الممدّدين على الجليد الروسي اللامع تباعًا وعلى صدورهم صلبان خشبية ضخمة، قرأ تفاصيل الحرب العالمية الثانية متتبّعًا سير تلك المعارك الكبرى على مشارف ستالينغراد. قال الجدّ مُسترسلاً: «ثم بدأتُ أخرج برفقة بعض الشبان من العائلة بعد أن خفّ الضغط علينا، ولم أكن قد نجحتُ في إيجاد القاتل، وكنا نعود قرابة المغرب لندفن أنفسنا في الكوخ، وتمّكن مني الملل والفتور، ولم أقدر على استعادة قوتي، لم أتوقف أبدًا عن تتبّع خطوات الوغد، حتى عرفتُ أنه يقضي وقته أحيانًا عند أرملة تُدعى وسيمة، كان يشاع أنها الوحيدة التي يقضي وقته عندها، فلأمثاله دائمًا فتيات يقضون أوقاتهم عندهن، كان هدفي منذ البدء هو العثور على هذه الفتاة، عدتُ للمقهى الذي وجدته فيه للمرة الأولى، أمسكتُ بالقزم التيمبكتي، غرستُ حد خنجري في فخذه وسألته ألاّ يُضطرني لغرسه أكثر، عندها أخبرني عن مكان وسيمة الأرملة، فتسلّلتُ خارجًا للبحث عنها حيث وصف، هذه المرة كنتُ لوحدي.»
هكذا روى الجد لحفيده، لكنه لم يخبره عن كل شيء، أضطر آلي ورد كو أن ينتظر طويلاً حتى عرف بقية ما حدث، كما عرف مزيدًا من القصص التي تحدث في المخادع، فالرجال الذين يجوبون الصحاري والقرى، يكونون بحاجة لمكان يبيتون فيه، إذ لا فنادق ولا نزل، الأرامل والمطلّقات اللائي بلا معيل يوفرن هذه الميزة، يفتحن بيوتهن كفنادق للجوالين، يُقدّمن الطعام والشراب بما يحضره هؤلاء. لابد أن «جد آلي» قدّر هذا الأمر في نفسه، عن أكثر مقصد لرجل طبيعي، بلا عائلة، ولا يؤمن بالتقاليد القبلية والدينية. الرجل مهما اعتقد في حياته، فلا يمكنه أن لا يؤمن بحاجاته الإنسانية، للجلوس بصحبة امرأة؛ للحديث والاستمتاع وأكل طعام منزلي ساخن، وقضاء ليلة في مخدع إحدى الجميلات. وسيمة لا تستقبل أحدًا سواه بحسب وصف الجدّ لحفيده، فهي أجمل فتاة شاهدها في حياته، الأجمل على الإطلاق، كانتْ في العشرين من عمرها، بشرتها الخلاسية كالتربة المروية، ولديها إبن في حوالي الثالثة من عمره، بدا نشيطًا وذكيًا على مدى الأيام التي راقب أثناءها كل حركة في دارها، جالسًا أعلى تلّة تطلّ على المنطقة. كانتْ الأم الصغيرة تنزل كل صباح لشراء حاجياتها اليوميّة القليلة، وظلّ إبراهيم يراقبها لعدّة أيام، بدتْ رائعة بملابسها المشجّرة، عليها تلك الرسومات التي تتماوج خلال مشيها في الطرقات، في أوقات الصباح والعصرية، مزاجها لطيف مع الجميع. كانتْ أفضل فتاة يختارها أي رجل، استغرب أن يكون ثور الذي شاهده بهذا الحظ والذكاء، ليقنع فتاة مثلها أن تظل بانتظاره طوال فترات غيابه، دون أن تُدخل أحدًا لمخدعها أو تسمح لأي عابر بطرق بابها. آلي لم يتعجّب من استغراب جدّه ولا من علامات الغرام البادية على وجهه وهو يتحدث عنها بعد كل هذه السنين، وأدرك أن هذا ما دفعه لإقتحام بيتها في تلك الليلة، كانتْ تغتسل في الفناء تحت ضوء القمر، شموع مضاءة بالقرب منها، شعرها المكشوف يستلقي مبللاً على ظهرها، كرسومات الكهوف، فيما يتلامع ضوء الشموع بكسل على بشرتها المبلّلة بقطرات كثيفة على الجزء المكشوف من ظهرها، تمعّن فيها جيدًا فيما هو متوارٍ في طيّات العتمة، فوق السطح، ناظرًا من الأعلى إلى الضوء المرتعش على جسدها، لم يكن أمرًا يراه على الدوام.
«أنه السحر، هو هذا». هكذا تمتم الجد.
هذا النصّ فصل من رواية «الفنان»، والتي يواصل المؤلف كتابتها
صورة الشريط © حيدر ديوه چي