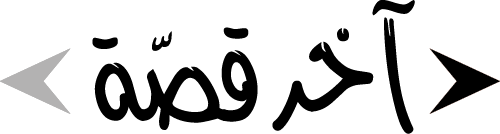عادت زوجتي ذات يوم، فنقلت حديثا قصيرا دار بينها وبين صاحب دكان البقالة المواجه لمنزلي، أخبرها أنه يراني رجلا طيبا، أرضى بأي شيء وأنه يحترمني بشدة حد أنه يقف إكبارا لي ما أن أدخل المحل. اندهشت، فنادرا ما تبادلت معه الكلام خارج نطاق البيع والشراء، ولم أنتبه أصلا لدلالة وقوفه عند رؤيتي.
كان صاحب الدكان أربعينيا، متوسط القامة، قمحي البشرة، ذي شعر أكرت يختلط فيه البياض بخصلات شعر رمادية، كانت ملامحه أقرب للوسامة، منبسطة، منسجمة مع أدبه الجم وصوته الخفيض الهادىء إذا ما تحدث، لكن شيئا ما جعلني مرتبكا حياله، فوجوه الفلاحين، كما خبرتها في حياتي، دائما ما تخفي شيئا ما فلا تعرف إن كان طيبة حقيقية، أم خبث قاتل يتحين الفرصة، أما زوجته الريفية القحة في مظهرها وجلبابها الذي لم تتخل عنه ولا عن لكنتها أو عاداتها، فلم أحبها أبدا، ربما لأنها لم تحاول إخفاء شيء.
كانا يتبادلان الوقوف في الدكان، هي من الصباح الباكر لتبيع الحلوى الرديئة مجهولة المصدر، لتلاميذ المدراس الابتدائية، ثم تأتي ابنتها الكبرى( وهي نسخة مصغرة من الأم) لتغطي فترة العصر، حتى يأتي الأب ليستلم نوبة عمله من المغرب إلى ما بعد منتصف الليل بساعة أو ساعتين.
علمت أنهما انتقلا من الأرياف حديثا، لكن الزوج كان يعمل كموظف بالقاهرة، وكان يسافر يوميا إلى قريته، ثم قررا بعد إرث مفاجىء أصابته الزوجة، استيطان الحي السويسري وافتتاح مشروعهما العائلي، وهو ما فسر لي أيضا امتلاكه لنفس ماركة سيارتي شيفروليه أوبترا، لكن سيارته ذات موديل أحدث، رغم أن دكانهما لا يزيد عن كوة في حائط تدعى زورا وبهتانا عبر لافتة رسمت بفوتوشوب سيء الذوق أنها سوبر ماركت.
في رأيي لم نكن نحتاج إلى دكان بقالة إضافي من ذلك النوع، فإذا ما سألتني عما ينقص الحي السويسري بمدينة النصر، فسأقول بلا تردد: الثلج. بياض كثيف ومحيط يغطي المكان، كثوب خال من الدنس، فلا شيء يعود قذرا إذا ما غطاه الثلج. لا أفضل هطولا رقيقا وبطيئا، بل أن يضرب كإعصار يطهر الحي من حصار الفقر والبيوت العشوائية القبيحة، الكافيهات غير المرخصة، القمامة، طفح المجاري، البلاعات المفتوحة، البلطجية، المدمنين، حوادث السرقة بالإكراه، التكاتك، الضجيج، الكلاب الضالة، الشوارع المليئة بالحفر، الأرصفة المتكسرة، فيعيده إلى سيرته الأولى، مثالا للجمال والنظام والنظافة، تماما كما كان قبل أقل من خمسة وعشرين عاما.
حلم مستحيل، لكن به أتعزى، فأبدا لن تهبط الثلوج في الحي السويسري، بل ستنشق الحوائط عن المزيد من دكاكين البقالة الصغيرة، التي لا تبيع سوى أردأ المنتجات وأرخصها.
لفترة قصيرة تجاهلت المشروع العائلي البائس وواصلت شراء حاجياتي من الهايبر ماركت البعيد، فلم أكن أبدا زبونهم المستهدف، وإذا ما وجد فوق رفوفهم نوعا ما اعتدت على شرائه، فلن يتوافر إلا في أصغر حجم ممكن، وهو ما لا يكفي بالطبع احتياجات عائلة من الطبقة الوسطى مكونة من زوجين وثلاثة أطفال. كان الدكان يخدم عشرات العائلات الأخرى التي تناثرت حولي كسرطان، وهي علامة لم أكن أحتاج إلى رؤيتها على انحدار الحي السويسري إلى مستوى شعبي، رغم ذلك لا أنكر أن وجود الدكان كان إعلانا صارخا بتمام الحصار.
لم يصمد التجاهل طويلا، كالمشي منوما إلى هوة، صرت زبونه اليومي.
بدأ كل شيء من تضاعف أسعار السجائر عدة مرات، لأهبط معها درجة تلو درجة من تدخين الميريت الأصفر إلى الإل إم، ثم مرورا بأسماء كالفيسروي والنيكست والبال مال وقذارات أخرى. لم أطق تدخين الكليوباترا، ففضلا عن أن لطعمها مذاق التعاسة، كانت تذكرني بأيام الفقر المريرة. لم أستطع التوقف عن التدخين ولا تقليل العلب الثلاث التي أنفث دخانها يوميا في انتظار الثلج.
انتهيت إلى شرب سجائر الكاريلا المهربة والتي لا يزيد ثمن العلبة الواحدة منها عن ثمانية عشر جنيها، على عكس باقي أنواع السجائر المهربة، كانت علبتها أنيقة ولا يوحي فلترها الصلب وطريقة كبس التبغ أنها مجهولة المصدر، كما أن مذاقها ورائحتها كانا معقولين، وقد حماها تهريبها من الارتفاع الهيستيري لأسعار السجائر والذي لا يبدو أنه سيتوقف حتى لو بلغ سعر الميريت الأصفر مائة جنيه لللعلبة.
كانت الخيار الوحيد المناسب بكل المقاييس، مشكلتها الوحيدة أنها لا تباع في الهايبر ماركت بالطبع، وكذلك أغلب المحلات التي تخشى حملات التموين، كان الوحيد الذي يواظب على شرائها في المنطقة، بل ويجرؤ على وضعها في الواجهة، هو صاحب شق الحائط الذي افتتح بالقرب من منزلي، فصرت زبونه اليومي. لم أعد أكتف بالسجائر، امتدت يدي إلى علب البن والمياه الغازية والعصائر والشيبسي والبسكويت – الذي بإمكاني الوثوق في مصدره – للأطفال، وكذلك صارت زوجتي زبونة دائمة، حيث يمكننا شراء العبوات الأرخص حجما من الزيت واللبن والجبن، أشياء لا يليق أن يهز المرء طوله كي يشتريها من الهايبر ماركت. لم تعد الخصومات الكبيرة تحمينا، من آن لآخر أفتقد حس الخدر والوفرة وسط طوفان من البضائع.
كنت ممتنا ولا شك لمبادرته بالوقوف عند دخولي، رغم عدم احتياجي لها، عندما ذهبت إليه في اليوم التالي لشراء سجائري، أبدى علامة احترامه، فأشحت ببصري، وودت لو انشقت الأرض وابتلعتني من الحرج .
عدت إلى بيتي دون أن أعرف ما الذي يزعجني حقا، هل لأني أشعر أني محل خدعة ما، فقد كان وهو زوجته، يرفضان أن يتركا جنيها واحدا إذا ما تعذر وجود فكة، وأغلب الظن أنهما كانا يدعيان عدم توافرها ويفضلان بدلا من ذلك توريطي في شراء أشياء لا أحتاجها بباقي عشرة أو خمسة جنيهات، وإذا ما حدث وتركا الجنيه الزائد لصالحي، فلا يتوانيا عن تذكيري به ولو بعد حين، لم أكترث، كنت أشتري ما يعرضانه دون أن أنبس بحرف، أو أترك لهما الفكة دون أن أطالب بها لاحقا، ورغم أن طريقتهما أثارت حفيظتي، إلا أني تفهمته كسلوك طبيعي، فهكذا تجري الأمور في القاع، حيث للمبالغ الصغيرة وزنها لدى النوعية التي يتعاملون معها من الزبائن، ألهذا رأى أني رجل طيب يسهل إرضائه؟ بسبب عدم مبالاتي بشأن جنيه أواثنين؟ أذاك مبرره الوحيد لاحترامي أم أنه أدرك علامة استسلام ما في وجهي؟
من بين صفات عديدة أمتلكها وأعتز بها، لم أكن يوما الشخص الذي يسهل إرضائه، هذا الرجل لا يعرف عني شيئا، لقد جئت من القاع، من أحراش المدينة وهامشها الفج، عشت طفولتي في بيت ضيق ومتهالك تخنقه رائحة الصرف والجنون وتأكل جدرانه الرطوبة ونشع الفقر والكآبة، ومن أجل أن أصل إلى ما صرت عليه، كافحت سوط الشمس والجلافة بالغربة لأكثر من خمسة عشر عاما ، فعلت فيها كل يلزم لأنجو، وكل ما لا يقره الطيبون الراضون، وشيت، ضللت، زورت، وشددت وثاق أرواح عشرات مثله إلى هاوية، ولطخت يداي دماء جريمة، لا.. لم أقتل أحدا، لكن أليس لكلمة جريمة أيضا وقعا مميزا كالحي السويسري؟
لقد اخترت هذا المكان تحديدا من أجل الاسم، انطقه معي، كرره، تذوقه بطرف لسانك، استشعر فخر حضوره بروحك، وقل لي، أليس شيئا رائعا أن تخبر الناس أنك تسكن بالحي السويسري، أن تطلب من سائق التاكسي أن يقلك إلى الحي السويسري، أن تكتبه في بطاقتك كمحل للإقامة، أن تقول حماتك متباهية أمام أقاربها وجيرانها أن ابنتها تسكن الحي السويسري، هذا اسم يليق به هبوط الثلج، لا حصار الفقر.
بدماء عمري، بنزيف أسود وقاتم، اشتريت بيتي في تلك المنطقة، وصرفت ثروة على تشطيبه وفرشه، أبدا لم أكن هذا الرجل الذي يدخن السجائر المهربة لولا أني عدت بعد تصفية غادرة للعمالة، كنت أخطط لخمسة أعوام أخرى تكفل لي تقاعدا مريحا، أو أن أقيم مشروعا لن يكون بالتأكيد، محل بقالة آخر يملكه رجل بائس يعيش من ضربة حظ كفلها ميراث زوجته، حتى أنه وبسفه بالغ يفضل شراء شيفروليه أوبترا حديثة على أن يملك سوبر ماركت محترم.
يظن أقاربي أني أخبىء كنزا، وأني عدت بمدخرات تكفل لي الحياة متبطلا، عرضوا علي عشرات المشاريع الخائبة، ولما يأسوا من استغفالي اتهموني بالبخل، لا يعلمون أن كل ما جمعته كفل لي بالكاد سيارة ووديعة لمدراس الأطفال وشقة في الحي السويسري، لم يمر علي ثلاثة أعوام في مصر، حتى تبخر أغلب ما ادخرته، وتحول مكان سكني إلى كابوس من العشوائية والقذارة، لأكتشف أني بذلت حياتي من أجل صعود سلم ذي قاعدة مهتزة متآكلة.
لعدة أيام، ظل وقوفه لي كلما دخلت مربكا، وواصلت تجنب النظر إليه، ربما حاولت تفحص وجهه بضع مرات خلسة، لأتبين ما يخفيه، ثم نسيت الحكاية كلها، واعتبرت اهتمامي بها من الأساس شيئا تافها لا يليق بي، مع الوقت لم أعد أنتبه لوقوفه عند دخولي، لكن ذلك أيضا – كشأن كل شيء – لم يصمد طويلا.
ذات ظهيرة حارة، نفذت سجائري، فذهبت إلى الدكان، وكانت نوبة عمل الزوجة، اشتريت ثلاثة علب سجائر وزجاجة مياه غازية وبسكويتا لأطفالي، كان الحساب ستة وستين جنيها، أعطيتها سبعين جنيها فقدمت خيارها المعتاد، أن آخذ شيئا ما بأربعة جينهات عوضا أن تترك الجنيه، قلت للمرة الأولى: لا أرغب في شراء شيء. لا أعلم الذي دفعني للاعتراض، ربما لأني لم أحظ ذلك اليوم بنوم جيد مما جعلني عصبي المزاج، ربما شيئا ما في طريقتها الريفية القحة، شيئا عفنا برز من عينيها فأنبىء أن مسألة الاحترام برمتها مسرحية من أجل استغفالي، أو ربما – وهو ما أنكرته طويلا – لأنها لم تقف أبدا عند دخولي المحل، وكانت تبيعني مشترياتي بكسل ولا مبالاة واضحتين.
عندما أدركت إصراري على الحصول على الباقي، فتحت الدرج، ثم أخرجت لي جنيهين بدلا من أربعة، لا أتذكر إن كنت وضعتهما على الكاونتر بجلافة، أم قذفتهما بعنف. الأكيد أني قلت باحتقار بالغ: لا أريدهما، ثم أخذت سجائري ومضيت دون أن ألتفت ورائي وأنا آكل نفسي من الغضب، مرتبكا حيال مشاعري، لا أعلم إن كنت قد بالغت بردة فعلي، أم أني اتخذت الموقف الصحيح، لمت نفسي ولعنت السيدة البخيلة التي أفسدت يومي من أجل جنيه تافه، ثم استبد بي قلق عارم وقبيح، وبقيت طيلة اليوم أفكر في حياتي بأكملها، دون أن يكون ذلك مرتبطا بما حدث في الدكان، وظل عقلي يجر قائمة آثام واتهامات وجهها جميعا إلي، كأنما يفتش عن مكمن الخطأ الأول، فمنذ عدت إلى القاهرة وأنا أنتظر عقابا قاصما، وسواء ارتكبت شيئا أم لم أفعل، فقد كنت استشعر دائما قدومه، والأخطر هو إيماني أني استحقه.
في جوف الليل سيطر على ذهني سؤال واحد، مكمن قلقي الذي حاولت إخفائه، هل سيقف صاحب الدكان احتراما إذا ما دخلت محله بعد ما فعلته مع زوجته؟ وهالني أن ذلك هو جوهر ما يخيفني، هل تسلط علي بحركته السخيفة إلى هذا الحد؟ أهنا مربط الفخ؟ أم أن احترامه سيدفعه لتفهم الموقف، سيأخذ صفي، وينهر زوجته التي تفقده ببخلها علاقته بشخص يعده ثمينا في حياته إلى هذا الحد، سيجبرها على الاعتذار لي، حينها سأقول بابتسامة ودودة متواضعة، لكنها تكشف كبرياء رجل نبيل: لا عليك.. فلم يحدث شيء. ثم يعود العالم إلى الاستقامة.
تجنبت شراء حاجياتي من المحل في اليوم التالي ولعدة أيام أخرى، عليه أن يدرك أن مشاعري قد جرحت بتصرفات زوجته. تدبرت أمر السجائر من سوبر ماركت أكبر وأكثر نظافة واتساعا، لكنه يقع على مسافة أبعد، يبيع الكاريلا أيضا لكنه يخبئها أسفل الكاونتر هربا من التموين، حرصت أن أعود وأنا أحمل أكياسا كبيرة من المشتريات، وأن أمر أمام دكانهما، وعندما ظننت أن عقابي كافيا، وأن الوقت قد حان لأقبل الاعتذار، ذهبت إليه.
كنا في منتصف الليل، تخيرت هذا التوقيت كي أضمن خلو الدكان من زبائن آخرين وعدم لقاء زوجته قبل تسوية الأمور، ألقيت السلام عليه لأجس النبض، فرده بابتسامة متكلفة دون أن ينظر إلي، لم يقف، وبدلا من ذلك ادعى انشغاله بمشاهدة فيلم سخيف في التليفزيون الصغير الذي يعلقه عاليا في مواجهته، تجمدت مكاني مرتبكا، طلبت علبة بن، وكان ثمنها سبعة عشر جنيها، أشار بإصبع لا مبال إلى أن أكياس البن ورائي، دون أن يحول بصره عن الفيلم، وبحركة من رأسه فهمت أني أقف أمام التلفاز وأمنعه من مواصلة الفرجة، تناولت طلبي، ثم أعطيته عشرين جنيها، لم يكن معي سواها في جيبي، وقد قررت أن ألقنه درسا إذا ما عرض علي شراء شيء بالباقي، لكنه أخرج خمسة جنيهات وأعطاها لي في ترفع، وضعتها في جيبي بخضوع، قلت بصوت خفيض: يبقى لك، هز رأسه، ثم عاد لمتابعة الفيلم.
“أهذا كل شيء؟” لا أعرف إن كنت قلتها همسا، أم ترددت كفضيحة مدوية داخل عقلي. نظر لي في اندهاش، فانصرفت متعثرا في خطواتي، هاجمني كلب ضال انشق من الظلام، فصرخت ذعرا، ولما هدأت، أصررت على العودة إلى الكلب، ممسكا بحجر، كي يتعلم ألا يكرر هجومه عند مروري، أني لست رجلا طيبا يسهل إخافته، لكنه تبخر من أمام عيني.
عدت إلى فراشي، صرت أنفث الدخان، سيجارة تلو أخرى حتى كادت أن تنفذ، لم أنتبه إلى أنها العلبة الأخيرة، بكيت بحرقة، ثم غصت في نوم طويل، بلا أحلام، فقط بياض كثيف ومحيط من الثلج يغطي كل شيء.
صورة الشريط © حيدر ديوه چي