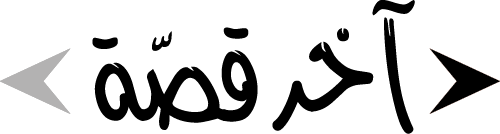في تلك الليلة التي ترك فيها نافذة الغرفة مفتوحة، في تلك الليلة التي كان فيها الهواء الصيفي يحرك الستارة، في تلك الليلة تحديدًا حلم حلمًا غريبًا، وليست الغرابة في مضمون الحلم، كلا.. كلا لكن الغرابة في أن الحلم يسبب له الكآبة رغم أنه لا يتذكره بوضوح حينما يفيق. في تلك الليلة حلم بنفسه جالسًا داخل خندق على الجبهة شرق القناة بعد عبور خط بارليف، كان يرتدي زيًا عسكريًا متواضعًا ويتقلّد بندقية قديمة، يجلس بجواره مجند ليست لجسمه كتلة واضحة. كان المجند يسأل كثيرًا ويدخن، ويستمع بمذياع خشبي صغير لإذاعة الاحتلال الإسرائيلي.
قال المجند: أنت ستموت أيضًا، لكن ليس في فراشك بل في معارك المزرعة الصينية. دخن سيجارة كاملة بصمت ثم قال وهو يشير إلى كتفه: سوف يصيبك ضابط من كتيبة المظلية بنيرانه، ربما كان اسمه شاؤول، وقلد صوت اندفاع الطلقات.
قال له وهو غير مصدق: لا يهم.
أخرجَ المجند من محفظته صورة فوتوغرافية لفتاة خجولة تقف في حقل برتقال: هذه ابنتي حبيبة، أزوجك إياها إن أردت، وضحك.
أعادها له بصمت.
قال المجند: أنا لا أريد الحرب، لكن ماذا نفعل وهؤلاء الأمريكان يحتلون أرضنا.
قال له: ليسوا أمريكان.
قال المجند بغضب: لا يهم، أنا لا أخشاهم. ومد يده وهو يرفع أربعة أصابع: لقد سحقنا لهم ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مشاة. لقد أسقطنا كل طائراتهم المهاجمة. صمت وبعد وقت قال: لو سارت الأمور على هذا النحو لكنا انتصرنا يا أخي. ثم صمت طويلاً
قال له: هل تأكل؟
رد المجند: لا. أريد أن أتبول، ثم أضاف منفعلاً: أنت تحلم الآن بينما أنا هنا أقاتل الأمريكان يا أخي.
حينما أفيق في الساعة الثامنة أو السابعة من حلم مزعج – ولا أدري تحديدًا ما المزعج فيه – أشعر بالكآبة، ليس لأنه حلم مزعج، لكن لأني أشعر بالمسؤولية تجاه شيء ما لا أدري ما هو. دارت في نفسي وأنا أعتدل لأجلس على حافة السرير رغبة العودة للنوم. كانت المثانة تزعجني، قمت لأتبول. وفكرت في أن المثانة منبه جيد. كان أبي جالسًا على الكنبة يتابع التلفاز بتركيز، ثرثرة عن الوضع الاقتصادي. من المطبخ انبعث صوت الطاحونة الكهربائية. لما عدت لسريري مددت يدي على علبة السجائر، أردت أن أدخن سيجارة واحدة ثم أكمل نومي، لكن الولاعة لم تعمل. قمت لموقد الغاز في المطبخ، الزرقة في نار الموقد مريحة، وقفت قليلاً أراقبها بصمت وأدخن. قالت أمي إني أزعجها بهذا الدخان، ثم طلبت مني أن أغسل وجهي وأستعد للأكل وأن أذهب لأدخن في البلكونة. أبي من مكانه شاركنا بصوت جهوري وقال لأمي إن ابنك هذا لا يفعل شيئًا في حياته سوى النوم. أطفأت نار الموقد وعدت للسرير. في شاشة الجوال اقتربت الساعة من الثامنة. لم أجد منفضة السجائر بالقرب، فأطفأت السيجارة بحافة السرير الخشبية ورميت العقب خلف الكومودينو. تمددت وأغلقت عينيّ، قلقت قليلاً من الحلم الذي لا أتذكره بوضوح، لكن أتذكره بشكل عام. ورجوت في نفسي ألا أرى أي حلم. يمر وقت النوم دون إدراك، أو على الأقل شاشة سوداء ليس لها معنى.
لقد رأى حلمًا غريبًا، في ليلة باردة ومطيرة داخل خندق في الجبهة على خط بارليف رأى نفسه مرتديًا زيًا عسكريًا، ويجلس على الأرض، بجواره السيد الرئيس أنور السادات ينظر لخريطة ميدانية مدها أمامه الفريق سعد الدين الشاذلي. كان السيد الرئيس يرتدي بدلة أنيقة، ويضع على رأسه معطفًا عسكريًا يتقي به المطر الغزير. كان الشاذلي منفعلاً جداً، ويتحدث بصوت مرتفع حتى يسمعه السيد الرئيس؛ لأن صوت المدفعية المتقطع يصم الآذان. أشار الشاذلي على الخريطة وهو يتكلم بغضب: أنت طلبتَ تطوير الهجوم. والآن أنظر ماذا حدث. رد السيد الرئيس أنور السادات مندهشاً من جرأة الشاذلي: أنا اديتك أمر وأنت لازم تنفذ، لأن أنت مش بتفهم سياسة. أحنا مش عايزين نموت الإسرائيليين، احنا عايزين موقف كويس على الأرض عشان لما نتفاوض معاهم نتفاوض من مكان قوة يا أستاذ. سمع الشاذلي وهو يقول كلامًا كثيرًا عن تحريك بعض الألوية. إلا أن السادات سحب الخريطة الملطخة بالوحل وقال: مافيش حد ينسحب، ولا بندقية وحدة. ولّا هرميك في السجن. كان كل شيء واضحًا في الحلم كما لو كانت صورة تلفزيونية، صواريخ سام التي تطارد الطائرات في السماء المظلمة وأضواء المدفعية المبهرة، ناقلة الجند التي تطارد المجندين وتدهسهم، لكن لاحقًا حينما يستيقظ سوف ينسى، وتبقى صورة ضبابية للسادات غير واضحة، لا يتذكر إن كان قد قال كلامًا عن النصر أو كلامًا عن المدفعية أو محاسبة الضباط أو شيء نحو هذا. لكنه على أي حال، حينما يفيق ويدخن سيجارته الأولى سوف يشعر بالكآبة.
الحلم الوحيد الذي راود الضابط الذي خدم في لواء حاييم في جيش الاحتلال الإسرائيلي: راود الضابط الذي ربما كان اسمه شاؤول، والذي كان يتأتئ في طفولته، والذي تعرض لسخرية زملائه في المدرسة من عدم توافق حركة عينيه بسبب ضعف في عضلات عينه اليسرى، والذي تحرش في مراهقته بابنة الجيران التي تكبره بتسع سنين، والذي كان يسرق من المال الذي تدسه في دولاب ملابسها. والذي كاد أن يغرق حينما بدأ في دروس تعلم السباحة التي تركها بعد ذلك، والذي تعلم التدخين في سن مبكر حينما كان يخرج مع رفاقه للتسكع في الشوارع القريبة، والذي كان على خلاف مع والده بسبب موضوع الهجرة لأمريكا، والذي لا يعلم أن عمته قُتلت في نهاية شارع ريفولي قريبًا من ميدان الكونكورد بعد أن انظمت إلى المقاومة الفرنسية ضد النازيين، والذي لم يكمل دراسته من كلية الحقوق، والذي التُقِطت له صورة دعائية واقفًا فوق عربة مدرعة بلباس مغبر وذقن غير محلوق ويظهر بجواره أعلى العربة علم أحمر صغير، والذي لو لم يقتل في معركة المزرعة الصينية لكان الآن أبا لطفلين ويراجع عيادة للصحة النفسية في شارع انديانا آفي، والذي شاهد الجنرال اريال شارون وأدى له التحية في المناطق المحاذية لطريق ابو طرطور شرق القناة، والذي قُتل بصاروخ مضاد للدروع في معركة المزرعة الصينية أطلقه الرقيب أول محمد محمد مأمون، رواد هذا الضابط في كل الليالي التي نامها بعد حرب ٦٧ حلم متكرر لا ينقطع، رأى نفسه ممسكًا بعصى غليظة يدفع بها رأسه الذي يتدحرج أمامه في كثبان رملية صفراء لا نهائية .
تلقيت مكالمة من صديقي الذي دائمًا ما يبدأ المكالمة: أنت فين يا ابني. وبعد أن طلب مني الخروج قلت له أنني سوف ألحق به. في العاشرة تقريبا كنت قد دخلت القهوة ورأيته يشير بذراعه الطويلة وينادي بصوت عالٍ. صافحته دون أن يقوم من مكانه. حينما جلست أمال رأسه ناحيتي وسألني ودخان الشيشة يخرج من فمه هل معي حشيش، قلت له وأنا أضحك: ليس معي شيء. كان كما هو دائمًا مندفعًا وغير مبالٍ، إلا أنه طيب، منذ طفولتنا كان يقتسم معي كل شيء جيد يحصل عليه ويقتسم معي مشاكله أيضًا. أردت أن أقول له عن موضوع الأحلام، لكن لم أقل حتى لا يبدو الأمر متكلفًا. قال لي: شفت – وسحب نفسا من خرطوم الشيشة – المرة المخلولة عملت إيه؟ وبدأ يحدثني عن حماته التي طلق ابنتها بعد أقل من سنة زواج. وضعتُ علبة السجائر والولاعة على الطاولة، وصرت أشعل سجائري من الجمر على رأس الشيشة، وأستمع إليه وأعلق بتعليقات محدودة مؤيدة. كانت الأصوات تنبعث من كل مكان من الأفواه والشيش والتلفاز والموبايلات ودينمو الثلاجة وغلاية الماء ومن العربيات في الخارج. طلب لي – وهو مازال يتحدث عن مشكلته مع حماته – شاي كشري. ثم راح يضحك ويقول إنه يحسدني لأني لم أتورط بموضوع الزواج هذا. سألني إن كنت أنهيت إجراءات عمل تأمين طبي لأبي وطلب من عامل القهوة أن يغير له الجمر على رأس الشيشة. أشعلت سيجارة أخرى من الجمر قبل أن يغيره. قلت له إني أنتظر أن يستخرج تقريرًا طبيًا. التفتَ إليّ بجسمه كما لو تذكر أمرًا مصيريًا وسألني – وهو يشير بخرطوم الشيشة – مرافقته إلى الإسماعيلية، قال لي: لأجل تعزية رفيق قديم توفى والده. حاول أن يذكرني به، قال لي إنني قابلته مرة أو مرتين. تذكرته حينما قال لي إنه هو الذي كان معنا حينما تعطلت بنا السيارة على كوبري ٦ أكتوبر. قلت له إنني ربما لا أستطيع الذهاب، في الحقيقة تكاسلت أن أقطع كل هذه المسافة لأجل شخص لم أقابله إلا مرة، ربما لن يتذكرني. قال لي إننا لن نتأخر. أشعلت سيجارة بولاعتي وقلت له: سوف أفكر. طلبت كوب شاي آخر، شاي كشري. وهو يلعب بالموبايل لعبة قتالية أو شيئًا نحو هذا أشار لي لأنظر للتلفزيون، رأيت على الشاشة ياسمين صبري في لقاء مسجل مع إسعاد يونس، كانت جميلة ومحببة. علق متحمسًا إن هذه الياسمين هي إله الجمال عند قدماء المصريين، وضحك. ثم شتم وقال إنه خسر بعض النقاط بسببها. قلت له أنها عادية، نظر إليّ مشمئزًا وهو يُنزل الجمرَ عن رأس الشيشة بمفتاح الشقة. صمتَ وأكمل لعبته. طلب رأس شيشة ثاني، ووضع موبايله على الطاولة. سألني عن أخبار الشغل في الصحيفة، قلت له إن كل شيء كما هو. غيّر عامل القهوة رأس الشيشة ووضع جمرًا جديدًا، أشعلتُ سيجارة من جمر الشيشة، وقلت له أنني أعمل على كتابة قصة قصيرة، عن حرب أكتوبر. شاهدت كثيرًا من شهادات الضباط المصريين وضباط جيش الاحتلال، أفلام تسجيلية، خطابات السادات في البرلمان، قرأت مؤلفات عربية ومترجمة عن الحرب، ما كتبه السادات وبقية القيادات العسكرية عن الحرب. سجّلتُ ملاحظات على أكثر من أربعين صفحة عن كل شيء، عن أنماط الشخصيات، الأسلحة المستخدمة، أعداد القتلى والأسرى، التطور اليومي على الجبهة، سجّلتُ رسومات ومخططات توضح مواقع وتحركات القطاعات العسكرية. هذا العمل متعِب، العمل الفني ليس سهلاً، عليك أن تعرف كل شيء كما لو كنتَ قد رأيته بنفسك وشاركت فيه. ثم بعد هذا التعب تستخدم أقل من ثلث هذه المعرفة. رد عليّ معزيًا وقال إن القصص التي أكتبها جيدة. طلب مني أن أرسل له النص على الإيميل، قلت له إنني لم أكتب سوى جملة واحدة، أشعلت سيجارة أخرى وقرأت عليه الجملة الوحيدة التي كتبتها: في الحقيقة كان الأمر ينطوي على مغالطة مضحكة، حيث إن المزرعة الصينية التي سُميت بها المعركة كانت مزرعة يابانية. بدا متحمسًا بعض الشيء وهو يستمع، قال إن هذا ليس مضحكًا لكنها بداية لافتة، هكذا قال. حدثته عن موضوع القصة وقلت له إن جوهر القصة ليس عن الحرب ولكن عن تأثير السياسي على العمل العسكري في حرب أكتوبر. وقلت له إن السادات أجبر القيادات العسكرية على تنفيذ أوامر فاشلة، حتى إن الإسرائيليين حاصروا الجيش الثالث الميداني بسبب تدخلاته، قلت له إننا خسرنا الحرب، وشتمت السادات. ضحك وقال إن هذه الأخطاء تحدث والمهم أن سيناء تحررَت. بدأت أنزعج قليلاً من كثافة الدخان في القهوة وقلت إنها ليست أخطاء ولكنها جزء من السياق، ومثل حكيم إغريقي اكتشف سر الوجود لكن بصورة كاريكاتورية قلت: لا يوجد ما هو اعتباطي، كل شيء خاضع لسياق ما، حتى جمر شيشتك. ضحك ولم يعلق. قلت له: ربما يتطور الأمر وأكتب رواية عن تأثير السياسي ليس فقط على العمل العسكري ولكن على كل شيء، الدين، اللغة، الاقتصاد، الأخلاق، العلوم الإنسانية، الشارع أمام بيتكم، ويمكن أن أبدأ من حرب أكتوبر. وشعرت بسعادة غامضة وأنا أتحدث عن عملي، قال إنها ستكون رواية جيدة، ثم سألني باهتمام لماذا لا أجمع القصص التي كتبتها وأطبع مجموعة قصصية. قلت له: إنني لست مهتمًا الآن. قال إنه قرأ مرة أن الجامعة الأمريكية في الكويت وضعت جائزة بقيمة ٢٠ ألف دولار، وشجعني على أن أطبع مجموعتي وأشارك، ثم قال إنني لو حصلت على هذه الجائزة يمكن حينها أن نبدأ أي مشروع. صمتُّ ولم أرد. أشعلت سيجارة وقلت له أن أمرًا غريبًا حدث معي وأنا أعد لكتابة هذه القصة، ولأجعل الغرابة مبررة قلت له أنني كتبت كثيرًا من القصص ولم يحدث معي هذا قبل الآن. ثم حدثته عن الكوابيس المزعجة غير الواضحة التي تعاودني منذ أن بدأت جمع مادة القصة. ضحك وخرج مع الضحكة دخان كثيف وقال ربما هذه الكوابيس من تأثير السياسي، وسألني عن الكوابيس. قلت له إنها كوابيس مزعجة لا أتذكرها بوضوح، لكن كانت كلها عن حرب أكتوبر، أظن أني رأيت الشاذلي يقاتل بنفسه، الدبابات تدهس المجندين، ليالٍ مطيرة باردة، بكاء النساء، لا أدري أشياء كثيرة مزعجة. آه في مرة رأيت ثلاثة من عساكر الاحتلال في البلكونة ينظرون إليّ من خلف زجاج بابها، لم يهاجموني لكنني كلما اختبأت كنت أراهم ينظرون إليّ. فهمت من الحلم أنهم يريدون أن يقتلوني. كان هذا أوضح كابوس رأيته. قال لي إن هذا بسبب المبالغة في القراءة عن الحرب، وإنني أجهدت نفسي. قلت له ربما أكتفي بتلك الجملة التي كتبتها وأنسى هذه القصة الكابوسية، ضحك وقال المهم أن أطبع مجموعتي القصصية. صمَتُّ وأشعلت سيجارة وطلبتُ شاي كشري.
عاشت أمي جزءًا هامشيًا من طفولتها في ملجأ تحت الأرض. ملجأ بدائي حفره جدي بمساعدة أخيه في باحة المنزل، منزل شعبي قديم في عين شمس. بأدوات الفلاحة حفرا خندقًا، جعلا له سقفًا من جذوع وجريد النخل وعوارض خشبية وغطيَاه بالتراب. كان ذلك في أيام حرب ٦٧ لما كانت السماء ملعبًا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي. في المساء يطفئون كل الأنوار ويستعدون للنزول المحتمل في الملجأ. كانت الطفلة الصغير تكره اليهود، وتعتقد بأنه لا يوجد في العالم إلا مصر واليهود، وحينما ينتهى هذا الصراع سوف تقوم القيامة وينتهي العالم. لما كبرت أمي صارت تكره المحتلين، وتعرف أن التاريخ أوسع من هذا الصراع. وصار الملجأ مكانًا يلعب به الأحفاد حتى انهار من تلقاء نفسه، ربما مل من انتظار الحرب دون جدوى أو ربما كان غاضبًا من معاهدات السلام.
صورة الشريط © حيدر ديوه چي