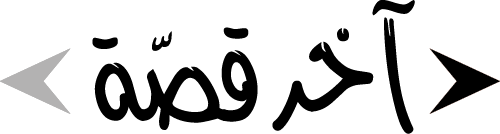شمس مشرقة ولكنّ المطر يهطل. على ذمة صديق فالناس على الطرف الشرقي من سلسلة جبال لبنان يقولون أنه عندما يهطل المطر والشمس مشرقة فإن الديب عم يتجوز، بينما على الجانب الغربي من الجبال عندنا يقولون أن الواوي عم يتجوز. أو العكس. ما علينا، فبينما الواوي والذيب يقومان بأشيائهم، كنّا نحن في الطريق إلى بنزرت، نشق طريقنا بين تلال من القمح والشعير وطواحين الهواء. بنزرت كانت آخر مستعمرة للفرنسيين في تونس، بقيت القوات الفرنسية ٥ سنوات في بنزرت بعد نزاع دولي حولها رغبة في مينائها، بعد انسحابها من بقية أراضي الجمهورية. أيضًا ما علينا، طواحين الهواء تدور، الواوي أو الديب عم يتجوزو، الشاب خالد يغني، وشخص ما في البلاد يلقي بنكتة حول بشرة البنزرتية البيضاء وعيونهم الزرقاء، ونحن في السيارة نشتهي القهوة.
توقفنا لأخذ القهوة في المحطة. تحت الترّاس وفوق الطاولات بنَت العصافير أعشاشها. عصافير صاخبة جدًا تفهم جلبَ الرزق واللهي، الناس تُكمل أكلها وتترك البقايا على الطاولات فتهبط هي لالتقاطها. وضعتُ على الطاولة الفارغة بجانبنا قطعة البسكويت التي وقعت منّي على الأرض قبل قليل، أردتُ امتحان العصافير، وهي لم تتأخر؛ هبط عصفور وتجول حولها وأخذ قضمة فُتات ثم طار. صفقت من فرط السعادة. فعلٌ سخيف، لكنني فهمت على العصفور وهو فهم عليّ.. ع الطاير.
يحكي صديقي عن امرأة تعرّف عليها هنا في تونس، في أول رحلة لها خارج بلدها الأوروبي. الأخت – لنطلق عليها مثلا اسم ست زبيدة – قالت له أنها عملت مع اللاجئين السوريين في بلدها. ماذا كانت تفعل ست زبيدة؟ كانت «تدرّسهم السعادة». يا لبكاحتك وبكاحة بلدك يا ست زبيدة.
في السوق القديمة عند منعطف غير مناسب أبدًا لفرش البضائع لزحمته، فرش أحدهم كيس خيش أبيض فيه حزم من أغصان الملّيسة الطازجة. تختلف تسميتها بين ملّيسة وترنجيّة وفرفين، لكن الرائحة المذهلة واحدة. الملّيسة هي العشبة المفضلة لدي، عندما تكون «خضرا» قبل أن تجفّ أوراقها تُجبرك على الابتسام. اشتريتُ آخر حزمة لديه وكانت مبللة بالماء لتعيش أكثر، تأبّطتها كحبّ مريح، أخذت «عِرِق» منها ووضعته على أذني – كعادة التوانسة في وضع المشموم والورود والأعشاب العطرية فوق أذانهم لكي ترافقهم رائحتها الطيبة – ومشيت. خلال التمشاية تناوبنا على حمل الحزمة، أو بالأحرى تناوبنا على حضن الملّيسة المُنعشة. في سوق السمك، كنت أنا أحمل الحزمة، بين «الحوت» ورائحته القوية، أصوات الباعة العالية وماء الثلج الذائب على أرض السوق، كانت الناس أفواج أفواج. بينما أحاول شقّ طريقي في الزحمة حاملةً حزمة الترنجية يسألني أحدهم مشيرًا إليها: «انّجم؟». بالطبع ممكن. إقتطع منها «عِرِق» ووضعه على أذنه وعاد ليناقش بائع السمك بينما أكملتُ طريقي. كلانا مع مشموم ترنجية فوق أذنينا، وأنا لديّ سعادة رقيقة بالملّيسة وبأنني جزء من هذا المكان، أعرفُ اشاراته ومفاتيحه، فهمت على ذلك الرجل وهو فهم عليّ.. ع الطاير.
كم مرة يمكن لحزمة ترنجية أن تكون الوصل مع الناس حولك؟ أو أن تكون كسّارةً للجليد ومحرّكًا للجو.
بجانب سوق السمك يوجد مطعم تعطيه مشترياتك من السمك ليشويه لك. ناس بتفهم بجلب الرزق. يعني: يوجد سوق سمك فتعالوا نحط مشوى جنبه. ما علينا، بعد أن أكلنا أشهى سمك دوراد بحري ذهبي فيكِ يا شمال أفريقيا، فتح صاحب المحل حوارًا معنا عن الترنجية؛ متى نجدها في السوق، في أي أيام وفي أي مواسم. عرضتُ عليه جزءًا من الحزمة فرفض بأدب «عيّش أختي»، لكنّه أخذ شمّة. أخبرنا عن شيء لم أكن أعلم بوجوده: البنزرتية يقطّرون الترنجية. أصبح ماء الترنجية الآن على قائمة ما أريد في هذه الحياة.
عدنا يومها، أكلين شاربين مزهزهين، وحاضنين حزمة الترنجية.
عودةً للستّ زبيدة التي أخبرني عنها صديقي؛ عدا عن عُقدة المنقذ الأبيض وعدا عن هوس تضميد الكسر بلزقة جروح وعدا عن كل الهبل الأبيض الذي يريد أن يلغي التروما والحرب المستمرة بجلسة تُخبر فيها الآخرين ما الذي يعجبك فيهم، الزبدة بالموضوع هو أن ستّ زبيدة لم تكن سعيدة. ليتبرع لها أحد بشتلة ملّيسة – وعلى حسابي – باسم اللاجئين السوريين.
صورة الشريط والتسجيلين المرئيَيْن © فرات الحطاب