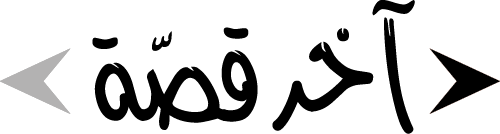قام للترجّل عن القطار. كنت أتمنى أن يترجّل عنه قبلي لأقوم بتبديل مقعدي بمقعده والجلوس مقابلة اتجاه السير. كان الجلوس في الاتجاه المعاكس يصيبني بالدوار. عندما جلست على المقعد البرتقالي المهترئ الذي شغر كان مازال يحمل دفء جسده الذي ذكرني بذلك اليوم منذ خمسة أعوام.
تذكرت ذلك في اليوم السابق أيضًا عندما ظهرت تلك السمكة أمامي. كنت جالسة على ضفة النهر أستمع إلى الماء يغريني بالغرق. ظننتها بقايا نفايات طافية على سطح المياه حتى لاحظت مقاومتها للتيّار. كان عند طرف الرصيف صياد يرسم وعصى صنّارته لوحة بأجسادهما أمام زُرقة السماء ومنازل القصبة القديمة. كانت السمكة تحاول الهرب منهما بتحدي النهر. راقبتها تبتعد.
كانت المباني قيد البناء خارج النافذة تتوالى المبنى تلو الآخر. محطات جديدة يجري إنشاؤها استعدادًا لتدشين خط القطار السريع الجديد. سوف يصبح التنقل من الساحل الغربي إلى الساحل الشمالي للبلاد أكثر سهولة، وربما الموت على السكة الحديدية كذلك.
كانت والدتي لتحب السمكة ففي أحد أركان غرفة جلوسنا اعتنت بواحدة تشبهها لفترة من الزمن. أحضرها والدي ذات يوم. قال بأنّها لأحد أصدقائه الذي غادر في رحلة خارج البلد ولن يعود قبل ستة أشهر. أحبّت أمي السمكة حال رأتها. شغفت بها حبًا وكان كل من عرف بالأمر استغربه. كانت إلى جانب أعمال التغذية والتنظيف الروتيني تغني لها، وتحادثها. و دائمًا ما تقول لي أن جزءًا من روحها يسكن جسد السمكة.
أخرج هاتفي من الحقيبة وأراجع الصور التي جمعتها من بحث على الإنترنت للتأكد من قراري. وبعد فحص لعدد من صور آذان الغرباء، أقرّر أن ما اخترته من عدد وتنظيم هو فعلا الأجمل.
في بداية الأشهر الستة التي شغرت فيها تلك السمكة ركن غرفة جلوسنا، تغيّر مزاج أمي. أصبحت دائمة الغناء والابتسام وكثيرا ما بدت سعيدة كما لم أرها من قبل. لم تعد تلعن نفسها إذا ما نسيت الطعام على الموقد ليحترق قليلا. ولم يعد أحد يسمعها تكرّر بأنها قد تقدمت في العمر ولم تعد قادرة على إعداد الحلوى كما كانت تعدّها في شبابها كلما فشلت في إعداد أحد أصنافها.
أرجع الهاتف مكانه في الحقيبة وأتذكر ما حدث بالأمس عند ضفة النهر.
في السنوات التي سبقت وصول السمكة بيتنا، لم أشعر يومًا بروح أمي. لم أكن أراها تبكي. ولم تكن هناك صدامات واضحة لها مع أبي. ولكني لطالما رأيت فيها استسلامًا تعيسًا للأيام. كانت خاوية، لا حياة فيها. يحركها قلق مُزمن. كانت تستيقظ صباحًا كل يوم تعدّ الطعام وتقوم بأعمال المنزل دونما أي شغف بأي من أنشطتها تلك التي لم يكن لها غيرها. كانت امرأة تعيش حياتها اليومية أقرب لإنسان آلي متطور يشعر بآلام التعب الجسدي ويشكو منها باستمرار. لم تكن تجيد الكلام، ولم تكن يوما مستمعة جيدة. ولكن ظهور تلك السمكة فجأة في حياتها غير كل ذلك.
سمعت صوتا يناديني بأن آتي. كان الصياد قد جمع عدّته ورحل. ولم يكن هناك أحد آخر على الرصيف غيري. لقد كانت السمكة مستسلمة للتيار.
في يوم من أيام الشهر الخامس، وأثناء تناولنا للطعام، ذكر أبي قُرب موعد عودة صديقه. تكدّر وجه أمي. وتبع الأمر تدهور سريع في مزاجها أولاً، ومن ثم صحتها خلال الأسابيع التي تلت ذلك التذكير. كانت على ما يبدو تأمل أن لا يعود الرجل أبدًا أو ينسى سمكته وتحتفظ بمكانها في غرفة جلوسنا مقابل باب المطبخ، تغنّي لها وتحادثها كما فعلت كل يوم خلال الأشهر الأربع الماضية.
في البدء لم أصدق أن السمكة هي مصدر النداء. ولاحظت هي ذلك. أكدت لي أن الأمر حقيقة وأنها هي فعلا من يناديني. استمعت لها وتبعتها لتحتضنني المياه الدافئة.
في أحد صباحات الشهر السابع، استيقظت لأجد ركن السمكة فارغًا. جلستْ أمي في المطبخ تبكي. «سوف تعود الآن إلى رعاية شخص لا يعرف معنى أن تعيش محجورًا في حوض.»
في البدء حاولت مقاومة التيار كما فعلت السمكة قبل أن يرحل الصياد. ولكني سرعان ما استسلمت. لم أكن أعرف السباحة على أية حال.
رحلتْ السمكة ورحلتْ روح والدتي معها. ولكني ما زلت أذكر ذلك اليوم منذ خمسة أعوام، وذلك الركن في غرفة جلوسنا شاغرا، عندما احتضنني دفء روح أمي.
لا أتذكر كيف وجدتني أتنفس على الرصيف مجددا.
يخبرني هاتفي بأنّي وصلت وجهتي بشارع محمد الخامس. أتحسّس أذني مودّعة الفراغ في شحمتها وأدفع باب الصالون المعتم.
صورة الشريط © حيدر ديوه چي