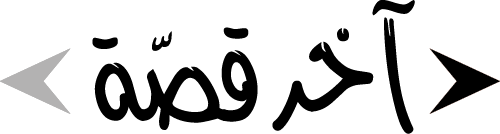جلست على مقهى في انتظار شيء ما. كانت السماعات الكبيرة المختفية عن الصورة تنقل صوت فريد الأطرش الذي تلعب أغنياته على موبايل القهوجي. شعرت بالغرابة. وكانت رائحة الطعمية المقلية الغرقانة في الزيت الرديء المحروق تصل من مكان ما لم أستطع تحديد مسافته. لكنها كانت قوية جداً، عنيفة، مزعجة، ومثيرة للغثيان. طلبت كركديه. سألني القهوجي عن السكر. كنت سأقول: العادي. لكنني أخبرته بتواضع: ملعقتان. لم تعجبه صياغة الإجابة فقال بتعالي حرفي: يعني مضبوط! أشعلت سيجارة وانتظرت الكركديه. مثانتي مزعجة. توقظني في الصباح كل يوم قبل المنبه، وتهاجمني على مدار اليوم. لم أكن على استعداد لدخول مرحاض المقهى، لأنني لا ارتاح لطلب العون وطرح الأسئلة على العوام، ولأنني أفتقر للشجاعة التي تؤهلني لخوض رحلة البحث عن مرحاض عمومي بمفردي. قررت أن أتماسك. أنا بطريقة ما متماسك جيد. أتصور أنني واقف على شفير الهاوية منذ سنين. لا أنزاح. لا أتراجع. لا أتجاوز. ولا أنهار. ربما أنا الفزاعة التي تنبه وتحذر الآخرين السائرين في الطريق. قضيت على سيجارتين. السجائر الجيدة لها عمر قصير. أقصر بكثير من الأخرى الرديئة. تذكرت مقولة سقط اسم صاحبها من ذاكرتي، تعني أن الانسان المحترم لا يتجاوز الثلاثين من عمره. وتذكرت شاعرا له اسم كبير وسمعة طيبة في الوسط الثقافي كتب: “أنا الرجل السيء. كان علي أن أموت صغيراً.” ومات قبل أن يتجاوز الثامنة والعشرين من عمره. لجأت إلى موبايلي. وفكرت أنه جهاز أملكه، أي أنه يتبع سلطتي، يخدم مصالحي، لكن واقع الأمر، والأمر في واقعه، غير ذلك. وأنه بات في النهاية جهازاً يصدر القلق. أشعلت سيجارة ثالثة وبدأت أشعر بالضجر والضغط الذي يصيب الواحد بعد أن يوطد علاقته بشيء أو بأحد. ودخلت في سباق مع الزمن للإنتهاء منها. ثم راودتني رغبة قوية وصارمة في التخلص منها. لكنني أكملتها حتى النهاية. وما جعلني أقاوم وأستمر هو شيء غامض. ربما هو نفس الشيء الغامض الذي يدفع الواحد للاستمرار في الحياة. عدت لصوت فريد الأطرش، وما زاد شعوري بالغرابة هو أن الأغنية التي تلعب ليست من بين أغانيه المشهورة، أو في كلمة أخرى الجماهيرية، فضلا عن أني لم ألمس اعتراض او استهجان او استغراب على الوجوه الحاضرة على المقهى. وبدأت أقتنع أن الأمر ليس صدفة. وأن القهوجي عاشق كبير لفريد الأطرش. ورحت أراقبه وهو يتحرك بين الطاولات. رجل في منتصف الثلاثينات. وفي منتصف الصلع. وفي منتصف الوردية. لا تعوزه الحيوية ومزاجه رائق بشكل محير. ناداه أحد الزبائن وهو في طريقه إلى طاولة أخرى. وقف وأخبره بأن يصبر وأن ينتظره فقط نصف دقيقة. فقط نصف دقيقة. وأخذ يردد فقط نصف دقيقة. لا بغضب أو بضجر. فقط نصف دقيقة. كان يقف فوق رأسي تقريباً. أخبرته بمرح أن النصف دقيقة قد مرت بالفعل. مال برأسه نحوي وقال بصوت منخفض وبطريقة جادة وهزلية في آن واحد: أنا عارف أنا بعمل ايه.. دي عالم متناكة. رفع رأسه وهم بالانصراف الا أنه نظر في عيني وقال: ما تقلقش، مش ناسيك. كان يراودني شعورا مبكرا بأن الرجل صاحب مزاج. لكني بمرور الوقت صرت مقتنعاً بأنه أكثر من ذلك. لم يمر وقت طويل قبل أن يحضر كوب الكركديه. بدأت في احتساء الكركديه بالفعل وشعرت بأني بصدد انجاز نصف مهمتي في الحياة. لكنني مع ذلك لم أتخلص من الشعور بالقلق والغربة والقرف والضغط المصاحب للانتظار. انتظار شيء ما. وانتظار تفريغ مثانتي. كانت الأغنية المجهولة لفريد قد انتهت وبدأت أغنية ذات إيقاع مألوف. رفعت رأسي وحدفت بصري نحو القهوجي الذي كان منهمكاً في إحضار المزيد من الطلبات التي لا تتوقف. بدأ فريد في الغناء وتوقف الرجل عن العمل وانشغل بالانصات: “آدي الربيع عاد من تاني.. والبدر هلت أنواره. وفين حبيبي اللي رماني.. من جنة الحب لناره؟” أطلقت زفرة عميقة وحارة. كأنني أتخلص من شيء ثقيل جداً. وبدأت أحس بمرارة واحتقان في حلقومي وشعرت أنني قريب جدا من الانزلاق في نوبة بكاء. عاودت النظر إلى القهوجي الذي كان قد انزلق بدوره في عالم آخر. عالم حزين لكن حالم وجميل. رفع رأسه كأنه أفاق من غفوة صغيرة وألقى نظرة شاردة وحالمة إلى المطلق ثم راح يسكب القهوة من الكنكة العالقة في الهواء منذ دقيقة في الفنجان. قررت أن أتخلى عن خجلي أو تحفظي وأسأل القهوجي عن مكان المرحاض. ولما اقترب مني سألته عن الحساب. دفعت ورقة نقدية وتركت له الباقي. وهو يهم بالانصراف سألته عن المرحاض. دلني عليه ولامني على الانتظار الطويل المرير والغير مبرر. وأنا في الحمام فكرت في أن لي وجه فاضح واندهشت في نفس الوقت من فراسة الرجل. ثم تساءلت هل هي فراسة أم غباء وغرور؟ خرجت وألقيت على الرجل تحية الوداع. قال لي وهو يرد التحية بابتسامة عريضة كشفت عن اسنانه الصفراء المجهدة: شايف وشك نور ازاي؟ اكتفيت بابتسامة صغيرة، صفراء ومجهدة. ثم انصرفت وراح وجودي في المكان ينهار ويضمحل ويتلاشى ويتحول إلى ذكرى عديمة القيمة والمعنى.
صورة الشريط © حيدر ديوه چي