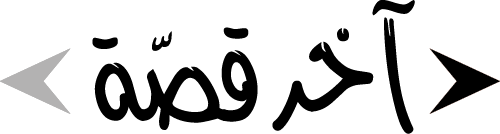في صيف حارق
– أحرق من الصيف الماضي،
وأبرد من التالي –
نزل الشاعر من الجنوب الأعلى
إلى الجنوب الأدنى
نزل ثم وقف على حافة الصخرة
وذبح صوته. هكذا بكل هدوء،
رمشت عيناه الضيقتان بانزعاج.
لم يقرأ الفاتحة ولم يحدد لله
لمن يهدي هذا القربان.
لقد زهق الشاعر من كون صوته استعارة،
أراد أن يرى دم صوته، شحمه ولحمه،
حسبه ونسبه، أن يسمع اهتزاز الحبال
حتى لو تكلفه لفظة الموت.
في لغتنا، يجد نفسه مقدماً الاسم على الفعل،
لوثة الأنا الغنائية ربما. يقطف كلمات
تيبست حتى استحالت ذهباً، ينفض عنها
غبار القرون ثم يغرسها في أصص صغيرة.
يظن الشاعر أن بإمكانه
ابراء الأكم واحياء الميت.
أما في لغتهم، يقطع الجبال والمحيطات
تاركاً طلاسم على كل شجرة
كي لا يستحيل إلى مرايا.
يأتي بجبل من سفوح كاليفورنيا
ثم يلقي به في خليج المكسيك
ليطفو ثانية فوق أنبوب نفط.
كل صباح، أستيقظ على صوته،
أوصد الشباك في وجهه لأكمل نومي.
أتركه يلخبط الساعات، يحدثني عن قصيدة النثر
كيف تقف كجذع أجرد قاطعة الأفق:
لقد سرقوا موسيقانا
ولم يتبق سوى الصوت
يصلني مع فارق التوقيت
مريضاً بالأرق، مثقلاً بالبدايات،
عالقاً – كصرخة أزلية –
في هوة الوقت.
صورة الشريط © حيدر ديوه چي