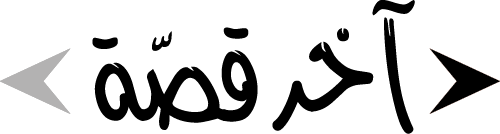فاجأتني في غرفتي قاعدة بقميصي الأسود تلفّ لي حشيشًا، تنظر لي مُبتسمة ببساطة تُضيء وجهها الأبيض ذا السحابة الحمراء العابرة للوجنتين. مَسّني – أنا الكافر بالطريق – إحساس بالإكتمال.
جاريَ في نفس الدور رجل لا يُعرف عنه الكثير، بجانب أنه أصلع وأن له عادات غريبة، مثل وقوفه على باب الشقة بروب أحمر وهو يمسك في يده لعبة؛ عربية صفراء، كأنه ينتظر أحدًا أو شيئًا ما. إن تصادف وتعطّل الأسانسير بأحد الجيران في دورنا وألقى السلام، يردّه جاري بغمغمة غير مسموعة لكن مبتسمًا دائمًا.
في طرقة الدور أصرّت على خطّتها بالتسحّب إلى شقتي. قلت: ماينفعش. قالت: ليه؟ قلت: علشان ما حدّش بيعمل كدا. قالت: ما هي دي حلاوتها. ثم أكدت بعينين ممتلئتين: لو عملوا زيّنا المعنى يروح.
ولديه عادة أخرى لطيفة؛ كلما انقطعت المياه وضع جالونًا ممتلئًا أمام كل شقة في الدور، بما فيها الشقق الخالية، حتى تراكمت الجالونات بجانب بعضها. كما أنه تعهّد بسقي وردة حمراء وحيدة تنبت في قصرية صغيرة على حرف شبّاك يطل على المنور ولا يُفتح أبدًا.
حين علّقت يدي بيدها خلف ظهرها وهي تقودني إلى شقتي، ورأيت حبكة شعرها البُنّي المتغازل من الخلف، وجدتني – أنا الكافر بالحساب – على أعتاب الجنة.
اكتشفتُ لاحقًا أن الرجل لم يختر مكان الورة الحمراء عشوائيًّا. حين راقبته بتركيز، رأيت أنه لا يسقي الوردة ويعود مباشرة إلى شقته، بل يُلقي نظرة متمهلة على الشقة المقابلة. في مرة، رأى الباب مواربًا فانقلب طفلاً لاقى أمه بعد غياب.
حين حكيتُ لها اكتشافي وكنّا في غرفتي عاريَين، بعد الكثير من الحشيش، ضحكت وسألتني: إنت ما تعرفش إن دي أمي؟ تفاجأتُ، لكنّها أكملتْ: أومال أنا ساكنة معاها ازاي؟ تفاجأتُ مرة أخرى، ثم نطَقتُ: تِصدّقي عمري ما أخدت بالي إنتِ بتيجي منين. ردّت: وهو إنت يعني عارف إنت نفسك بتيجي منين؟ ردّها المُلتبس والمبالغ فيه ظاهريًّا صاحبَته ابتسامة مُطَمْئنة، فاطمأنّيت، رغم أنه لا وجود لشيء يدعو للطمأنينة.
هذه المرأة، التي اتّضح أنها أمها، تراودني في أحلامي. أسمع أنها بتعمل جمعية كبيرة والكُل بيقبضها في معادها. لطالما حلمتُ بأن أستثمر معها في جمعيتها ولو حتى بخمسين جنيهًا. لكن بما أني متدهور ماليًّا باستمرار، عجزت حتى عن اقتطاع الجنيهات الخمسين للجمعية. لم أعرف سبب احتياجي الغامض لجمعية المرأة، ولم أرد أن تعرف البنت بحلمي لسبب أيضًا لم أعلمه.
ويدي معلّقة بِيَدها خلف ظهرها نتسحّب على أعتاب الجنّة، فتَنني عن حبكة شعرها رؤية صورة انعكاسنا على زجاج شباك المنور الذي لا يُفتح أبدًا. قصرية الوردة الحمراء لم تكن هناك. لكنّها ظهرت حين ظهر الرجل معلّقًا يده بيد المرأة وهما يتسحّبان لشقته، في يده الوردة وقد استوت. ثم امتلأ الدور بعُشاق يعلّقون أيديهم في أيدي عشيقاتهم خلف أظهرهن بالخفّة نفسها. فجأة، حلّت على يدي المعلّقة بُرودة قاسية، رجعتُ ببصري إليها فوجدتها تنظر لي وفي عينيها بركان غضب. لطمتني وقالت: مش قلتلك لو عملوا زيّنا المعنى يروح!
لم أعرف ماذا حدث للمرأة مع الرجل، لكنّني خمّنت أنهما لم يصلا إلى مرامهما لأن الوردة كانت واقعة في الطرقة مُداسة بالأقدام.
راقبتُ الرجل لأرى ماذا سيسقي الآن، وجدته جالسًا عند باب شقته، خالعًا روبه الأحمر، زاد صلعه، وفي يده العربية الصفراء. المرأة كانت عند باب الشقّة المقابلة، تجلسُ كاشفةً نهديها؛ ممتلئين ريّانَين لكن ينحدران إلى الذبول حالاً. كانت تُدخن الحشيش وتصوّب نظرها إلى الرجل. أخرج الرجل من جيبه خمسين جنيهًا لفّها وحشرها في فتحة العربية اللعبة، ثم نام على بطنه ووضعها على الأرض ودفعها تجاه المرأة بأقصى قوة. قبل أن تصل العربية إلى منتصف الطريق، كان الذبول قد أكل النهدين حتى تيبّسا. وتوقفت العربية. كان الدور قد وصل إلى نهاية عمره الافتراضي، فقرّر الإثنان، وبهدوء طقس جنائزي وثباته، أن يدفنا نفسيهما كلٌ عند باب شقته.
بقيتُ أراقب العربية وفيها الخمسين جنيهًا، واقفة في منتصف الدور الميّت. لكَم تمنيتُ أن تظهر البنت من جديد بقميصيَ الأسود وتلتقط العربية، تُعلّق يدي بيدها خلف ظهرها كي نتسحّب لشقتي وتلفّ لي الحشيش.
لكنّها لم تأتِ.
صورة الشريط © حيدر ديوه چي