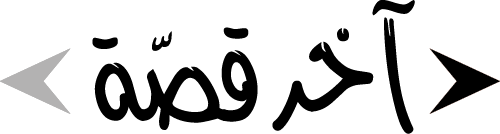أحببتُ ولداً، فلسطينيًا، كان يسخر من كل شيء على تويتر، لكنها لم تكن سخرية عادية، كان شيئًا رماديًا، ينمُّ عن إدراك ووعي كبيرين، يعيش في غزة ويصغرني في العمر، كان يقول طوال الوقت أن غزة من أقصى شمالها لأقصى جنوبها تُقطع في ساعة واحدة، فتخيل أن تعيش ٢٣ عامًا في هذه الساعة. ولم أكن أقرأ في ذلك الوقت، بينما كان هو يتحدث عن مجلات عربية، ويشارك صورًا من أرشيف يبدو أنه مهم، شعرتُ بالانجذاب فورًا، لابد وأن شابًا كهذا، لن يضيعني.
اكتشفت من خلال البحث الذي أجريته عنه أنه يُحب بوكوفسكي وسالينجر ومحمد شكري، انهمكتُ في قراءة كتبهم قبل أن أتحدث معه كلمة واحدة، كتبهم تكاد تكون متشابهة، أو لأقل كما لو أن كاتبها وضع أسماء مستعارة وعاش في مدن مختلفة، يطبخ الطاجن، ويعرف كيف يعمل البريد الأمريكي، وكيف تغوص قدميه في الثلج شتاءً، ويرتدي قبعة، ويحلم بحراسة حقل يركض فيه الأطفال والخراف، خفتُ كثيرًا من الغضب الهائل الذي أحسستُ به وأنا أقرأ، تشكّلت في ذهني صورته الكاملة، بدا أن هذا تحول تراجيدي في قصتي العادية، شيءٌ لو أنه كان في رواية لبدا منفرًا، هل أفعل هذا بالتحديد لأنه كذلك؟ تخيّلته ينفخ الدُخان ولا يغمض عينيه عندما يفعل ذلك، تخيّلته ينفض عقب السيجارة، بمهارة، ولا يحترق شيء في العالم، ثم إن الكتب الثلاثة، بها جنسٌ كثير، وفي مكان خبيء عرفتُ أنني أتوق لهذا، لكنني لستُ متأكدة بأنني جيدة عندما يتعلق الأمر بالنّيك.
ثمة جُملة أبكتني في الخبز الحافي،«لم يعد يروق لي عطف الناس علي: لا الرجال ولا النساء» فيما بعد عندما سأحبه وأتعلق به، سألاحظ هذا، كان لا يحب العزاء الذي يقدمه أحد لأحد، ولا يقدم هو نفسه أي عزاء، واذا قلت له أننا سنموت سيقول أننا سنموت ميتةً رعناء، وعندما يكون متعبًا أو مريضًا يحبذ أن لا تلفت انتباهه إلى هذا، كان عارفًا وصموتًا، وكان هذا لا يشبهني، كنتُ أحب عندما يشتمني في الفراش، ذلك أنه يصبحُ عاطفيًا بهذه الطريقة، كانت تلك السخرية التي يحترفها، محاولة جادة إذن، لعدم الظهور بمظهر عاطفي، وكنتُ أكثر عاديةً من أن أتلائم مع شيء بهذه العبقرية والفتنة، كنتُ نكرة، خاوية، مستسلمة، وأكثر عملية في بعض الأحيان، عملية مطحونة بمرارة العيش، التي جعلتني أدركُ أن الواقع يتطلبُ قدرًا من الإذعان، أريد أن أعيش على فراش وثير، وأظافري ليست قذرة، لا أريد تربية نباتات، ليس إلى هذه الدرجة، لكنني سأسكن في بيت جدرانه مطلية بعازل الصوت، مثل الفنادق خمس نجوم، وهذا كل شيء.
قلت له مرة أن ثياب النوم مثيرة، الدانتيلا والحرير، والحجب المقصود. لم يتفق، قال أنه يحبُ العري وحده، يكفي ان يكون لحمًا واضحًا وفيه يتدفق دم المرأة التي يحب وتضطرب دقات قلبها لرؤيته ينظر إليها. كان يقول لي قولي أنك قحبتي، وأنا عادية جداً ولا يمكنني أن أكون قحبة، ومع ذلك في لحظة ما، ولأنني تسليتُ كثيرًا بعاطفيته، قلتُ أنني قحبة، قحبته للأبد.
كانت صورتي التي تستطيع أن تحاكي حياتي، هي الذهاب للعمل، وكان هو في الفراش طوال الوقت، ليس نائمًا، ولا يحدق في السقف، بل يتململ، مثلما يجب أن يشعر عصابيٌ غاضب مثله. كان رقيقًا للغاية، يطعمُ قطة، يلاعبها، ينيمها بجانبه، وأنا كان يقبلني في عيوني، ويمسكُ أصابعي، وعندما أنام، يسهرُ بجانبي يمسدُ شعري، يقبل كتفي بنعومة، قبلات متقطعة، غير عجولة. كان أول رجل أسبقه إلى النوم وأنا بجانبه.
ذات يوم رأى في نشرة الأخبار طفلا مقطوعة قدمه بسبب الحرب، غضب وبكى وقال بأن على كل سكان غزة أن يموتوا.
في مرة أخرى اتصل صديقه من بيروت، كان ساكتًا معظم وقت تلك المحادثة، يستمع بوجوم ونحن نلعب في العتمة، أنا بين قدميه، رأسي على صدره، وهو يسند ظهره بميلان على مقدمة السرير، ويعدّ شعري، ثم فجأة بكى، دون صوت، كانت دموعه تسقط حارة، ولما أنهى المكالمة قال لي ان «صديقه وصاحبته تركوا!»، كنتُ أعرف أنهما معاً منذ ٩ سنوات، كان «هـ»، صديقه المقرب.
تلك الليلة لم يشتمني على الفراش. وكان حبنا غير الفاحش، انهزاميتنا الجديدة للواقع.
في اليوم التالي قال لي أنه يحبني، لكنّني كنت قد عزمتُ على ترتيب أولوياتي، حيث لا مفاجآت، يمكن أن يستسلم الإنسان ويترك الأمل للصغار، لكنّني في مطلع الثلاثينيات، وأحسُ بأن الإنسان يفسدُ مع مرور الوقت، وإذا سألني أحد لماذا تركته، لن أجيب، فقد تعلمت منه الرفض، وأعرف يقينيًا أنه عندما يتحدث عنّي أمام الآخرين لا يكون ملهوفًا، بل جافًا، رغم أنه يحبني كثيرًا، أكثر من حبه لنفسه. أنا متأكدة.
قد تظنون انني قصدت الكتابة عن رجل من غزة، فهذا أسهل للإشارة للخلفية الاجتماعية التي نشأ فيها حبيبي وبطل هذه القصة، لكنني لا أمزح ولا أبالغ، كان من غزة بالفعل، وقد كانت مصادفة بلا شك.
لقد أعجبتُ به كثيراً لأنني عرفتُ أن عناد يأسه لم يكن مصطنعًا، بل أصيلاً، ليست تلك ردة فعل يمكن حسابها بسهولة، أثارني هذا بصورة نهائية، حتى بتُ أعبد صعلوكي المفضل، الذي كان ضد الجميع، وضدي بالطبع.
ومثلما كان محمد شكري، كاتب الخبز الحافي يفضلُ أسمهان على أم كلثوم، ظننتُ أنه يحبني للسبب نفسه، تعجبتُ كثيرًا من أنه قد يلتفت لإمرأة مثلي؛ أنا تمثيل مباشر للبرجوازية الصغرى والتي أسعى لأن أكملها تمامًا بالزواج من رجل ينتمي للطبقة المتوسطة، ولا بأس إن كان ثريًا. كنتُ أعرف أن هذا يشكّل أحد مواطن ضعفي، كان قد أسرني، عندما رأيتُ كيف أنه يتحدى كل شيء ويعيش وفقًا لأهوائه، ظللتُ طوال الوقت في ريبة من أن يتركني، لستُ أي شيء اذا ما قورنت به، مالذي حصل إذن؟ كيف صار وتركته أنا؟
في اليوم التالي لاتصال صديقه، استيقظتُ مبكرًا وأنا أتمنى أن يخطئ في أي شيء لأتمكن من التذرع به فأرحل، لكن هذا ما لم يحدث، خرجتُ من شقتنا الصغيرة في القاهرة، لم أتمكن من الحصول على سيارة أجرة بسرعة، اليوم الجمعة، والمكان الذي أسكن فيه بعيد بعض الشيء عن وسط المدينة، وصلتني رسالته التي تقول أنه سيخرج أيضًا، ظللتُ أنتظر في الأسفل مختبئة خلف سلم العمارة، أنتظر أن يأتي، ثم بعثت له برسالة، متى ستخرج؟ قال لقد فعلت، كنتُ أعرف أنه لم يغادر فراشه، تعجبتُ من هذه الكذبة، لكنني عندما أمعنت التفكير في الأمر، رأيتُ أنه كان يخشاني، لقد تمكنتُ إذن بعاديتي أن أهزم الثورة، أن أخمدها، وربما أن أضيعه للأبد، لم أشعر في أي وقت بمثل ذلك اليأس، الذي كان ينهمرُ من الطابق الرابع، الشقة رقم ١٢، ليظلل عمارة حديثة، ويصير شبحًا جديدًا في القاهرة المنكوبة، لم يكن ذلك كله لأنه من غزة، تلك كانت مصادفة.
صورة الشريط © حيدر ديوه چي