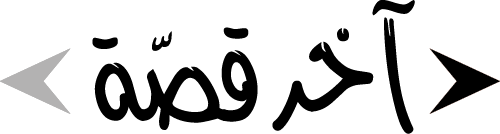٠
هذه الحائطية ليست سوى نتاجاً للهذر والسهر والتفكير في قضايا تافهة كصاحبها، ليس لها رسالة سوى توثيق أجوبتي لسؤال الأخ الأزرق الكبير لي كل يوم، عن ماذا يخطر ببالي، بالحائطية شذرات لا يربطها شيء سوى كوني كاتبها.
١
أنا مرتبك طيلة الوقت، هناك شيء ما يلاحقني لا أعرف كنهه. كل ما أعرفه عنه أنه مثقل بالحياة ومكنوناتها البسيطة، أكون مرتبكاً عندما أضع قدميْ على أبواب الكوشة فأجد العشرات منتظرين حول صندوق خشبي، يلتقطون الخبز وهو يتطاير من يدِ العامل إلى الصندوق، أرتبك حقاً عند البدء في يوم جديد، سيكون عليّ مواجهة المتاعب الدنيوية الاعتيادية؛ بنزين في السيارة، سجائري المفضلة التي أبدّلها حسب تبعيات السوق، أحاول دائماً الاحتفاظ بسجائر ذات جودة متوسّطة، أرتبك أكثر عندما أقف أمام اسطى القهوة لأطلب قهوتي. عادةً أدخل المقهى مبتسمًا وأفرغ الكلام في وجهه هكذا:«صباح الخير، كيف الحال، كريمة لو سمحت»، ولا أنتظر إجابة. أرتبك أيضًا عندما يتصل بي أحد الأصدقاء، أرى المحادثة الهاتفية مثقلة بالمسؤوليات الاجتماعية والنفسية والعاطفية والاقتصادية أيضاً، ولكنني في أشد ارتباكي عندما يوقفني الملثمون في البوابات العسكرية ويسألونني عن صحتي، سيارتي، مدينتي وأي الطرق أتيت منها وهل لديْ ممنوعات أم لا، أحمد الله دائماً أنهم لا يفتشون عقلي.
أنا مرتبك طيلة الوقت، إلا في تلك اللحظة التي أختلي بها بنفسي لألتقط جزءاً من الغبار الكوني لمّا أطير بين الكواكب، أزور لندن، أقف مشاكساً الحارس الملكي، أجلس في إحدى مقاهي أمستردام أو أركب سيارتي في السريع، أو حتى أستلقي متخيلاً حبيبتي تغني لي.
ما الذي يحاول أن يقوله الجَرَاد؟ إنه يسقط في كل مكان، في أواني الطعام وفي حبات المعكرونة، على رؤوس الأطفال، وعلى عروسة كانت لطفلة ما تمشّط شعرها كل يوم، يسقط في قناني الفودكا لشلّة تنزوي بقدرها الميؤوس منه بعيداً، يسقط على المنازل والأبقار والماعز وشجر الزيتون وفي كراهب الكادحين، لكن اللعين لا يسقط أبداً على رؤوس العساكر، ولا ينزع أشلاءهم، ولا يخرّب العكّاريَات التي تحمل الأربعطاش ونص على عاتقها، لا يسقط على أبناء القادة البعيدين في بلاد الكفّار ولا على السياسيين أيضاً، لابد أنه يحاول أن يرسل رسالة ما لهؤلاء، لأنه لا يمكن أن يكون سافلاً لهذا الحد، أن يترك السفلة أحياء ويسلم كل هؤلاء لملك الموت، لا يمكن أن يصح المثل الذي يقول ” العافن ما يموتش”.
٢
لديّ صديق عشتُ معه أياماً طويلة في تونس، مليئة بالمغامرات، إحداها كانت تخص تعرّفنا على رجل فرنسي، وكان صديقي كريماً جداً إلى تلك الدرجة التي غصب فيها الرجل الفرنسي على استعارة مظلتي الخاصة لنخوض أنا وهو يوماً من المطر في شوارع بورقيبة، لا يحمينا سوى رؤوسنا المليئة بالضحك. بعد ذلك، لم أعد أضرب مثل الكرم بالطائي، بل بصديقي الذي أريد أن أحافظ على سمعته دون ذكر اسمه.
«البندقة» هي الأخت الكبرى للكرم في ليبيا، والبندقة مصطلح واسع يشمل الكرم بحاجياتك وحاجيات الآخرين من حولك وربما حتى بأشياء ليست عندك، فقد كذب من قال «فاقد الشيء لا يعطيه»، في ليبيا، فاقد الشيء يعطيه ويزيد عليه. بسهولة يمكنك التمعن في السرّاج وقراراته، أمي ونقود أبي، صديقي ومظلتي، حفتر وكرامته، الشعب الليبي وطريقته المحافظة في الحياة، طرابلس والمليشيات التي تتداولها كأنها عاهرة لكل دوره في مضاجعتها، المثقفون الليبيون والألقاب التي يخلعونها على بعضهم البعض، الإعلام الليبي والحقيقة، وزير الثقافة والثقافة، الناشطون المدنيون والمدنية والإنسانية التي “يتحلون” بها، الزقعار والدين، البقرة والحليب الذي يذره، معمر القذافي والنضال، التراث الليبي والمتعاركون عليه من أجل أن يبيعوه في مزادات علنية في كل مكان، عمي وسيارتي، زيدان وملابسه الداخلية، البطولة والمجاهدين والمناضليت والكتّاب الأحرار الذي يمتلئ بهم هذا الوطن، ليبيا والموقع الاستراتيجي، قدرتنا التي يخاف منها الغرب ويحاول تشتيتنا من أجل أن لا نتحد، العرب ووطنهم المشترك في «الهندسة»، حفّاظة القرطاسية خاصتنا، الأمازيغ ووطنهم المسلوب، وكل تلك الشعارات والحروب والقضايا والقرارات وانفاص التُن في مقصف المدرسة.
أصبحت أشك في جاذبية مدينة كطرابلس بدون مشاهد القبح اليومية: القمامة، طوابير البشر على المصارف، زحمة السيارات، اضمحلال اللون الأبيض من المباني الإيطالية وتسلل الأصفر الرملي بدلاً منه، المليشيات، نافورة الغزالة المتكسرة، والأضرحة المكلومة، رائحة المجاري النافرة، سيدي الشعاب، والغبار، كل ذلك ممتزجاً بما تبقى من شراشف ليلة زفافها مع البحر، طرابلس… تبدو جميلة ورائعة في البداية وعندما يتكاثر عليها الأزواج تفقد روحها إلا أنها رغم ذلك، تحول كل ذلك القبح إلى جاذبية ما. شيء كالخدعة تمارسها.
وأتخيل طرابلس جميلة وهادئة ومسالمة دون أية قيود تردعها نحو الجمال، كم ستكون متكررة، كم ستكون عادية، كم ستكون مسالمة وفاتحة ذراعيها نحو الحياة، وأقول، ربما عندما يأتي ذلك اليوم، عليْ حقاً التفكير في هجرانها.
اغزالة..
سلّمي لي عالأحياء البحرية، على نورس يرقص فوق شطآن تاجوراء يحاول أن يسرق سمكة من خزنة البحر فيلهمني، على رقصٍ أمام شاطئ بعيد ينعم بالسكينة والفتيات اللذيذات يعصرن الغنج نبيذاً للناظرين، على عاشقين يتمشيان بخوفٍ في كورنيش اطرابلس يتفقّدان آثار تمثال الغزالة التي حملت الحرية صحبتها لينهش الجائعون غزالها في حفلة شواءٍ لأكلة التراث، سلّمي لي رجاءً على النبكة تنفخ في شاطئ مصراتة روحاً تبتهج بسيدي مورجانتي، على خفر السواحل الذين يمضون لياليهم في تتبع دخان الوقت ينسحب كبكاءِ الطيرة في ليل الموانئ التي تعج بالمهاجرين، سلمي لي على مهاجرٍ أسود حاول أن يمضي قدماً للهجرة إلى الشمال. سلمي لي على البحر، رجاءً… لأنه يبدو، العائق الوحيد بيني وبين أن أغرق أرقاً من الذوبان في حبك.
غير صحيح، عندما يحل الليل ينطفئ العالم ويخرج القمر ليراقب البشر وما يصنعون، أتذكر مجموعة من الشباب يسيرون في خط مستقيم لا يعوجه سوى صوت البورجيجي وهو يغني للأزهار لتهدأ.
منذ متى وقد كنت في عهد يرغمك على التنازل عن تقبيل الأيام بلهفة؟ منذ متى استعرضت كونك شر لا بد منه؟ هاهم أبناء عمومتك يمارسون الطقس نفسه، إنهم جميعا أبطال في معركة لا شر فيها، إنهم الرجل الخارق والمرأة الرائعة.
ماذا تبقى لبائعي السجائر والحكايا المبهجة؟ هل تبقى من رائحة العرق الذي يندى في صدر السماء سوى مطر تغريك للابتعاد أكثر؟؛ قل لي.. ماهي الحقيقة؟ الحقيقة هي أن تتنكر للحقيقة وأن تلبس الجرد والمعرقة وتعزق الأرض بأغاني الشعير… شباب زي الورد، شمّ ولوّح. هذه هي الحقيقة.
٣
قليل البخت يعضه الكلب في الزحمة، وقد عضتني الأيام دون العباد حتى صرت مستكلباً، كلب مسعور يبحث في أعين الناس ويتصيّد خوفهم من كلماته الجارحة، أحياناً أنبح في وجه أمي أنه لو أمكن أن يعود بي الزمن عندما كنت في بطنها لركلتها بكامل قوتي حتى تسقطني ميتاً، أحياناً أخرى أخبر حبيبتي أنني أتمنى أن أكرهها، وأخرى أخبر هذا الوطن أنني أرجو له أن يحرق حتى آخر ورقة توت به.
ذات يوم وبعيداً في الزمن استيقظت ليلاً في الجبانة القريبة، أشمّ رائحة جدي، أحرّك بمقدمتي تراب قبره لأخرج عظامه، أعضّه بأسناني الدبقة، يقولون وحده الكلب الذي ينسى أصله، وأنا لا أريد أن أنسى أصلي فقط، بل أن آكله وأرمي بقاياه في المجاري. وها أنا الآن، أدور مشرداً في شوارع هذا الوطن، في الفجر، أبحث عن تقي واحد على الأقل لأركض خلفه قبل أن يرميني بحجر.
القضية الأساسية أن الحياة هنا لا بنّة فيها، وستحتاج لجهد عظيم كي تتذوق لحظاتها، أن تنهمر في أسلوب الحياة الليبي وترتكز بقهوتك على الأنقولي وتنتظر الفتيات ليسرن بجانبك في زحمة السيارات والزمامير والمتسوقين في «بن عاشور» أو «الجرابة» أو «عمر المختار». تلك اللحظة الوحيدة التي يمكن أن تستمتع بوجود «الأنثى» أمامك خارج أسوار الجامعة والمقاهي النسائية، منذ أيام الأعراس داخل الخيمة، حيث كانت رغباتك تتفتّق لأول مرة.
أمور أخرى يصعب تذوّقها نظرا لضيق الحال، «تقييد» أحوالك الشخصية، تغلي الدنيا عليك بدولاراتها وديناراتها، هذا بالطبع بعيدا عن أن هذا البلد يفتقد لحانة واحدة على الأقل، وطريق تمشي فيها دون أن تصاب بسعار الأمن والآمان، وفتاة تمشي بتنورتها، وعازف كمان يستلقي الجدران ويعزف من أجل بضعة دنانير، وراقصة باليه تمشي راقصة في وسط البلاد، وسينما واحدة يخرج منها الأصدقاء ممتلئين حتى ولو بأفلام السبعينيات والتسعينيات، لا غرو أننا حقا أصبحنا نشبه الجرذان، نسترق الطَعم.
في السادسة، كنت أسرق الألعاب من رفوف بيت عمي، كنت كطفل لا أصدق ولا أحتمل كيف يضع أطفال عمي لعبهم الصغيرة في الرفوف كأنها تحف أو مزهرية مزيّفة فقط للتفرج عليها، وليسقط الغبار كالثلج يغطيها، ويتناسون مع الوقت وجودها، أجد طريقي للرفوف عاليا. أسرقها، أعود بها للمنزل وألعب بها، أجسّدها وأسمّيها وأعرّفها على بقية ألعابي قبل قتلها وملؤها بلعابي ومخاطي وعرقي، ومن ثم اختفاءها فجأة فأبكي على فراقها.
وأنا الآن أسرق القصص من ألسن الناس، عيونهم، أفكارهم، وجوههم، ملابسهم والكلمات العابرة التي يلقونها دون انتباه. لا أحد حولي يكترث للقصص، يتناسونها كأنها ألعاب تركت فوق رف. أتناولها بيدي وأشكّلها، أسمّيها، أجسّدها وأعّرفها على بقية القصص التي ألعب بها، أقتلها وأملؤها بمنيي، دمي، عرقي وترهاتي. أخيّطها مع بعضها كأنها سروال عامل في حقل بطاطس في مزارع تاجوراء. أكتبها ومن ثم أبكي على كتابتها.
٤
كمشهد سيارة شرطة تلاحق بطل الفلم، حياتك تتكرر. كمشهد رجل يسقط من أعلى بناية على سطح سيارة، حياتك كليشيه. كأفلام الأكشن، أيامك متشابهة. كالمشاهد الإباحية في القنوات العربية، يقطع نصف عمرك دون أن تدري. كأن يقول بطل الفيلم المترجم «تباً لك» قتخطئ في قول صباح الخير.
كعاهرة تبعث فيك حب المجون وخوض المغامرات داخلها هي هذه المدينة التي تعيشها. الأيام لا تلقِ لك بالاً، الحرب لا تبحث عنك ولكن تبحث فيك عن أسوأ ما فيك. أصدقاء طفولتي، أحدهم فقد ذراعه ونصف وجهه بسبب قنبلة يدوية أخطأ رميها، آخر مرّة رأيته فيها كانت في بوابة، حين أوقفني طالباً أوراقي التبوثية.
صديق آخر صرف وجهه عن المسجد بعد أن كاد ينظم للمتشدّدين، ثم رأيته يقبّل فتاة في ردهات الجامعة. صديق آخر خرّبت الحرب عقله، وجدته أخر مرة وقد فقد قدميه.
يقولون لي أن هذه هي الحياة، وأن عليك أن تفعل أفضل ما بوسعك، ولكن لا وسع لي إلا التفرج عليها، كمسلسل رخيص أشاهده أثناء دوام عملٍ ممل. وفي فراشي أمرّر الوقت حتى يفرغ اليوم مني.
يخبرونني أن أكتب عن أي شيء، أنت تعرف: يمكنك كتابة مقالة حلّل فيها أي شي.
تقصد كطريقة جدتي في إعداد الشاي؟
لا، بل أقصد، خذ مثلاً «الهجرة غير الشرعية»: تحّدث عن معاناة المهاجرين، المهرّبين، خطر البحر وأشياء حقيقية، أشياء كالصحافة، لا كالأدب.
عرفتُ مهاجراً كان ضحوكاً وساخراً وهو في مراكز الهجرة غير الشرعية، مليئاً بالحياة كما يقولون، حاول أن يعبر البحر مرة صحبة 150 آخرين حتى تلقفهم خفر السواحل، يسمّونه «الملك» في المركز، هل تعلم ذلك؟، ذات يوم وجدته في أحدى الأعمال السينمائية وأنا أطل على ليبيا من بلاد أخرى، ابتسمت وحزنت، فقد كان آخر لقاء لي به في أحد مراكز الإيواء قبل ستة أشهر، ويبدو أنهم رحلوه لمركز آخر، عندما انتهى الفلم، خرجت لأدخن سيجارة، أمضيت بقية اليوم في التعرّف على ملامحي، فقد رحلت ذات مرة من هنا لأشهر لأجد نفسي كارهاً لحياة الرفاهية التي كنت أعيشها، عازماً العودة للأرق، القلق، العرق، الغرق، وألق الرصاص في الليل. لا يا عزيزي! هل ترى ما الذي تفعله؟ إنّك تعشق رواية القصص، القصص لا تشتري لك قوت يومك.. تحدّث بجدية، بعيداً عن الخيال، بعيداً عن أنسنة الأشياء، بعيداً عن العبارات المنمّقة.
تحدث بجدّية أرجوك، يقولون لي، عن أي شيء: المقاهي، حال المرأة في ليبيا، الجينيريشن قاب، تأثير التدخّل الخارجي في شؤون الليبيين، ربطات العنق، طعم القهوة اللاذع الذي بدأت أشربه لأخفي تقزّزي من النهارات، البُنية التحتيّة وقيادتي للسيارة وسط الظلام، وزارة المواصلات، اندثار الإيفكوات. أشياء لا يبتدئ عنوانها بـ «قصة»، «قصة قصيرة» أو حتى لو أخذني الغرور وكتبت مئات الصفحات وأسميتها رواية.
لماذا -حتى الآن- لا نملك وزارةً للفكاهة؟
كان هنالك في كلية الهندسة موظف اشتُهر بإسم «عزّو غدوة»، كان عزّو «موظف الاستعلامات» في مكتب مسجّل الكلية القابع داخل ردهات قسم الهندسة النووية؛ مبنى ألماني يعود لحقبة برلين الشرقية مليء بقبل العشاق ومكتبة تجلب الدوار. كان سبب تسمية عزّو بـ ” غدوة” أنه يجيب على كل سؤال للطلاب بـ: «مافيش، مهناش، غدوة يا باش مهندس». وعندما تأتيه غداً ستجده يخبرك أن تأتي «غدوة»، هذه المتلازمة التي التصقت به جعلتني ذات مرة آتيه 7 غدوات متتالية.
في تاجوراء، يعمل أحد موظفي الدولة كـ «موزّع غاز». يجلس الرجل الخمسيني كل صباح أمام مستودع الغاز خاصته ليشرب الشاي ويدخن السجائر وبجانبه عبوتيْ غاز مقلوبتيْن، وأيام كان هنالك غاز في هذا البلد المليء بالغاز، كنت آتيه لأملأ عبوتي الفارغة، وكان الرجل ينظر لي كأنني شحاذ، سيتفضّل عليه بعبوة مملوءة. كنت أخشى دائماً أن يطالبني بأوراق ثبوتية أو يخبرني أن ” المنظومة واقفة”.
واليوم، أخبرني صديق بقصة مثيرة للضحك – لربما تكون مثيرة للبكاء أو العزاء، فالمآسي وحدها تضحكني – مفادها أنه وفي إحدى مؤسسات الدولة، وبعد شتاءٍ قاسٍ تسللت فيه المياه لأرشيف المؤسسة المليء بالأوراق والملفات الخاصة بالمواطنين، قرّرت الإدارة حفظ الأوراق بعيداً عن غرفة الأرشيف، في ممر عام، فأصبح الممر الممتلئ بجبال الاوراق والملفات المنتفخة بفعل البلل كمتحف يأتي الزوار وأصحاب المصالح لمشاهدته، ويخبرهم موظف صار يعمل كمرشد سياحي، بعد أن يمسك أحد ملفات المواطنين ويقرأ الاسم: هذا فلان، يبدو أن حياته منذ اليوم ستكون صعبة، ثم يرمي الملف على الأكداس بشيء من الشماتة.
صورة الشريط © حيدر ديوه چي